إيلاف من جدة: يضع المخرج السعودي وائل أبومنصور المشاهد، منذ الدقيقة الأولى، لعمله السينمائي الروائي الطويل الأول «مدينة الملاهي» أمام ثيمة فيلم الطريقRoad movie بتوليف نابه ومشحون بلغة بصرية ماتعة تحمل قدراً من الرمزيات الغامضة التي يحتمل بعضها التأويل ويستعصي البعض الآخر.
مجريات الفيلم لا تطرح قصة تقليدية بحبكة واضحة وتراتب حدثي مسرود بالمنطق الكلاسيكي: بداية وعقدة ونهاية، وإن كان ذلك متحققاً جزئياً في السياق العام. وهو كذلك لا يبلور صراعاً مادياً معقداً يخوضه أبطاله وتسعى حبكته المخاتلة لتفكيكه، ومن ثم الوصول إلى لحظة تنوير تبهج المشاهد وتجاوب على الأسئلة التي قد تدور بعقله وهو يتفرج؛ فالفيلم محمّل بالغموض الذي يفضي إلى أسئلة حائرة هي التي تخلق متعته وتحديه. الطرح الواضح ليس من شأن الفيلم؛ ولا هو منهج أسلوب صانعه أو هدفه المبتغى. هو يختبر حالة وجودية سيتماهى المتفرج مع مستواها الحكائي السطحي، لكن ثمة مستويات أخرى في هذه الحالة يتركها كاتب السيناريو للمشاهد ليفهم ما يفهم ويؤول كيفما يشاء.
هي إذن سينما المؤلف ذات العمق الفني والفكري في اطار من المنطق العبثي، وهي السينما المستقلة المعاصرة في دوافعها ودينميكيتها وأدواتها؛ ذات العناصر التجريبية التي تتخذ من التلميح والإيحاء والترميز أساسيات لسرد سياقاتها الدرامية. سينما بعيدة عن الخوف من أحكام الجماهير المعتادة على الاعمال المقولبة والأشكال النمطية، وبذلك تكفل للمتلقي المتبصّر استمرارية التفكير المستكشف، واشتعال الأسئلة حول المعنى والمقصود والمغزى من مجمل الفيلم. انها بتعبير أدق سينما الفلسفة بالمعنى المتبسط والعميق في آن واحد؛ حول الأسئلة الوجودية للسعادة والقيم والرضا والقلق والرفض والتوازن، بحثاً عن الحكمة؛ ضالة الباحث المؤمن بالحياة. وهو في المقام الأول، من ناحية أسلوبية، سيناريو يحتكم الى خلق أفق ترقب وانتظار يستدرج المشاهد إلى التماهي والتوقع.
لكن الحامل الفكري للفيلم يعززه أداء الممثلين؛ والذي كان أفراده منسجمون مع أدوارهم، بحيث لم يتركوا شاردة أو برهة أو لفتة ركيكة أو خارجة عن سياق التقمص الكامل للشخصيات، بدءًا من الممثل محمد سلامة، الذي استوعب دوره المثقل بالأزمات النفسية، فظهرت على ملامحه وحديثه ونظراته وحركة جسده، وتبلورت في اختلاجات بالغة الأثر والتأثير، فيما جسدت ندى المجددي الأريحية المستهترة بتشخيص متقن، يركن إلى أريحية محمومة، وفي نفس الوقت متوترة، أظهرت ما يعتمل بداخلها وكأنها فاقدة للأمل في انصلاح حال رفيقها، لكنها بدت غير مبالية، باسمة بفتور، باحثة عن خلاص بغير حروب أو مجابهة، منتظرة لما سيقود مصيرها؛ ولم تخرج عن إطار المرأة المحبة والمستاءة والرافضة والمستهترة الباحثة عن انعتاق... إنه الأداء دون تكلف أو مبالغة.
وعي بالأعماق
ربما تكون هذه المقدمة مرشداً إلى مدخل النص الفيلمي، فما ترنوه هذه القراءة المحاولة التحليلية الظاهراتية لأفعال الوعي القصدي لمؤلفه، ولأبطال الفيلم وصراعهم، وهي لا (تحرق) الفيلم بقدر ما تحث على مشاهدته، فقد تتوافق هذه القراءة مع آراء نخبة الجمهور المتمكن، وقد تذهب بعيداً عن رؤى البعض الآخر. الفيلم يخلق تلك المساحة الرحبة للتحليل والتداخل والنقد والتأويل والرفض والقبول، وربما للرفض جملة وتفصيلاً أو حتى للقبول والإعجاب والإشادة المتحمسة بالمطلق.
هكذا تتعامل سينما التجريب مع حيثيات غير معتادة على مشاهد اعتاد أن يقول الفيلم له كل شيء؛ بحسب نظرية الفيلم التقليدية، ليخرج منه مرتاحاً ممتناً لصانعه وطاقمه الفني والتمثيلي. لكن الفيلم لا يسعى إلى راحة المتلقي بل أنه يزج به في مسؤولية إكمال القصص غير المكتملة التي حفل بها الفيلم.
هذا كله يحيل إلى أهمية العمل على مستوى التفكير في مهمة السينما وتشابكها مع المجتمع. وعلى مستوى صناعة الفيلم السعودي تحديداً، من جهة المغايرة والجرأة والخصوصية في تحقيق سينما تريد أن تصنع هويتها وقوالبها وأساليبها الخاصة بمعزل عن الركام الآتي من السينمات الأخرى.
سندرك أن مزاج أو "مود" Mood الفيلم خنقه الخط السردي الرأسي في الربع ساعة الأولى منه، حتى أدخلنا الى الأزمة الطارئة رويداً رويداً، لكن عندما اكتملت دائرة العقدة يحال المشاهد إلى بؤرة الانجذاب الكاملة.
وفي كل ذلك يعي وائل أبومنصور أعماق ما يفعل، من خلال النقاش معه بعد عرض الفيلم. هو يدرك أن فيلمه تجربة أولى قد يكتشف فيما بعد خفايا سياقاتها المعرفية والفنية. يدرك أن الجمهور (السعودي) في مرحلة التهيئة لتلقي أنماط غير معهودة من الأساليب السينمائية. يدرك أيضاً أنه لا يقدم سردية مرتبة حدثياً وزمانياً ومكانياً، وفوق ذلك يتعمد إشراك المشاهد في عمله. هو كذلك لا يخشى فتور الأحداث أحياناً وتوترها أحيان أخرى؛ ربما بسبب ثقته في أن المشاهد عندما يتمعّن قليلاً سيتحول فتوره إلى حمم بركانية تفيض بالمعاني والنقاش الثري. يركن إلى جمالية الصورة بكوادرها المتقنة، والموسيقى بمسامعها الحسية، والألوان بتأثيراتها النفسية. لذلك تأنى كثيراً في تحقيق فيلمه واستغرق نحو ثلاث سنوات، سعياً للتجويد.
مسافران على الطريق
بدايةً، يأخذنا الفيلم في رحلة على الطريق الصحراوي بين مدينتين مجهولتين، غالباً في غرب السعودية، والرحلة مجهولة المقصد والسبب والوجهة، وهي بالتأكيد ليست للبحث عن الجوهر الوجداني للذات، بل ربما للبحث عن ملجأ لروح الذات؛ لسكينتها ورضاها، ملجأ يكون آمناً متخلصاً من مستجدات العصر المرهقة؛ ليقيم فيه الرفيقان السائران بسيارتهما. أو أن هذان الرفيقان متجهان الى مكان يحققان فيه ذواتهما على المستوى الوجودي والمادي والعاطفي، تلك الذوات التي تبدو متأزمة وضاجة، لأسباب لا يفصح عنها الفيلم بطريقة مباشرة، بل يسحب المشاهد للتنبؤ؛ بما يكسب بنية الفيلم أفقاً فلسفياً عاماً يستقصي الحكمة من الرحلة ومكابداتها ونتائجها.
رفيق ورفيقة، رجل وامرأة، يمثلان المجتمع، ربما سنتذكر فيلم المخرج ريدلي سكوت: ثيلما ولويز 1991) ـ Thelma & Louise) رفيقتان تنطلقان في رحلة عبر المدن الأمريكية باتجاه المكسيك طلباً للترفيه الذي تحول إلى هروب من جريمة قتل. لكننا هنا أمام رفيقين لا نتأكد من هدفهما ولا كنه العلاقة بينهما، فقد يخال للمشاهد أنهما حبيبان هاربان أو باحثان يتلمسان طريقاً في نهايته تكمن سعادتهما، ولا ندري من ماذا هما شاردان، أو لعلهما ليسا هاربين؛ إنما منتقلان ورافضان واقعاً معيناً، متجهان الى مكان قرره "مسعود" (الممثل محمد سلامة)، فيما توافقه رفيقته "سلمى" (الممثلة ندى المجددي) على أن تسير معه إلى الوجهة التي يحددها.. إنها رحلة نحو الحياة الأفضل التي لا يعلمان إن كانت ستكون كذلك أم العكس. رحلة يحدد بالضرورة الرجل مساراتها، فيما تنشغل المرأة بما يستجد عليها في محطة التوقف الاجبارية، غير عابهة إلا بما يبهجها لحظياً.
سنتذكر أيضاً فيلم (باريس تكساس (Paris, Texas للمخرج الألماني فيم فيندرز، 1984م، حيث الطريق هو انعكاس لرحلة ذاتية، باطنية، أكثر مما هي رحلة بحث عن المدينة الفاضلة. وهذا ما حدث مع مسعود بالمصادفة. حيث غيرته الرحلة ولم يخرج منها كما دخل.
وكما الحال في أفلام الطريق تعتمد حدوتة «مدينة الملاهي»، في البناء، على خط حدثي بسيط مترابط مع تفاصيل تشكـّل أجزاءً ضمن السياق العام، وفي كل جزء تتكشّف موتيفة وفكرة من الحبكة، وتواجه الشخصيات تحديات أو اختبارات من نوع أو آخر.
في خلفية المشهد الافتتاحي للسرد نسمع تسجيل صوتي يبث حديثاً للمفكر الراحل مصطفى محمود، برنامج "العلم والايمان"، والذي قدمه منذ بدايات السبعينيات وحتى نهاية التسعينيات، بما يوحي بشكل أو بآخر إلى زمن الروي للفيلم، حيث لا مؤشرات واضحة تبين في أي فترة زمنية بالتحديد دارت الأحداث، عدا السيارة موديل الثمانينيات التي يستقلها البطلان في رحلتهما، والحافلات (خط البلدة) "الكوستنر" التي تنقل مجهولين إلى ما لا نعلم. وهكذا فنحن في مكان مجهول/معلوم إلى حد ما خلال زمن مفقود/محدد نسبياً ونواجه أزمات يمكن التكهن بها استنادا للعصر.
ضياع المجتمعات العشوائية المهمشة في ظل طفرة اقتصادية واجتماعية لا تعترف إلا بالمنتجين في منظومة البناء الجديدة. أولئك الذين يباركهم العم المتدين الحكيم (الممثل مختار محمود) رغم جهله وضعف شخصيته.
نسمع من خلال الراديو، أو هكذا يبدو، صوت مصطفى محمود وهو يتحدث عن قِدم الزمن السحيق الذي خلق الله فيه الكون، وبالتالي عن حجم هذا الكون الهائل، وحركته السرمدية؛ وعن فرضية الانفجار العظيم، التي انبثقت عنها الكواكب والنجوم والمجرات، ويختم بأن هذه المكونات الكونية ستحال الى ثقوب سوداء هائلة تستحيل فيها الحياة... هذا مفتاح أولي للفيلم. فلسفة النظر للكل لفهم الجزء، وربطه بالواقع. فهل سيقودنا ذلك إلى عدمية الطريق الذي يسلكه بطل وبطلة الفيلم؟

عالم مدينة الملاهي المهجورة
بطلينا سائران بسيارتهما؛ ليخطر في بال المشاهد أنهما متجهان إلى اللامكان؛ إلى ما يشبه الثقب الأسود، العدمية والعبثية... فإذا بالسيارة تتعطل، وتبدأ أحداث دراماتيكية في ظاهرها معاناة إصلاح السيارة، وفي فحواها الرمزي صعوبات تعترض المسير.
يذهب مسعود ليبحث عمن يصلح السيارة، بينما تتجول سلمى في الجوار للبحث عما يشغلها ويسليها. يجد مسعود من سيساعده في اصلاح السيارة، الميكانيكي أو "البنشرجي" سفيان أبو طاقية، (الممثل نايف الظفيري) بأدائه المتقمص والمقنع، بشخصيته العدائية بمكونات طباع قاطع طريق؛ يستغل وجوده في منطقة مقطوعة، ويمارس أمور غامضة، خارجة عن القانون، لا تفسير لها، سوى أنها الحرية المنفلتة الساعية لفرض السيطرة.
ثمة مدينة ملاهي بالقرب من المكان الذي تعطلت فيه السيارة، مدينة ملاهي مهجورة وبائسة، تطل على حوش تحدث فيه أحداث مريبة. حافلات تأتي لتقل مجموعات من الرجال إلى عالم آخر لا يفصح عنه ولا عنهم. مسجد يؤدي فيه مجموعة من الأشخاص صلاتهم، يقرأ عليهم الإمام (قام بالدور محمود تراوري) آيات اختارها بعناية ليقول معنى يقصده، معنى غير واضح سطحياً ويخضع للتأويل الفلسفي في سياق الفيلم، يقرأ من القرآن: «وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي»، بمحمولها الرسالي للبنشرجي المتسلط ومعاونيه. مجموعة أخرى من الرجال يرقصون المزمار. إنهم أشخاص غريبو الأطوار يقيمون في مدينة الملاهي الغريبة. صاحب الملاهي "ياقوت" (الممثل عبدالاله القرشي) الخاضع لسلطة سفيان. ترى ما حقيقة ودوافع وجود كل هؤلاء الاشخاص وما مدى تورطهم في أعمال تبدو مشبوهة يحيكها سفيان، وما هي رمزية مدينة الملاهي هذه؟
يستغل سفيان أزمة مسعود ويأخذ السيارة ويختفي. أثناء البحث عن سفيان يجد مسعود نفسه وحيداً في رحلة لاكتشاف خبايا ذاته، يقف على حقيقة استياء سلمى منه، رغم ذلك فهي متمسكة به وقررت السفر معه، والآن عليه أن يواجه نفسه، أن يتخلص من عاداته وأفكاره القديمة، وأن يدرك ما هو ضروري ومهم لمواصلة العيش في عالم غير متصالح معه. يتعرض للعنف من سفيان لإرغامه على قبول ما يحدث له.
سلمى وليلى..التبعية والحرية
سلمى تنصب خيمتها المؤقتة وتلتقي بجمع من الناس في الصحراء لاهين؛ يغنون؛ ويصنعون بهجتهم في سواد الليل، تشعر معهم بالانتماء والسعادة؛ مجتمع حضري حديث متوازن العلاقات بين الجنسين، بعكس المجتمع الذي انغمر فيه مسعود: مجتمع مشوه خارج عن النطاق الانساني المتوازن. يدور حوار قصير وموحي بين سلمى واحدى نساء هذا المجتمع "ليلى" (الممثلة سارة طيبة) نستشعر منه مدى التوائم والانسجام الذي تعيشه المرأة في ظل مجتمع صحيح ومتوازن. مضمون الحوار بينهما يقوم على منطقين مختلفين للمرأة في مجتمعنا، منطق يقوم على التبعية، ومنطق منافس يقوم على الاستقلال تمثله ليلى، تحاول من خلاله أن تحث سلمى على ضرورة اتخاذ موقف أعلى من الأحداث التي تمر بالشخص، كونهما يتحدثان من صخرة مرتفعة تراقب الأحداث أمامهما.
صراع وحوار مقتضب
الصراع بين الرفيقين يتصاعد من خلال حوار مقتضب، شأنه شأن بقية الحوارات التي تدور بين شخوص الفيلم، فمنها ما يفهم بقدر معين، ومنها ما يستغلق ويبقى مفتوحاً للتأويل. وربما أدى ذلك مع بطء السرد والمونتاج المتأني الى مغامرة السؤال: هل سوف يتسرب الملل إلى المشاهد؟ فهو أمام حوارات قليلة مبتسرة؛ صامتة، وانتقالات مشهدية بطيئة الى حد ما في بعض المشاهد. في حين حملت المؤثرات الموسيقية والصوتية جانب تبديد ما قد يتسرب من قلق أو ملل، مستوحياً الموسيقى التي دمجها "مايك وفابيان كورتزر" من أعمال Gustavo Santaolalla لقدرتها على تكثيف مشاعر الوحشة والغربة والاشتياق والتعاطف. تعززها تلك اللغة البصرية المدعمة بصور وزوايا خلقت روح ناطقة لمجمل كوادر الفيلم.
حوار بين مسعود وياقوت يحدث بعد قضاء مسعود ليلته الأولى في الفندق، ويظن فيه مسعود أنه قادر على اقناع ياقوت بمساعدته في الحصول على سيارته، وأنه يعلم أن ثمة رابط خفي بينه وبين سفيان، بينما ياقوت يعلم أن مسعود حاول في الليلة السابقة أن يكتشف عالم الملاهي، لذلك يبدأ حديثه معه على مائدة الإفطار بقوله: "انت فاير ليل ونهار"، ويبدأن حوارا فيه من التحايل بالألفاظ أكثر من الصراحة إلى أن يضطر مسعود بمواجهة ياقوت بقوله: "اعتبرني من الناس اللي بتشحنوهم في الباصات .. " كمن يريد أن يقول شاهدت كل شيء ولا داعي يا ياقوت إلى التحايل، الأمر الذي يدفع ياقوت إلى استفزازه ودفع مسعود إلى الاعتراف بقوله: "وانت ايش عرفك اننا بنشحنهم؟ ومع مين؟ ومو كل شي هنا تفسره على كيف أهلك!" في محاولة توحي بأن ياقوت يعلم أن مسعود فاقد للبصيرة.
البيئة أيضاً تصبح طرفاً في ذلك الحوار الصامت البليغ، وتضيف أبعاداً نفسية كانت مختفية وراء ضجيج المدينة التي هرب منها مسعود وسلمى. لأن الصحراء هي العراء الكاشف والمكشوف الذي يبث في الوجدان فضيلة المكاشفة ويعري نقائص وأخطاء الذات، ولذلك في هذه المساحات الصحراوية الشاسعة تتعرى قيم الحياة التي تركها مسعود وراءه، وتظهر تأثيرات أزمة الأنانية والنزعة المادية التي سيطرت على مجتمعه، إبان تلك المرحلة التي عرفت بالطفرة الاقتصادية، والتي انشغل فيها الجميع بالتعمير والتنمية والاستهلاك وغفل عن جوهر الاخلاق والفضيلة، لذلك يسعى مسعود للنجاة من آفة العصر المادية، مصطحباً رفيقته للبقاء على قيد الحياة نقياً ونقية.
يختتم الفيلم بذات مشهد الافتتاحي، نرى مسعود وسلمى وهما بسيارتهما، منطلقان لإكمال الرحلة، بينما مصطفى محمود يكمل حديثه عن الثقوب السوداء، ومعها في الثواني الأخيرة في الفيلم تنفتح نافذة جديدة في ذهن المتفرج: الثقوب السوداء الملتاعة في ثنايا النفس البشرية والمكتنزة بطاقات هائلة من المشاعر والرفض والرؤى والأحلام والهواجس والأمل والبحث في دهاليز الحياة. إنها من المستحيل أن تذوي كما تذوي الثقوب السوداء الخاملة في العدم، هي ارادة الحياة التي أخذت تتلألأ في عيني سلمى.


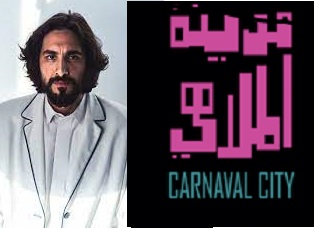
















التعليقات