أحاط الفنانَ ومفهومَ الفنِّ كمٌّ هائلٌّ من الأساطير تعود إلى زمن بعيد جِدًّا، لا يمكن تحديده. والذي ساعد في تعزيز هذه الأساطير والانفصال عن المجتمع والواقع هو احتكاره من قِبَلِ طبقة الكهنة، والقصور الملكية؛ ما أدَّى إلى زيادة الحيرة والغموض بشأنه. فهل تساءلت يومًا لماذا تبدو أبنية المتاحف كالمعابد والقصور الأثرية؟ وهل شعرت بالضيق والارتباك في الوقت الذي كان من المفترض أن تشعر فيه بالراحة؟
قد يشعر الزائر بهذا الطقس الرمزي منذ اللحظة الأولى التي يطأ بقدميه عتبة المتحف، وهناك بعض المتاحف التي تقدّم خارطة مزوّدة بشكل كامل بما يجب عليه أن يفعله، ويمتنع عن فعله داخل النشاط الطقوسي المتحفي. ومن المتوقع، بالطبع، أن يتصرف الزائر بلياقة. ناهيك عن أن المتاحف تقع في أماكن معزولة عن الشارع ومحاطة بحدائق خضراء شاسعة، فضلا عن وجود علامات مميّزة تتصدّر بوابات المداخل الضخمة، ثم السقوف المرتفعة المبالَغ بها في بعض الأحيان، لإضفاء الإحساس بالعظمة والفخامة. زيادة على ذلك وجود مسافة تفصل الزائر عن العمل الفني بواسطة الأشرطة الصفراء والحمراء وعلامات "ممنوع الاقتراب، أو اللّمس".
الجواب كما ذكرت الفيلسوفة الأميركية "كَابليك"، هو التالي: لقد صنعت أبنية المتاحف بهذا الشكل عن تعمد، وكان الغرض منها هو أوّلًا: محاكاة الأبنية الاحتفالية القديمة مثل القصور والمعابد، وثانيًا: التباهي بالتراث الثقافي والمظاهر البرّاقة والشكليات.
لكن ما مدى أهمية الحفاظ على هذا النوع من الطراز المعماري الذي لم يعد يملك سوى معنى مجازيٍّ، بعد أن فقد وظيفته الرئيسية المتمثلة بممارسة المعتقدات الدينية التي ارتبطت بالتضحيات، والمعجزات، وممارسات التعبُّد، والسحر؟
الجواب: هذا لأنها صُمِّمَتْ للتحريض على التأمل العميق، والتواصل مع الأعمال الفنية التي أنجزت في الماضي. بات الغرض الرئيسي للمتاحف الفنية إذن هو عرض الأعمال الفنية الخالدة، وتشجيع الجمهور على التفكير في معانيها وقيمها.
ومن الواضح أن هذه الرغبة في الاتصال بالماضي المثالي، والأشياء التي تحمل الروح الخالدة تشكّل دافعًا للعديد من الطقوس الأخرى، بالإضافة إلى المتاحف الفنية.
أكد هذا أحد المشرفين على واحدة من أهم المتاحف المرموقة في العالم، قائلا إن "متحف الفن" هو في الحقيقة- معبدٌ- يدخله الزائر على أمل العثور على واحدة من تلك التجلّيات الثقافية اللحظية، وادَّعى آخرُ أن المتاحف هي أماكن نسعى فيها إلى حالة من التأمل المنفصل الخالد.
يبدو أن عملية الانتقال أو التحوُّل من المجتمعات الدينية إلى العلمانية، لم تكتمل بعد، ويشبهها عددٌ من المفكرين بحالة الوقوف في المنتصف، أو ما بين بين، وهي حالة يطلق عليها في علم الأنثروبولوجيا بـ "(الحَدِّيّة)، أو (العَتَبية)، وفيها يقف المشاركون على العتبة بين طريقتهم السابقة في بناء هُويتهم، أو مجتمعهم، وطريقة جديدة تنتج عن هذه الشعائر.
صانع العمل الفني
كيف يا ترى ننظر لصانع الأعمال الفنية، وهل نعتبره إنسانًا عاديًا؟
لابد من أن نعترف بأن للفنان هوية اختلفت من عصر لآخر، فقد تمتع الفنان في العصور السابقة بقدرات فاقت قدرات الإنسان الطبيعي، فكان هو العالم والباحث والطبيب والمعماري والمخطط الحضري في آن واحد.
من هنا أنزل منزلة القداسة، وعومل كإنسان خارق، بديهي ومستقل، مصدره الوحيد لعملية الإبداع هو الإلهام، أو الوحي. وقد نُسِجَتِ القصص والحكايات الشعبية التي تدور حول شخصية الفنان عدة قرون حتى اتخذت منزلة الفنان شكلًا آخر، فهو لم يعد مدعومًا من الآلهة بالوحي أو الإلهام، وإنما أصبح بمنزلة الإله، معتمدًا اعتمادًا كلّيًّا على موارده الداخلية في عملية الخلق، وإضفاء الأشكال على الفراغات.
وربما كان أحد دعاة هذا النموذج هو الفنان، وأحد مفكّري عصر النهضة، الألماني "ألبرخت دورر" فهو من قال:” ان الفنان مليئًا بالأشكال من الداخل؛ ولذلك فهو يرتقي إلى منزلة الخالق..".
بيد أن هذا المنظور الكلاسيكي الذي قدمه "ألبرخت دورر"، ورفاقه، لاقى معارضة كبيرة فيما بعد. ويصف "إرنست كرس"، و "أوتو كرتز" في كتاب: (الأسطورة والسحر في صورة الفنان) - 1979م- بإيجاز تطور النموذج الحديث للرؤية الداخلية: "في سياق الثقافة الأوروبية يمكن للمرء أن يتحدث عن الذاتية المتزايدة، وشحن العمل بسمات مستمدة من الشخصية الفردية للفنان، وقد بلغ هذا التطور- الذي اكتمل فقط في نهاية القرن التاسع عشر- ذروته في النظر إلى العمل الفني أكثر فأكثر كتعبير عن شخصية الفنان، أو روحه".
لقد دفعت مجموعة من الحركات الإبداعية المختلفة، مثل "حركة دادا"، وفن الحدث والفن الأدائي والفن البيئي.. إلخ، الفن إلى ما وراء جدران المتحف، وفردانية الفنان، وتمايزه، وتميزه. حيث أدرك الفنان اإن الحوار المفتوح مع الآخر حاجة جمالية مُلِحّة، تختلف تمامًا عن جمالية الحوار مع النفس "المونولوج".
وتلك هي سياسة موجهة نحو تحقيق التفاهم المشترك والترابط الأساسي بين الذات والآخر، الذات والمجتمع. إذ تُعرض هذه الأعمال في مدة زمنية محدودة كما هي العروض المسرحية، ثم يتم تفكيكها، ورفعها بعد نهاية العرض.
هذا وقد شهدت أسطورة الفرداني- والتي كانت تشكل هوية الفنان في العصر الحديث- تحوّلًا كبيرًا لكن التخلِّي عن الامتيازات الموروثة مثل الفردية والخلود ليس أمرًا هيّنًا. ففي ظل الرأسمالية والمنافسة الشديدة، قد يضطر الفنان وغيره إلى الالتزام بأنماط التفكير الفردية.
ولعل تصريحات الفنان الأميركي "كريستو"، 1935م ـ 2020م، أحد أهم الفنانين الأمريكيين في الفن البيئي، المتضاربة، تبيّن هذا. فمرة يقول:
"هل تعلم أنه ليس لديَّ أي أعمال فنية موجودة؟ كل شيءٍ يختفي بعد نهاية العرض. لم يتبق سوى الرسومات التحضيرية والفن التصويري، ممَّا يضفي على عملي طابعًا شبه أسطوري. أعتقد أن الأمر يتطلب شجاعة أكبر بكثير لخلق أشياء لتختفي بدلاً من إنشاء أشياء ستبقى".
لكنه أردف بعد فترة وجيزة، قائلًا: "العمل هو لفتة فردية ضخمة أقرِّرها بالكامل...واحدة من أعظم مساهمات الفن الحديث هي فكرة الفردية ... أعتقد أن الفنان يمكنه فعل أي شيء يريد القيام به. الاستقلال هو الأهم بالنسبة لي. العمل الفني هو صرخة منفردة".
والحق أنَّ الفنان في نهاية المطاف ليس هو الشخص العميق الفكر، ولا هو الشخص المشبوب الانفعال، ولا الثري التجارب، فكل هذه صفاتٌ توجد في أناسٍ بعدد الحصى دون أن تتخايل في أحدهم بارقة فنٍّ واحدة. إنما الفنان هو ذلك الشخص الذي يفكر ويحس من خلال وسيطٍ فني معين، وأيٍّا ما كانت انفعالاته وأفكاره، مُلتهبة أو باردة، عميقة أو سطحية، فإنها تتمثَّل لذهنه مُتجسِّدةً في وسيطه الخاص. وفقا لجيروم ستولنيتز.
ما هو الفن؟
لكن ما الفن؟ إنه سؤال يستعصي على الإجابة، ينتهي من حيث بدأ، ويبدأ من حيث انتهى.
إن مفهوم الفن بعيد المنال بطبيعته، ومقاوم للتعريفات النهائية؛ لأنه مفهوم متجدد لا يمكن التقاط جوهره بدقة، أو تقييد حدوده. فهو معقد وديناميكي، يستمر في التطور، ويتحدَّى تصوراتنا، ويمكن أن يختلف تعريفه وفهمه اعتمادًا على وجهات النظر الشخصية والسياقات الثقافية، والأطر التاريخية. لكن الأهمية التي أوْلاها الباحثون في أسئلة الذوق، وإدراك الجمال، والأدوار المعرفية للحواس والخيال قد ساعدت على فتح أرضية فلسفية جديدة يزدهر فيها النقد الفني. كما ظهرت الأعمال الفنية قدرتها على التأثير على المستوى الروحي والأخلاقي والعاطفي للناس.
يؤكد مؤرخ الفن والفيلسوف "بول كريستيلر" أن مفهوم الفن الجميل هو ابتكار حديث نسبيًّا، وأن القدماء لم يتركوا أنظمةً، أو مفاهيم محكمة من النواحي الجمالية، بل تركوا فقط عددًا من الأفكار المبعثرة والاقتراحات. وفي العصور الوسطى، لم يتم تجميع الفنون الجميلة معًا أو تحديدها، بل تناثرت فيما بين العلوم المختلفة والحرف والأنشطة البشرية المتنوعة " حتى جرى توحيدها من قِبَلِ الفيلسوف الفرنسي "شارلز باتو" الذي قدم القائمة التي يفضلها النقاد التقليديّون اليوم، والتي ضمَّتِ الموسيقى والشعر والرسم والنحت والرقص معًا، مدَّعِيًا أنها جميعًا تستحضر المتعة، وتقليد الطبيعة الجميلة. قبل ذلك لم يكن لكلمة "فن" معنى ثابتا، فقد كانت تعني "مهارة". لكنها تطوّرت خلال عصر التنوير، وأصبح تعريف العمل الفني كالتالي: كائن صمم لتوليد الخبرات الجمالية، ومحاكاة الطبيعة، باعتماد أساليب متنوعة مثل الخداع البصري والمنظور وتصوير الأشكال. لكن بعد لوحة "مانيه" (البار مثلًا)، لم يعد الخداع البصري شرطًا ضروريًّا لصناعة الأعمال الفنية، ولا المنظور الناتج عن نقطة التلاشي حاجة ماسة بعد التكعيبية، هذا وجرى الاستغناء عن الأشكال في التجريدية، فاختفت المحاكاة، والخدع البصرية ،والمنظور والشكل. فماذا تبقَّى لدينا إذن؟
لقد اختلفت الدراسات التي تقيّم مناهج الفنون والبتّ في الحدّ الفاصل بين الفن الجيّد والرَّديء، وجرى تسليط الضوء على خيارين رئيسيين: الأول، هو "المنهج الموضوعي"، حيث يجري التركيز على رسالة، أو حجة العمل الفني. والثاني" المنهج الشكلاني"، حيث يجري التركيز على كيفية إنشاء العمل الفني للمعنى. هذا وقد لعب كلا من الموضوعيين والشكلانيين دوراً أساسياً في الجدل القائم حول تقييم الفن وقيمته. وهناك مفهوم آخر تبلور عبر حركة برلين، دادا، في عام 1922، يرى أن على الفن أن يكون مثيرًا ومحفّزًا، ومراوغًا، ومزعجًا، ومشكّكًا من أجل دور فعّال يعكس من خلاله تحدِّيات المجتمع، ويغيّر العالم. وشعر المفكرون الغربيّون بأن الوقت قد حان للمُضِيّ قدمًا، وإعادة تقييم علاقتنا بالفنان وممارساته. فهو بالإضافة إلى دوره التقليدي في تصوير الجمال، أو الواقع، أو التعبير عن التجارب والعواطف الشخصية، فإن له القدرة على نقل المعنى وإثارة التفكير، أو التأويل، واستكشاف المفاهيم الفلسفية، ناهيك عن الدور الذي يلعبه في التحدي، أو التشكيك في القِيَم المجتمعية. الأمر الذي من شأنه أن يكون وسيلة للتوثيق الثقافي، أو التاريخي، أو التقاط اللحظات، أو الأفكار، أو الأحداث.
إن حاجتنا للتغيير ملحّة جدًا، ولا أحد ينكر هذا، وإرادة التغيير ما هي إلا حجر الزاوية والركن الركين في علاقة الإنسان بإنسانيته، وكذلك بوجوده الاجتماعي. إزاء ذلك إن حذف نظرية الفن التقليدي بجرّة قلم ليس عملاً هينًا ولا مفيدًا، والعكس صحيح. فبينما نجد أن الصلة بين المباحث الشكلانية والموضوعية وثيقة، نراها بالعكس منشغلة بكيفية نسف أحداهما للأخرى. ولعل تصريحات كلا من الفنان الفرنسي ماتيس والمفكر اندري برتون، خير مثال على ذلك:
كتب ماتيس الذي كان مؤمنًا بالجمال الخالد، المكتفي ذاتيًّا، المنفصل عن العالم- ذات مرة: "إنه يحلم بفن التوازن والنقاء والصفاء، فنٍّ خالٍ من الموضوعات المقلقة أو المحبطة، فنٍّ متاحٍ للعاملين في المجال النفسي، ورجال الأعمال والمفكرين...مثل: كرسي جيّد بذراعين يوفّر الاسترخاء من التعب الجسدي".
لم يكن ماتيس موفقاً بالدفاع عن نظرية الجمال بهذا المثل فقد شبّه أعماله بـكرسي التدليك المعاصر، الذي "بإمكانه تخفيف الألم، وتعزيز الاسترخاء"، كما يروّج له في الإعلانات التجارية. وربما كان الفيلسوف دانتو محقاً حين قال إن على الفنان أن لا يقدم شروحات لأعماله الفنية وإنما يترك هذه القضية للناقد/ الفيلسوف ليقوم بالمهمة بدلاً عنه.
على عكس ماتيس تمحور دور الفنان عند برتون حول الدفاع عن المضمون: "إن الفنانين أمثال ماتيس، قد لا يتمتعون بفكر عميق، وإنما هم مهمومون بمظاهر الأشياء، وشؤون الرسم، لا بـبواطنها. إن الفن الوحيد الذي يستحق العناء هو الفن الذي يتحدى مفاهيمنا الذاتية وفهمنا للعالم. وأن مفهوم الجمال، مفهوم نسبي، منفصل تمامًا عن الاهتمامات العملية، وخاصة الاجتماعية والسياسية؛ لأن ما وجدته مجموعات معينة من الناس جميلا، كان بالتأكيد نتيجة لخلفياتهم الثقافية والاجتماعية والبيئية."
بعد عدة عقود كتب الفنان الألماني "جورج باسيليتز" عن خلاصة الوعي المنفصل والمعزول "الخالي من القيمة" على كتالوج خاص بمعرضه الذي أقيم في "وايت تشابل" للفنون في عام ١٩٨٣م كالتالي:
" الفنان: لا أحد مسؤول عنه، دوره الاجتماعي غير اجتماعي. ومسؤوليته الوحيدة هي موقفه تجاه العمل الذي يقوم به. لا يوجد اتصال بينه وبين الجمهور على الإطلاق. لا ينبغي أن يُسأل ولا أن يجيب، لا يقدم لك أية معلومة، ولا يمكن استخدام عمله في شيء. وكل ما يهمّنا اليوم منه هي نتاجاته".


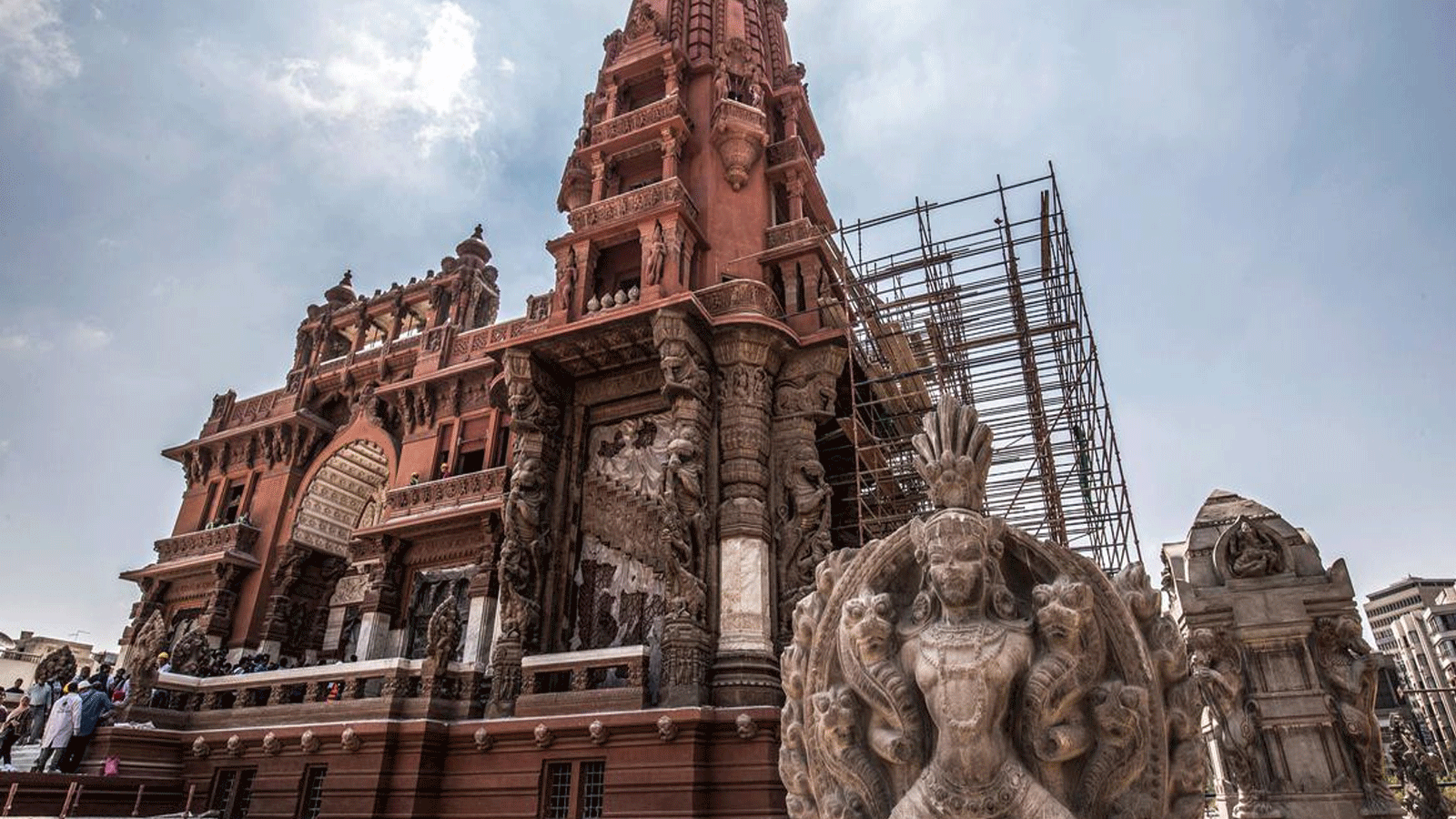









التعليقات