مفردة quot; الحوار quot;، مستحدثة في قاموسنا العربيّ وبالتالي، الإسلاميّ. غنيّ عن القول هنا، أنّ التأكيد على حداثة تلك المفردة، لا يُقصد به معناها القاموسيّ، بل دلالتها المعرفية تحديداً. فمنذ عصر الدعوة كان المسلمون قد بدأوا تبني مفردة quot; المجادلة quot;، بما هيَ عليه من إستلهام لآيةٍ في الكتاب الكريم: quot; وجادلهم بالتي هي أحسن quot;. ثم أضحتْ المفردة هذه، القرآنية، الأكثرَ شيوعاً في عالم الخلافات الإسلامية، وخصوصاً العباسية، المزدهر فيه الفقه والتفسير والفلسفة والتصوف. ففي ذلك العالم، الموسوم، كان الفتحُ الإسلاميّ قد إكتملَ إلى حدوده القصية، من تخوم بوادي الصين مشرقاً، إلى حدود جبال الغال مغرباً؛ وأضحى أوانُ الإهتمام بأمور التجارة وأضرابها، هوَ شاغلُ أهل الخلافة. وما يمكن لنا تسميته، مجازاً، بـ quot; تجارة الفكر quot;، كانت من الرواج زمنئذٍ أنها إشتملتْ على ترجمة آثار الفلاسفة الإغريق إلى اللغة العربية؛ كمؤلفات أرسطو وأفلاطون، الجدلية، على سبيل المثال. ففي حين ٍ كانت فيه تلك المؤلفات، نفسها، مضروبٌ عليها حُرْم ٌ صارمٌ في أقبية الأديرة، في أوروبة، بتشديدٍ من اللاهوت الكنسيّ، بوصفها أراجيف الوثنيين؛ فإنها بُعثتْ في شرقنا المسلم إلى نور الحياة اليومية، الفكرية، بفضل بعض الخلفاء المتنورين، كالمأمون بن الرشيد. الطريف، والهام في آن، أنّ أهل المعتزلة والمتصوفة وغيرهما من الفِرَق الدينية، الإسلامية، إعتمدوا في مجادلاتهم على مفردات وتعابير ورؤى وتحليلات وإستنتاجات، مقتبسة مما تسنى لهم مطالعته في مؤلفات الإغريق، الفلسفية؛ مماهين إياها، بحذاقة، مع عقائدهم وإعتقاداتهم وطرق تفكيرهم. لا بل لقد كان إستشهادُ أولئك المسلمون، المتفلسفون، بكلمات أرسطو في أحاديثهم ومجادلاتهم من السعة والحرية، حتى ليظنّ مستمعوهم أنه أحد رسل الله..
جازَ لي سَوْقُ تلك المقدمة، التاريخية، إشتغالاً على مواجع راهن عالمنا الإسلامي، المبخوس الحظ. هذا العالمُ المقدّرُ له، هنا وهناك، الإبتلاء بحكام متعسفين، جهلة، يشدّ من أزرهم أهلُ العمائم، الأكثر جهلاً. هؤلاء الأخيرون، أضحتْ مهمتهم الوحيدة، كمشرعين مزعومين، تمهيدَ طريق الآخرة للرعية؛ بوصف جنتها الموعودة كبديل، وحيد، للدنيا الفانية، المتخمة بالفقر والجهل والمرض والظلم. وفي الآن نفسه، إباحة هذه الدنيا ذاتها، كجنةٍ أرضية، أبدية، لأولئك الحكام وأسرهم وزبانيتهم، يعيثون فيها فساداً وسلباً ونهباً وبطشاً وإرهاباً: هذه الثنائية، هيَ على رأيي البسيط، أساسُ عثرة عالمنا الإسلاميّ، المعاصر، وسبب محنه المتلاحقة. فالمؤسسات الدينية لدينا، تتضخم حجماً وموارداً وتأثيراً، جنباً إلى جنب مع quot; ضخامة quot; حجم البؤس الشعبيّ وتردي الحالة الإجتماعية والثقافية والسياسية للوطن ككل. فلا غروَ، والحالة هذه، أن تبذل تلك المؤسسات الدينية، عبرَ دعاتها وأئمتها ومرجعياتها، كل ما بوسعها من أجل حَرْف أنظار الرعية عن واقعها المزري، بإفتعال الأزمات وإختلاق أسباب الشقاق، مع الآخر، المختلف دينياً أو مذهبياً؛ وخصوصاً مع الغرب الذي تتهمه، بمناسبة وبدونها، بشن حرب صليبية، جديدة، على عالم الإسلام. هكذا أزمات، لا تلهي جماهيرنا المسلمة عن مشكلاتها الحقة وحسب، وإنما تسهم أيضاً بإضفاء مزيدٍ من الأهمية والخطورة على تلك المؤسسات الدينية؛ بوصفها ـ كذا ـ حاميَة حِمَى الإسلام والمدافعة الغيورة عن قيمه.
حينما يعلن quot; الأزهرُ الشريف quot;، وهوَ أهمّ مرجعية دينية، توقيفَ الحوار الإسلامي ـ المسيحي، حتى يقدّم بابا الفاتيكان quot; إعتذاره quot; لأمة محمّد، عن تصريحه المعروف؛ هكذا إعلان، يستدعي أكثر من سؤال من لدن العارف بخلفياته ومراميه: لكأنما نجحت مؤسستنا الدينية، هذه أو غيرها، في إجراء حوار حضاريّ، شفاف، مع الآخر المختلف دينياً ومذهبياً وإثنياً وفكرياًً، في داخل مجتمعاتها ؛ كيما يحقّ لها نشدان هكذا حوار مع الخارج، الغربيّ، في الضفة المقابلة لمشرقنا المسلم؟ دينياً؛ ثمة أمثلة عديدة على تجاهل تلك المؤسسة ـ كيلا نقول تشجيعها ـ ما يتعرّض له أهل الذمة، من نصارى ويهود وصابئة وغيرهم، من مضايقات لا تحتمل على كافة الأصعدة الحياتية والروحية. وحوادث مدينة الإسكندرية، المتواصلة في كل حين، من تمثلات تلك المضايقات: وهوَ ما يدفع نصارى المشرق والمغرب، العربيين، لنشدان الهجرة إلى بلاد الغرب، النصرانيّ، خلاصاً من واقعهم المزري، كمواطنين من الدرجة الثانية. مذهبياً؛ العمل على ترسيخ شقاق عمره قرابة الألف وخمسمائة عام، بين مذهبَيْ السنة والشيعة، خصوصاً، والتمسك بإعتبار هذا الأخير فرقة ً هرطوقية وأتباعه من الروافض وتكفيرهم، وبالتالي إعطاء المبرر لإباحة دمهم وتدنيس مقدساتهم، من قبل النظام البعثي العراقي، البائد، وأخلافه من الجماعات الإرهابية : فلا عجبَ، إذاً، أن يتجه شيعة بلاد الرافدين أولاً إلى الغرب، وتحديداً أمريكة وبريطانية، لتخليصهم من عسف الطاغية صدام؛ وتالياً إلى جارتهم، إيران الشيعية، بوصفها سنداً روحياً لهم، وأن يعلنوا تبرأهم من أهل العروبة أجمعين. إثنياً؛ الصمت المريب، المتواطيء، على محاولات الإبادة العنصرية، التي تعرّض لها الأكراد ( وهم مسلمون سنة بغالبيتهم العظمى )، طوال النصف الثاني من القرن المنصرم، علاوة على ما يواجهه الآن إخوانهم في الدين والمذهب، في إقليم دارفور السوداني، من محاولات مماثلة: حدّ أنّ هؤلاء وأولئك، خلاصاً من علاقاتهم بأخوانهم في الوطن نفسه، صاروا ينشدون الحماية الدولية، التي يوفرها الغربُ أساساً، ويتهيأون من ثمّ لإعلان إستقلالهم. فكرياً؛ تبني تلك المؤسسة الدينية، المفترض فيها الإعتدال، الإسلوبَ التكفيري / الإرهابي، فيما يتعلق بالعلاقة مع الكتاب والمبدعين، وتدخلها في منح الترخيص لمؤلفاتهم أو منعها بحجج دينية، واهية. وأمثلة التعامل مع روايات نجيب محفوظ، تغني عن كل إسهاب في هذا المضمار: هنا أيضاً، سيدخلُ الغربُ، الديمقراطيّ، على هذا الخط، كملتجأ آمن لأدبائنا، بما توفره أنظمته الليبرالية من حرية تعبير ونشر.







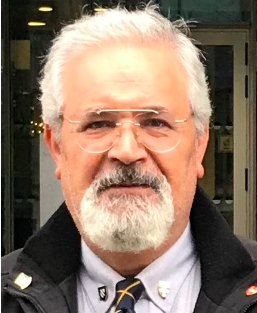
















التعليقات