كثيرون في الشرق من يبشرون بالحرية، ويحاولون تسويقها في أرض لم يسبق لها التعرف عليها، وبين شعوب لم تطلبها يوماً أو تريدها، ويفيض دعاة الحرية في شرح محاسنها وأصولها ونتائجها، لكنهم لا يقتربون أبداً من الوجه الآخر للعملة، والذي بدونه تصير الحرية مسخاً مشوهاً، بل وتصبح أشد وطأة من أسوأ ما عرفت البشرية من مفاهيم وأيديولوجيات، وفي مقدمتها الفاشية والنازية والشيوعية والعروبية، ونقصد بالعروبية هنا ليس مجرد الانتماء إلى جنس العرب، إن كانت لهذه التسمية على أرض الواقع من مسمى، لكننا نقصد بالعروبية ثقافة 'السيف أصدق أنباء من الكتب'، وثقافة 'إن جهل أحد علينا جهلنا فوق جهل الجاهلين'، وثقافة 'سيفي كان في الهيجاء طبيباً يداوي رأس من يشكو الصداع'.
الوجه الآخر المسكوت عنه من عملة الحرية هو المسئولية، المسئولية تلك الكلمة البغيضة والمخيفة في شرقنا، والتي وإن كان المبشرون بالحرية سواء من الغرب أو من أبناء المنطقة المستنيرون لا يقتربون منها بالشرح والتوعية، إلا أن الإحساس الفطري والغامض بها لدى الشعوب، هو ما يدفعها للهروب من الحرية وتفضيل العبودية، التي تلقي بالمسئولية على أكتاف أحد ما، قد يكون شيخ القبيلة، أو الأجداد بصفة عامة، عبر اتباع نهجهم وتقاليدهم، أو تحميلها للحاكم أو رجال الدين، الذين يحولونها بدورهم على الإله، فلقد اتفقنا جميعاً في صمت وسرية، أن الخنوع هو طريق السلامة، لأنه يقينا شر الوجه الآخر من العملة لقيمة مستأصلة من حياتنا وثقافتنا، يحاول الغرب اليوم أن يفرضها علينا، ويجاريه بعض من المستغربين من أبنائنا.
حين نحدث شعب عن الحرية، ونغريه بممارستها، ونتجاهل توعيته بوجهها الآخر وهو المسئولية، فإننا نكون بهذا ندفعه نحو كارثة، وهذا هو ما حدث تماماً في الأراضي الفلسطينية، فقد عرَّفنا الشعب الفلسطيني على الديموقراطية، وشجعناه على الذهاب إلى صناديق الانتخاب، وقلنا له أنه يستطيع أن ينتخب من يريد، وأن قراره هذا سيعتبر مشيئة مقدسة باعتباره رأي الشعب، وعند هذا الحد توقفنا، ربما تصوراً أنه لابد وسيدرك من تلقاء ذاته الوجه الآخر من العملة، رغم أن الإدراك النظري وحده في حالة توفره لا يكفي، فشتان ما بين المعرفة النظرية وبين الاستيعاب أو التمثل، فالتمثل لا يحدث إلا عبر المعايشة الحياتية، والجماهير الفلسطينية (مثلاً) التي سيقت إلى صناديق الانتخاب، والتي لم يسبق لها ممارسة الحرية، بالتأكيد لم يخطر على بالها شيء اسمه المسئولية، فكان أن اختارت الطرف الأكثر براعة في دغدغة عواطفها الدينية، والأكثر إشباعاً لغرائزها البدائية الغضبية، دون أن تسأل نفسها وماذا بعد؟
كان من الطبيعي إذن أن تندهش تلك الجماهير -وإن كان من غير الطبيعي أن يشاركها دهشتها واستنكارها من يعتبرون أنفسهم مفكرين ومثقفين- وهم يواجهون من العالم الغربي بموقف، اعتبروه انقلاباً على دعاواهم الديموقراطية، فالقطيعة التي أعلنها الغرب لمنظمة حماس، كانت في نظر جماهيرنا ومثقفينا، الذين لا يعرفون شيئاً عن الوجه الآخر من عملة الحرية، كانت تعني انقلاب الغرب على الديموقراطية، عندما أتت بمن هم على غير هواه، فيما كانت تعني لدى الغرب تطبيقاً وتفعيلاً لمفهوم الحرية بوجهيها، فمن يختار بملء حريته، عليه أن يتحمل مسئولية قراره كاملة، وهنا كانت المفاجأة غير السارة لكلا الفريقين، الفريق الذي مارس الحرية عن جهل بمضمونها، والفريق الذي روج لها، بأمل تعميمها بالمنطقة، فجاءت النتيجة مخيفة ومحبطة، بحيث صارت التجربة على العكس، مثالاً لمضار تطبيق الحرية في أرض الطغيان!!
لو تساءلنا عن المسئول عن هذا الفشل الذريع، لوجدنا في الصدارة من دفع بالشعوب دون استعداد وتدريب ووعي، إلى خوض تجربة مصيرية، ويبدو الأمر قريب من مثال أن تعلم أحدهم السير بسيارة، دون أن تعلمه كيف يوقفها، فهنا أيضاً الوعي المبتور والتدريب المفتقد، ويأتي بعد هذا ميراث العبودية الطويل بالمنطقة، بل ولا نبالغ حين نقول أن تاريخ الشرق كله محوره العبودية والاستعباد، ويعني هذا أن كلمة المسئولية لا وجود لها في قاموس الإنسان الشرقي، فهو بالأكثر يسمع عنها من بعيد، ويخاف وينفر منها، لكنه لم يمارسها يوماً.
إشكالية أخرى تظهر في تطبيق الحرية تعسفياً، هو أن الحرية الكاملة تحتم تطبيق تحمل المسئولية كاملة، فبكمال تحمل المسئولية سيتاح للفرد أو الشعب تقييم موقفه وخياره، ومن ثم اتخاذ ما يلزم من خطوات لتصحيح ما يلزم تصحيحه من مساره، كما سيتيح هذا أيضاً لكل من يرقب التجربة، أن يدرك أبعاد اللعبة وشروطها، لكن هل استطاع المجتمع الدولي أو الغرب أو حتى إسرائيل، تحميل الفلسطينيين مسئولية خيارهم كاملة؟
هذا بالطبع لم يحدث، فالدواعي الإنسانية تقتضي مراعاة ظروف الناس البسطاء واحتياجاتهم الحياتية، رغم أن خيارهم كان حماس الكراهية والعداء للحياة، التي تجاهر بالقتل والتهديد به لكل الجهات، وبالأخص للجهات التي تمد الشعب الفلسطيني بكل مقومات الحياة، فيما عدا الأحزمة الناسفة والمتفجرات.
هل وصلنا إلى نقطة تعارض بين مفهوم الحرية بوجهيه، وبين الدواعي الإنسانية، التي هي في مقدمة مفاهيم الحداثة، مادامت المسئولية تقتضي أن يتحمل الشعب الفلسطيني (مثلاً) مسئولية خياره كاملة، فيما تقتضي الإنسانية مد يد العون له، بحيث يُفْشِل مفهومي الحرية والإنسانية بعضهما البعض، فتصادر الحرية بشق المسئولية على الإنسانية، وتُفْشِل الإنسانية الحرية، حين تتيح لممارس الحرية أن يهرب من مسئوليته عن حرية قراره واختياره، فتصبح الحرية كما لو كانت نقمة، بدلاً من أن تكون نعمة، بل وتؤدي المعونات الإنسانية في هذه الحالة إلى إعطاء المثل لكل الشعوب، في استمراء الخيار العشوائي العاطفي دون تحسب للنتائج، مادام هناك من سيضطر لتخفيفها عنهم، فيختارون التبشير بالعداء والكراهية وإرسال الانتحاريين بالأحزمة الناسفة، مادامت قوافل الغذاء والدواء وشحنات الوقود لمحطات الكهرباء وغيرها لن تتوقف؟!!
مفارقة هي بالفعل، جذرها الأولي المفارقة الشهيرة بين العدل والرحمة، فغياب العدل والقصاص يحرض المخطئ على التمادي في خطأه، ويحرض آخرين على أن يحذوا حذوه، فجماعة الإخوان المسلمين في مصر وفي العديد من الدول العربية عيونها معلقة بتجربة حماس في غزة، وما إذا كان المجتمع الدولي والعالم الحر بالتحديد، سينجح في تحميلها مسئولية سياساتها كاملة، وتحميل الفلسطينيين معها مسئولية خيارهم، أم ستعترض الدواعي الإنسانية هذا المنحى، وتنجح حماس في الاستمرار قابضة على عنق الشعب الذي اختارها وهو غافل عن مفهوم المسئولية، مادمنا بدون الرحمة لا نصير بشراً بل وحوشاً، وما الرحمة إلا أن نمد يد العون للضعفاء والبسطاء، بغض النظر عن الحيثيات والملابسات.
بعد معركة مخيم نهر البارد، بين الجيش اللبناني وعصابات فتح الإسلام، التي تمترست بالمخيم، وآواها أهله بين جنباتهم، فكان القتل والنهب بلا حساب، وكان تدمير ما يسمى مخيم تدميراً كاملاً، فيما هو بالحقيقة وكما شاهدناه على شاشات التليفزيون مدينة عظيمة، فهل يقوم الآن الكفار ومن والاهم بضخ مليارات الدولارات، لتعود مدينة (وليس مخيم) نهر البارد كما كانت بل وأعظم وأحدث؟ هل ترغمنا الإنسانية على تعطيل قانون العدل، فلا ينال فلسطينيو المخيم ثمار احتضانهم للقتلة باسم الدين، وتتحمل البشرية في ذات الوقت النتائج الوبيلة المترتبة على تعطيل قانون من أهم قوانين الوجود، وهو قانون العدالة والمسئولية؟ أم نعلي من قيمة العدالة، وتقتصر الفعاليات الإنسانية على توفير خيام حقيقية تأوي من لم يصونوا أو يحفظوا جميل اللبنانيين والعالم الحر، الذين وفروا لهم إمكانيات بناء مدينة شامخة، ظلوا يطلقون عليها مسمى مخيم، ليستمر التسول والتباكي، في ذات الوقت الذي يحولونها فيه إلى وكر لوحوش خرافية من عصور ما قبل التاريخ؟!!
يقول الواقع في شرقنا الأوسط أن تمويل إعادة بناء ما هدمه الإرهاب والحرب عليه، لا يؤدي إلى تحسين الأحوال المعيشية، تحاشياً لنمو الإرهاب من جديد بفعل الظروف الحياتية الصعبة، بقدر ما يؤدي إلى استسهال تبني الشعوب وصفوتها لأيديولوجيات الهدم، على خلفية سهولة أو آلية إعادة البناء، ليس البناء على نفقة من كانوا عوامل للهدم، وإنما على نفقة أولاد الحلال من الذين كفروا، وأمامنا هنا نموذج لبنان، رغم أن اللبنانيين شعب بناء بطبيعته، حيث تاريخه الحديث عبارة عن حلقات من الهدم وإعادة البناء، والذي ربما لو توقف إعادة البناء على نفقة الذين كفروا، وترك اللبنانيون ليبنوا بأنفسهم وحدهم ما هدموه، ربما ndash;إن لم يكن بالتأكيد- عندها سيتوقف مسلسل الهدم اللعين!!
يمكن لنا أن نتحاشى الوصول بالأمور إلى حدود هذه المفارقة الأزلية، بالتبشير والتدريب المتدرج للشعوب على الحرية بشقيها: الخيار الحر والمسئولية، بأن نعلم الشعوب أن لكل شيء ثمناً، وأن السير وراء من ينادون بالعداء للعالم له ثمن، هو أن يعاديهم العالم، وأن الاحتفاء بدعوات القتل والذبح وسفك دماء الكفار أنهاراً له ثمن، وهو أن يطاردهم الكفار، ويجردون لهم الحملات، لاستئصال الإرهاب والإرهابيين من على وجه الأرض، ويكون السيد/ جورج بوش وإدارته بهذا ليسوا مجرمي حرب، كما نحب أن نصفهم، وإنما هم جنود الإنسانية، المدافعون عن الحياة البشرية، وعن كل ما شيده الإنسان من حضارة!!
إذا تم التأكيد على جانبي المعادلة أو وجهي العملة، نظرياً عبر التعليم والتوعية، وعملياً عبر الأمثلة الواقعية في تحميل كل صاحب قرار مسئولية قراره، في ظل خطوات تدريجية ومحسوبة في تطبيق الحرية وآلياتها كالديموقراطية، متحاشين القفز الفجائي لتطبيقات لم تمهد لها الأرض والشعوب بدرجة كافية، إذا تم هذا فإننا يمكن أن نسير في طريق التحديث والحرية بلا انكسارات وانتكاسات.
[email protected]
أية إعادة نشر من دون ذكر المصدر إيلاف تسبب ملاحقة قانونيه







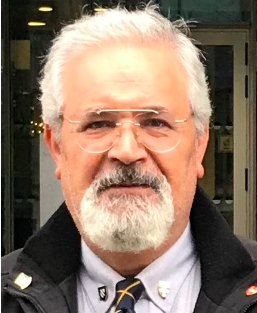













التعليقات