إنه الوصيّ، يتكلم:
أفقتُ صباحاً، مبكّراً، على صخب أغنية quot; علّوش quot;، والتي تبث على مدار الساعة في محطة الإذاعة الوحيدة عندنا، فضلاً عن القناة التلفزيونية، اليتيمة. إنها أغنيتي المفضلة، وأنا معجب بصاحبها. إنه فنان عـ.... عبقري طبعاً، بالفعل! قلتُ لهم مرة ً، فلنجعله نقيباً للفنانين. ولكنهم نصحوني بالتريث، لأنّ النقيب الحالي، المؤبّد، ما زال حياً. أكره سيرة الموت، مع أنها تلاحقني دوماً؛ كراهية مطربنا للفقر، الذي يلعنه في أغنيته تلك. رائحة الجثث، تزكم أنفي. أكانوا حقاً، ضحايايَ أنا؟ أثناء محاكمته في ما يُسمى بقضايا المجازر الجماعية، قال صاحبنا: quot; لم أقتل أحداً، أبداً، بيدي quot;.. يعني يريد القول، أنّ غيري هوَ من جزرَ بأوامر مسؤوله المباشر، وهذا الأخير مأمور للذي فوقه.. وهكذا دواليك إلى أن تضيع الطاسة! ومع حجة الرجل تلك، العصماء، فقد شنقه عملاء الإحتلال الأمريكي. فلمَ عليّ الإعتراف، إذاً، بجريمة ( أو جرائم! ) لم تلوّث بها يدي؟ وفي كل الأحوال، ألم يكن أولئك القتلى، أيضاً، عملاء.. وخصوصاً أولهم، ذلك العدوّ اللدود حياً وميتاً!؟ إنه يأتيني كل ليلة، في الكابوس: quot; لمَ غدرتَ بمُحْسن ٍ، لمْ يطالبكَ قط بدَيْن؟ quot;. أكانَ عليّ، متشفياً، أن أتابع عبر التلفاز منظر سحب جثته، المتفحمة: يا إلهي، ولا حتى في أفلام الرعب، الأمريكية. أمريكية!.. يا لها من كلمة مزعجة، لا بدّ لي من تناولها يومياً ـ كدواء مرّ. ورّطوا صدّاماً بإحتلال الكويت، ثم خوزقوه. وكرروا معنا اللعبة نفسها، أولئك المتغطرسون: ما داموا يتنصتون عبر الأقمار الصناعية على كل مكالمة هاتفية لنا، فلمَ هذا المكر؟.. لو أنّ نيتهم صافية، لكان بوسعهم إنذارنا قبل تنفيذ عملية التفجير، على الأقل. كنا ربما أجلنا العملية، أو حتى ألغيناها. فنحنُ قبل كل شيء، أشقاء اللبنانيين: شعبٌ واحد في بلدَيْن!
quot; هاتِ المَنجيل والمَنكوش / ولحقني بالزوادي quot;.. أتابعُ الإستمتاع بأغنيتي تلك، المفضلة. لديّ وقتٌ متسع، أقتله بسماع الموسيقى والطرب. القتل: تباً لها من كلمة مرعبة، تؤرق ليلي ونهاري! فمنذ إغتيال الحريري، ما عادَ مسؤولٌ معتبر، غربيّ أو عربيّ،، يودّ رؤيتنا. وقتي والحالة تلك، محصورٌ بمراجعة التقارير الأمنية. تضخمت أجهزتنا الأمنية وكبر ملاكها وصار فائضاً عن اللزوم. ولكننا مضطرون لإستقبال المزيد من المنتسبين لفروع المخابرات المختلفة، السياسية والعسكرية والجوية والبرية والبحرية، والفضائية: إذ لا يجوز بقاء شخص واحد من جماعتنا بلا عمل، ذكراً كان أم انثى. هجرَ معظم الشباب قراهم وإستقروا في العاصمة والمدن الرئيسية. تركوا حقولهم وكرومهم في الجبل والساحل من أجل وظيفة هنا أو هناك ـ كعنصر أمني أو حارس شخصي أو سائق خاص. وبناتنا، ما شاء الله، غزوْنَ التلفزيون والإذاعة والسينما، حتى تمّ تصدير الكثير منهن إلى دول الخليج لعمل المسلسلات والأفلام والطقاطيق و.. الخ! لذلك علينا معرفة المعنى العميق لتلك الأغنية، العلوشية، الموجود خلف مفرداتها البسيطة. لننسَ إذاً المنجل والمنكوش والزوادي، ولتذكرَ الأخطار المحدقة: يلعن أبو الفقر!
أعرف أن كثيرين، ( خصوصاً ممن يُسمّون حالهم معارضة ) سيتخرّصون بأنّ ما سبقَ من كلامي، لهوَ دليلٌ على أن نظامنا طائفيّ. الحقيقة غير ذلك. فتلك القرى التي خلفناها وراءنا، ليست فارغة تماماً، كما قد يتهيأ لذهن البعض. فكل ضابط من جماعتنا، أو حتى صف ضابط، عسكرياً كان أم أمنياً، لديه في ضيعته فيللا أو مزرعة. ومن سيخدم فيها غيرَ عناصره المجندين؟ وبما أن غالبية هؤلاء الأخيرين من العاصمة والمدن الكبيرة، فذلك يعني أنّ الوضعَ على ما يرام وطنياً؛ أيْ أن تبادلاً للأماكن قد حصل ليس إلا: وبعد كل شيء، أليسَ الجميع أولاد الحزب الواحد والأمة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة!؟ لا أعتقد أنه ثمة مثال أكثرَ سطوعاً ووضوحاً، على الوحدة الوطنية، كما هوَ الحالُ لدينا في سورية. تجربتنا هذه، كما تعرفون، نحاولُ مخلصين نقلها إلى لبنان، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية. وبسبب موقفنا القوميّ، تحديداً، كانت تلك المحاولات المحمومة، المشبوهة، التي تهدف إلى إبعادنا عن شؤون ذلك البلد الجار وشعبه الشقيق. هذا يقودنا، مجدداً، إلى قضية الحريري. فمع كل ما في جعبتنا من حجج، مقنعة، يريدون سحبنا إلى المحكمة الدولية. شكلنا بدورنا محكمة بديلة، عربية سورية، للتحقيق في إغتيال الرجل، مع قضاة ودفاع.. وشهود فوق ذلك ـ كالمقنع الكردي ( ماذا كان يُدعى؟ ).. ثمّ توصلنا إلى المجرمين وطلبناهم عن طريق الأنتربول، لأنهم موجودون في الحكومة اللبنانية الحالية، المتشكلة بعيد إنسحابنا: تعرفونهم، هذا الوزير وذاكَ النائب!
إقترحنا على الغربيين أخيراً ـ على فرض أننا مذنبون ـ أن نضحّي كرمى لعين صداقتهم بأربعة مسؤولين من عندنا، أمنيين، ونخلص! لم ينصتوا، أيضاً، لإقتراحنا. لماذا لا تقول أنّ هذه القضية، الحريرية، قد أضرت بالعملية الديمقراطية.. في سورية: والآن جميع المعارضين وضعتهم في المعتقل بلا محاكمة ملاكمة.. خيّرتُ الغرب ـ وخصوصاً أمريكة، بين حريّة هؤلاء المعارضين وحريّتي الشخصية! من ناحية اخرى، فثمة أوراق كثيرة لديّ، أستعملها بنجاح: الجولان وفلسطين والعراق، ولبنان طبعاً. لا بدّ أن أنجو. بقيَ أبي على مدى ثلاثين عاماً يجزر في الخلق سوريين ولبنانيين وفلسطينيين و.. ومات معززاً مكرماً، لا دجيل ولا أنفال ولا تدمر ولا حماة. فلمَ عليّ إذاً دفع ثمن خدمة بسيطة، لا تعدو عن كونها تقريبَ أمرءٍ من ربه، كما قال الرفيق.. أعني، سماحة المفتي؟! ولكنّ ضميري مرتاحٌ، ما دامت يدي لم تلوث، أبداً، بالدم. ثمّ أنّ هذه القضية، من ناحية اخرى، قد كشفتْ زيف الديمقراطية الغربية وبيّنتْ بالدليل القاطع أنّ لديهم أيضاً خيار وفقوس! كيف، سأقولها لكم. عندهم شيء إسمه أسرار دولة، ولا يجوز قبل مرور ثلاثين سنة فتحَ أرشيف الموت.. أعني، أرشيف الأمن!؛ كما في مثال إغتيال الرئيس كيندي، الممكن مقارنته مع إغتيال الرئيس الحريري. عال! أنا أيضاً على إستعداد كامل للتعاون مع المحكمة الدولية، بشرط مرور مهلة الثلاثين عاماً تلك: إنها أسرار دولة، ولاااا!
[email protected]
- آخر تحديث :








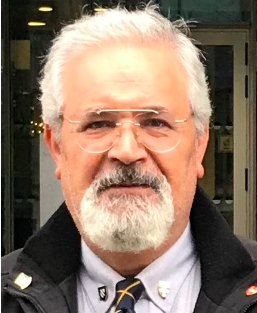














التعليقات