حسن حنفي
لاشك أن ممارسة العبادة والشعائر الدينية حق مشروع لكافة الناس، وكذلك أماكن هذه العبادة والحفاظ عليها، معبداً كانت أم كنيسة أم مسجداً. فمصدر الدين واحد بصرف النظر عن مراحله المتتالية: اليهودية والمسيحية والإسلام. كلها دين التوحيد، دين إبراهيم عليه السلام، الدين الطبيعي، دين الفطرة. يقوم على التوحيد والعدل، التوحيد في السماء، والعدل في الأرض. يبعث في النفس الاطمئنان والسكينة والهدوء. ويقيم العلاقات بين الناس على الأخوة والمحبة والسلام. ليس فقط في علاقة الإنسان بالخالق جل شأنه، ولكن أيضاً في علاقته مع أخيه الإنسان. وليس فقط مع المجتمع بل أيضاً مع الدولة التي تمثل المجتمع في نظام سياسي. وقد رسخ هذا النوع من التوافق مع الذات والآخر، وإن بصيغ مختلفة في السلوك الديني في ديانات وعقائد أخرى مثل الرهبنة في الهندوسية والبوذية في الهند، والعمل الصالح في الكونفوشوسية والتاوية في الصين، حيث ينشد التوحد مع النفس، والتوحد مع الآخر.
ومع ذلك ففي شوارع مصر وميادينها ظاهرة فريدة، الشرطة أمام الكنائس حماية لها من العدوان عليها! وهو وضع متناقض. الكنيسة للسلام والأمان، والشرطة لصد العنف والعدوان. الكنيسة للتوبة والغفران، والشرطة لإيقاف أصحاب الذنوب والعصيان. وهل دُور العبادة مثل السفارات والهيئات الأجنبية بحيث تتطلب هي أيضاً الحماية من احتمال التعدي عليها، في حالة سوء المعاملة في الداخل أو العدوان في الخارج؟ أليست الكنيسة جزءاً من الوطن، الكنيسة الوطنية، منذ كنيسة الإسكندرية الوطنية ضد السيطرة الرومانية باسم المسيحية، ومنذ الفتح الإسلامي حتى ثورة 1919 وحرب أكتوبر 1973؟ الكنيسة جزء من الوطن عبر تاريخها الطويل وما زالت. وهي ليست كياناً غريباً عنه يحتاج إلى حراسة أمن مثل السفارة أو الهيئة الأجنبية. ومعنى حراستها قد يعطي انطباعاً خاطئاً بأن هناك خللاً في المواطنة والمساواة، وأن هناك خللاً في الهوية، ضعفاً في الهوية الوطنية، ووهماً بإيجاد البديل في الهوية الطائفية. وبدلا من أن يكون الدين عاملا على تأكيد الهوية الوطنية يكون نقيضاً لها، بهذا المعنى الخاطئ إحساساً من الجماعة الدينية بالعزلة عن الجماعة الوطنية، وأن هناك أقلية دون الأغلبية. وبدلا من أن يتوجه الوطن إلى أعدائه في الخارج ينقسم على نفسه، ويخلق عدوّاً من داخله، أغلبية ضد أقلية، وأقلية ضد أغلبية. هذا مع أن أصل المسيحية والإسلام دين واحد، دين المحبة والسلام. ولا يوجد دين عظَّم المسيح، عليه السلام، واعتبره كلمة الله وروحاً منه وعظم أمه مريم وفضّلها على نساء العالمين كالإسلام.
وعلى رغم توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل في 1979 بعد زيارة القدس في 1977 وبعد كامب ديفيد في 1978 إلا أن المعبد اليهودي وسط القاهرة تحرسه هو أيضاً الشرطة. وتقف أمامه عربات الأمن. ويُمنع وقوف السيارات أمامه خوفاً من العربات المفخخة. واليهودية في مصر جزء من تاريخها قبل نشأة الكيان الصهيوني في 1948، وهجرة اليهود المصريين واليمنيين والمغاربة والعراقيين ومعظم اليهود العرب إلى إسرائيل، ليكونوا اليهود الشرقيين quot;السفارديمquot;، غالبية اليهود في إسرائيل في مقابل اليهود الغربيين quot;الأشكنازquot;، وأخيراً اليهود الروس والأحباش. وقد كان اليهود في مصر جزءاً من الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفنية. ورفض بعضهم الهجرة إلى إسرائيل مفضلين وطنيتهم المصرية على طائفيتهم اليهودية. ولم يزدهر اليهود قدر ازدهارهم مع العرب في إسبانيا حيث عاشوا عصرهم الذهبي. وظهر كبير فلاسفتهم موسى بن ميمون، الذي كان في الوقت نفسه طبيب الكامل. وكتبوا تراثهم بالعربية بحروف عبرية، جمعاً بين الشمولية في الفكر والخصوصية في اللغة. إلا أن الصهيونية الغربية التي احتلت فلسطين وشردت شعبها واحتلت أراضي لمصر وسوريا ولبنان وظلت باستمرار مصدراً للعدوان على العرب، وتحلم بـquot;إسرائيل الكبرىquot; من النيل إلى الفرات، ما زال يرفضها شعب مصر. نعم، يرفض التطبيع والتعايش مع كيان عنصري عدواني. ولو عاد اليهود المصريون جزءاً من الحياة المصرية كما كانوا لما كانت هناك ضرورة لوجود رجال شرطة أمام المعبد، ولا حراسة ولا خوف من الغضب الشعبي المصري.
أما دُور العبادة الإسلامية فلم تسلم هي أيضاً من حراسة الشرطة للمساجد، والإسلام دين الأغلبية. فتقوى الحراسة خاصة بعد صلاة الجمعة حيث قد تخرج المظاهرات الشعبية للمناداة بالمطالب الاجتماعية والسياسية حتى أصبح الأزهر رمزاً للإسلام الوطني. والنضال الوطني شرف له، ومقياس للحياة السياسية والاستقرار السياسي. صحنه بديل عن الميدان، ومصلوه نموذج للمواطنين عبر التاريخ الحديث منذ محمد علي الذي نصّبه مشايخ الأزهر وعلماؤه واليّاً على مصر. فالأزهر نيابة عن الشعب، والمتحدث باسمه كان حاضراً في النضال الوطني ضد الاحتلال في الخارج والظلم في الداخل قبل أن تنضم إليه الجامعة المصرية منذ نشأتها في 1925.
وجود الحراسة أمام دور العبادة، قد يعتقد البعض أنه فشل في تحقيق الوحدة الوطنية بين عناصر الأمة، وفشل في وحدة الوطن بين العامة والخاصة، بين الطبقة السياسية والطبقات الشعبية. لم يستطع البلد تحويل الدين، وهو العنصر الرئيسي في الثقافة، إلى عامل مساعد لتأكيد الوحدة الوطنية، وليس إلى عامل نقيض ضدها على رغم ما لديه من إعلام مؤثر ودولة مسيطرة. أصبحت وسائل الضبط هي أداة السيطرة على الحياة العامة الدينية والمدنية، لا فرق بين دُور العبادة والجامعات، بين دور العبادة والمؤسسات العامة، بين دور العبادة والسفارات والهيئات الأجنبية. الكل في حاجة إلى حراسة وأمن. يعتمد على الشرطة فإذا لم تستطع تولى الجيش ذلك.
والحقيقة أن الأمن والتعايش السلمي في داخل النفوس وليس خارجها، في قلوب الناس وليس في عصي رجال الأمن وخوذاتهم. الأمن في الحرية للجميع، والعدالة الاجتماعية بين الناس، والمساواة أمام القانون. الأمن في الاستقلال الوطني والهوية الوطنية حتى لا تتحول جماعة وطنية مفتوحة إلى جماعة دينية مغلقة. ليس بالقوة وحدها يمكن تحقيق الاستقرار. ثم قد نشكو من تشويه صورة مصر في الخارج، ومن نشاط بعض الأقباط المعادين لمصر في الخارج، والذين قد يستغلون أجهزة الاتصال الحديثة لبث الأخبار والصور، صحت أم كذبت. الوطن قوة جاذبة لأبنائه وليس قوة طاردة، مكان تجميع وليس مكان تفريق، موطن محبة وتآلف وليس مكان خصام وتنافر. لذلك سُمي الوطن من الموطن. ومنه المواطنة. فليس بقوة الضبط وحدها يحيا الوطن.






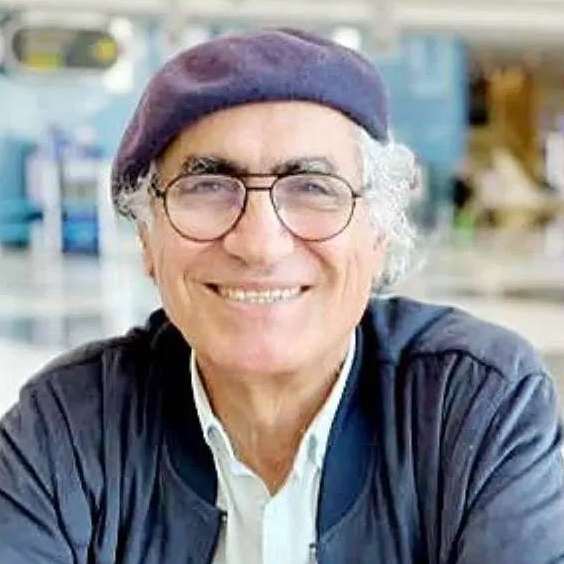










التعليقات