محمد عيادي
ثورة الشعبين المصري والتونسي على نظامي بن علي ومبارك، ومطالبهما المشروعة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والتعددية السياسية وحرية الإعلام، وشفافية الانتخابات وما إلى ذلك من المطالب، أفقدت بعض القومجيين توازنهم وأحيانا أدبهم، فعمموا الأحكام بقولهم بجزم وحسم وإطلاقية، أن ما حصل في تونس ومصر وما يجري في ليبيا سيحصل في كل الدول العربية بلا استثناء، وأن السبيل الوحيد للتغيير هو تغيير الأنظمة الحاكمة.
ولئن كانت الشعوب العربية جميعا تطمح للتغيير والإصلاح بما يحفظ كرامتها ويعطي القيمة لصوتها ويستجيب لإرادتها، فإن القول بتعميم الحالة التونسية والمصرية لا يسنده منطق، لأنه بذلك يصور وكأن الدول العربية كلها بدون استثناء كانت تسير وتحكم بالطريقة ذاتها التي كان يتبعها كلٌ من بن علي ومبارك، وهذا الكلام فيه مقارنة عدمية وغير موضوعية.
قال أحدهم في برنامج laquo;الاتجاه المعاكسraquo; على قناة الجزيرة في الحلقة ما قبل الأخيرة، إن laquo;الزلزال الذي ضرب النظامين التونسي والمصري سيقتلع باقي الأنظمة العربية، وسيحرك كل الشعوب العربيةraquo;، مشيراً إلى أن ذلك حصل بعد ثورة 1952 بمصر.
لكن الذي حصل أن ثورة الضباط الأحرار بزعامة جمال عبدالناصر بمصر، لم تتكرر إلا في دول عربية أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، أقامت أنظمة عسكرية بواجهات مدنية، وأُريدَ لها أن تتحول فيما بعد من جمهوريات إلى ما يوصف بـ laquo;جملوكياتraquo;، فيما تكيفت وتفاعلت دول أخرى مع المتغيرات الدولية، ومقتضيات الحداثة السياسية مع اختلاف درجات التكيف والتفاعل، دون أن تفقد خصوصياتها.
والمحللون الموضوعيون بمن فيهم محسوبون على التيار القومي، أكدوا أنه يمكن تحقيق التغيير والإصلاح في عدد من الدول العربية، دون أن يتكرر فيها السيناريو التونسي والمصري ولا الليبي أيضا، خاصة تلك الدول التي لم تسمح لحزب واحد بالهيمنة على كل شيء من كرسي الحكم إلى رئيس مجلس قروي أو عمدة بلدة نائية، واحتكار السياسة والاقتصاد والتحكم بالإعلام وبالنقابات و...، وجعل الجميع في خدمة الحزب الحاكم، بالشكل الذي يؤهله ليحصل على %90 من المقاعد في المجالس التشريعية وغيرها.
إن الدول التي لم تسمح بهيمنة الحزب الواحد الحاكم، وحافظت على التعددية السياسية، وتركت هامشا لحرية الإعلام ونشاط المجتمع المدني وما إلى ذلك، قد تعرف احتجاجات ومطالبات بالتغيير والإصلاح، ولكن من داخل نفس النظام القائم، خاصة إذا كان هذا الأخير لا يعاني من أزمة شرعية ومشروعية، وله مصداقية لدى الشعب كما هو الحال بالنسبة للنظام الملكي بالمغرب مثلا، ولديه القدرة على التكيف مع المتغيرات واستيعابها دون فقدان خصوصياته.
لكن للأسف كثيرون ممن يتكلمون عن المغرب يجهلون واقعه السياسي والاجتماعي والميزات التي جعلت أبناءه يتكلمون عن الخصوصية المغربية، ويعتزون بها.
يجهلون أن العلاقة بين الشعب المغربي والمؤسسة المَلَكية قائمة تاريخيا على تعاقد شرعي (البيعة) وتعاقد سياسي متجدد.
يجهلون أن المغرب عاش منذ الستينيات والسبعينيات حراكا سياسيا واجتماعيا مستمرا طبعه التشنج والصراع على السلطة فيما يعرف بسنوات الرصاص، وعرف محاولتين انقلابيتين فاشلتين في بداية السبعينيات، ثم عرف مرحلة طبعتها رغبة في الحوار مع مد وجزر في أواخر الثمانينيات والسعي للتوافق في التسعينيات ونهاية الصراع على السلطة، وبدأ مرحلة الانتقال الديمقراطي والاختلاف على التدبير والحكامة وليس على الحكم، وتجدد الإجماع على أهمية المؤسسة الملكية رمزا للوحدة والسيادة المغربيتين كما كانت تاريخيا.
يجهلون وربما يتجاهلون، أن المغرب دخل في ثورة متجددة انخرط فيها الملك والشعب، وهي ثورة الانتقال الديمقراطي بالتوافق بين الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله والقوى السياسية المعارضة -التي هيمن عليها اليسار بمختلف تياراته- أثمرت إطلاق المعتقلين السياسيين والإصلاحات الدستورية لعامي 1992 و1996، واستمر هذا التوافق مع تولي الملك محمد السادس الحكم في يوليو 1999، وإطلاقه في أكتوبر من السنة نفسها المفهوم الجديد للسلطة، والإعلان بعد ذلك عن تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة لمداواة جراح الماضي، وجبر ضرر المعتقلين السياسيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاختفاء القسري فيما يسمى بسنوات الرصاص برئاسة أحد ضحايا تلك الانتهاكات الراحل إدريس بنزكري، وهي الهيئة التي لم يسبق لها مثيل في العالم العربي في إطار ما يعرف بالعدالة الانتقالية وطي صفحة الماضي، والتطلع لمغرب أفضل ديمقراطيا وحقوقيا وسياسيا.
يجهلون وربما يتجاهلون أن المغرب فتح الباب للمعارضة السابقة لتدبير الشأن العام، وتشكيل العمود الفقري لحكومة التناوب سنة 1998 بقيادة أبرز المعارضين السابقين عبدالرحمن اليوسفي الأمين العام وقتها لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
يتجاهلون وربما يجهلون، أن المغاربة تمرنوا منذ سنوات عديدة على الاحتجاجات خاصة في العقد الأخير (2000 حركة احتجاجية سنويا)، وتكاد تكون الساحة المقابلة لمقر البرلمان محطة يومية لحركات احتجاجية متنوعة وبمطالب متعددة.
يتجاهلون أن المغرب لم يختر الطريقة التونسية والمصرية في التعامل مع الحركة الإسلامية التي اختارت العمل القانوني والمؤسساتي، وفضل إدماجها في العملية السياسية، ورفض نهج الإقصاء والاستئصال.
ولست بهذا أنفي وجود مشاكل في المغرب على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك السياسي، وظهور تيار معجب بالنموذج التونسي والمصري، وبدأت ملامح تشكل حزب يسميه البعض بالحزب الأغلبي والآخر بالحزب السلطوي، تلوح في الأفق خاصة بعد حصوله على المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية (البلدية والقروية) سنة 2009، رغم أنه لم يمض على تأسيسه سوى بضعة أشهر، الأمر الذي جعل عددا من الأحزاب السياسية المغربية تطرح علامات استفهام على هذا الوافد الجديد على حدّ وصفِ قياديّ في حزب الاتحاد الاشتراكي.
لست بهذا أنفي وجود اختلالات بالمغرب تحتاج للمعالجة والإصلاح، ولكن وددت التنبيه إلى أن القوى السياسية المغربية والمجتمع المدني والإعلام المغربي عموما، والإعلام الحزبي و laquo;المستقلraquo; خصوصا، أو ما يعرف بمؤسسات الوساطة، ما زالت حية ولها تأثيرها رغم ما أصابها من laquo;روماتيزمraquo; في المفاصل قابل للعلاج، وكانت وما زالت قادرة على الحديث بصوت واضح ومسموع عن المشاكل التي تعرفها البلاد، والمطالبة بالإصلاحات في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي، وهي ذات المطالب تقريبا التي رفعت في وقفات ما سمي بحركة 20 فبراير الأحد الماضي بعدد من المدن المغربية التي هيمن عليها الحضور اليساري الراديكالي، من قبيل مطلب الإصلاح الدستوري وفصل حقيقي بين السلطات، واستقلال القضاء، وجهاز تشريعي (البرلمان) قادر على محاسبة حقيقية للجهاز التنفيذي (الحكومة) وسلطات أوسع للوزير الأول، ومحاربة الرشوة والفساد المالي والإداري، ومؤسسات تمثيلية ومجالس تعبر عن إرادة الناخبين، وهذا يؤكد في المحصلة، حقيقة واضحة يُغفلها أو يتغافل عنها عدد من laquo;المحللينraquo; والمراقبين من خارج المغرب، وهو أن المغاربة باختلاف مشاربهم السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية، مقتنعون بإمكانية الإصلاح من داخل نفس النظام، ومؤمنون بأن المؤسسة الملكية قادرة دائما على الإنصات لنبض الشعب والتجاوب مع مطالبه، والتفاعل مع القوى السياسية والمجتمعية، واستيعاب المتغيرات والاستفادة منها بإطلاق مبادرات إصلاحية شجاعة ضمن استراتيجية التغيير في إطار الاستمرارية، وهذا هو النموذج المغربي.





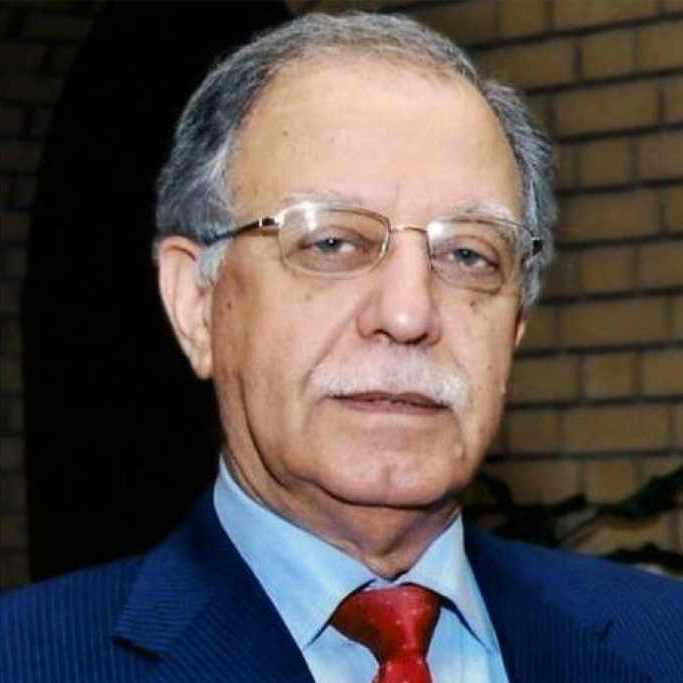





التعليقات