عبدالعزيز المقالح
هو واحد من أسئلة كثيرة تطرحها اللحظة الراهنة بإلحاح، انطلاقاً من الوقوع المتكرر في أخطاء شهدها ماضينا وحاضرنا القريب وما نزال نشهدها. وهو سؤال تكررت الإجابة عليه، ابتداءً من بداية محاولات التحديث و«العصرنة»، ومنها إجابات لعدد من المؤرخين وروّاد ما كان يسمى بعصر النهضة. ونبقى نحن، وفي هذه اللحظة الفارقة أحوج ما نكون إلى طرح السؤال والبحث في الإجابة عليه، لا في صيغته الموضوعة في العنوان فحسب؛ بل وفي صيغ مختلفة منها: لماذا ندرس التاريخ؟ ولماذا ندرّسه في مدارسنا وجامعاتنا؟
وأمامي الآن أحدث إجابة على السؤال كما جاءت في دراسة عميقة لمؤرخ عربي معاصر، وقد اخترقها على النحو الآتي: «هناك حقيقة يتجاهلها كثيرون، وهي أن الهدف الأول من دراسة التاريخ هو خدمة الحاضر والمستقبل، وأنه لا معنى للاهتمام بوقائعه والغوص في تفاصيله إذا لم يكن مفيداً للحاضر الذي نعيشه والمستقبل الذي نطمح إليه، فاهتمامنا بتاريخنا هو تعبير عن اهتمامنا بحاضرنا ومستقبلنا أكثر مما هو تعبير عن اهتمامنا بماضينا، لأن الماضي قد طويت صفحته بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات، من انتصارات وانكسارات، ونجاحات وإخفاقات، ولم يعد بإمكاننا تغيير أي شيء من وقائعه أو تعديل أي مفصل من مفاصله، ولكن علينا أن نستفيد من دروسه وعِبَره في تغيير حاضرنا ورسم معالم مستقبلنا. ومن هنا ينبع سر اهتمامنا به وأهمية دراسته واستحضاره».
هل أدركنا، من خلال هذه الإجابة العميقة والواضحة المعنى الكامن من وراء قراءتنا للتاريخ، ومن ثم دراسته وتدريسه؟ وفيما يشبه اليقين عندي، فإننا لم ولن ندرك هذا المعنى، وأن الهدف كما حددته الإجابة سيظل غائباً، وتبقى قراءتنا لتاريخنا ضرباً من التسلية، وفي أحسن الأحوال ضرباً من معرفة ما جرى، ولا فرق في حياتنا بين أن نقرأ التاريخ ولا نفيد من التجارب التي تراكمت على طريقه، أو نتابع المسلسلات والأفلام الخيالية التي تساعدنا على قتل الوقت والاستمتاع أو النفور من بعض المشاهد التي لا تعنينا في حقيقة الأمر، ولا تجد لها صدى في عقولنا ومشاعرنا. ولعل أسوأ ما في قراءتنا للتاريخ العربي والإسلامي، خاصة أن بعضنا ينتقي جملة من الوقائع المتقادمة، ويكتشف من خلالها مداخل لخلافات معاصرة تتبدد فيها ومعها طاقة الأمة وقدراتها وتتعزز معها خلافاتها، وإذا كان العقلاء قد نجحوا في وعيها ووضعوها في إطارها التاريخي القديم بعد تنقيتها مما لحق بها من مبالغات، فإن الجهلاء قد ألبسوها صيغة معاصرة، وكأنها حدثت بالأمس.
والسؤال الذي ينطلق من هذا التحريف والتخريف هو: ألا يكفينا ما وضعه الأعداء المعاصرون لنا على طريقنا من أسوار وحدود حتى نعود للغوص في أعماق التاريخ لننتزع من بين وقائعه المشكوك في وقوعها بالصورة التي رويت بها لتكون وقوداً يلتهم ما تبقى في وجدان الأمة من وشائج القربى ومكونات التعايش؟ وأعترف أنني لم أعد أغضب أو أثور في وجه أولئك الباحثين والمفكرين الأجانب الذين يسخرون من طريقة تعاملنا مع تاريخنا، ومن وقوفنا عند بعض الأحداث والوقائع التي أكل عليها الدهر وشرب، وكيف تعمل على تغييبنا عن واقعنا، وما نحتاج إلى معرفته، وتمثله في أعمالنا وسلوكنا مع أنفسنا ومع الآخرين. إن السخرية هي أقل ما نستحقه جراء مواقفنا الجاهلة والسطحية مع تاريخنا القديم الذي هو أعظم وأوسع من أن يختزل في واقعتين أو ثلاث.
لقد شهدت أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حروباً مذهلة ذهبت فيها مئات الآلاف من الضحايا، كما شهدت في النصف الأول من القرن العشرين مجازر مروعة بلغت ضحاياه ما بين خمسين إلى ستين مليوناً، ومع كل ذلك استعادت أوروبا تماسكها، وواصلت بناء حضارتها، مستفيدة من التجربة في تقوية أواصر التعاون والتقارب السياسي والاقتصادي، ونجحت في إسدال ستار كثيف على مجريات تلك الظروف ووضعها في زوايا النسيان.






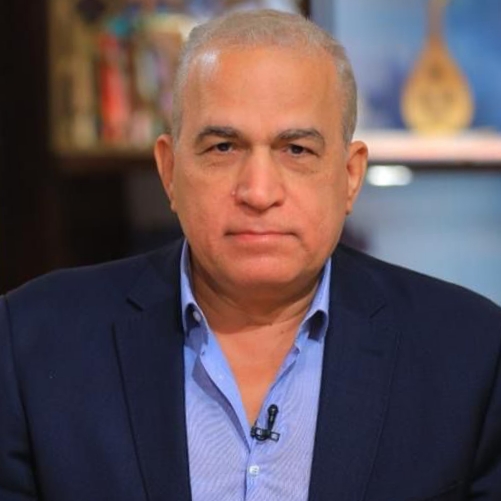






التعليقات