هل لاحظت أن المعضلات المزمنة في العالم العربي، هي في الحقيقة ضروريات عاجلة منذ مطلع القرن العشرين؟
لو جادنا الغيث حتى في منتصف القرن الماضي، لكانت الديار العربية غير ما هي اليوم. دعابة سوداء أن يصير العمل العربي المشترك مشكلة لا حلّ لها. كل التجارب أخفقت، لم يبق إلا تشكيل لجنة من علماء النفس والاجتماع لإجراء الفحوص اللازمة.
القضايا نامت نومةً رقيمية، لهذا لعب المكر في الأذهان. من أحسن الظن اعتقد أن العرب اتفقوا على ألاّ يتفقوا، ومن أساء الظنون غمز وهمز ولمز، مدعياً وجود ضغوط خارجية، وفئات أخرى تُردد التمائم درءاً للعين والنفّاثات في العُقد. منطقياً، الأوضاع غير المعقولة تُسفر عن تصوّرات تنافي العقل، إلا ما كان مرتبطاً بأيدٍ خفيّة، في الكواليس الدولية.
القضايا أبعد وأعقد من أن نحصرها في السياسة ومصادر القرار، ولو كانت من ذلك الطراز، لكان أقل من ثلاث وثلاثين قمّة كافياً كفيلاً بفكّ المربوط وإعتاق المضغوط. لا يمكن إهمال الأبعاد الثقافية والفكرية في المشكلات المزمنة الكبرى. ماذا يعني وجود معضلة مستمرة قرناً في العلاقات البينية العربية؟ الموضوع الجدير بالدراسة، هو تشخيص الأسباب الذهنية والنفسية التي أدت إلى عدم قدرة العقل العربي على التفكير العملي الإيجابي؟ المقارنة حاسمة: لماذا كانت دول الشرق الأقصى مختلفة؟ لهذا أوصلتها مسيرات تنميتها إلى مراتب عالمية؟ ولِمَ الذهاب إلى بعيد؟ كيف استطاعت دولة الإمارات في نصف قرن تحقيق أكبر حلم تنموي عربي؟ قد لا يكون علمياً الحديث عن ضرورة المراجعة الكاملة لطرائق أداء الدماغ العربي، ولكن مضمون الكلام لا يخلو من العقلانية.
يجب إعمال الفكر ملياً في هذه الدائرة من كل جوانبها: هل من المعقول ألاّ توجد روابط سببية للفشل العربي في تطوير التعليم طوال قرن؟ لماذا أخفق العالم العربي في تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائياً ودوائياً؟ العصر الزراعي ظهر قبل عشرة آلاف سنة. الثورة الصناعية بدأت في القرن التاسع عشر. أين اقتصادات جلّ العرب؟ لماذا استطاعت البرازيل التوفيق بين التنمية الشاملة وكرة القدم؟ لماذا ظل البحث العلمي ممتنعاً لا يشكّل غيابه همّاً، والعقول تهاجر؟
لزوم ما يلزم: النتيجة السحرية: نسينا أمراً مهماً، أن يكون العقل العربي «عملوا له عملاً».














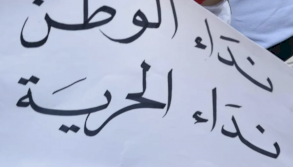


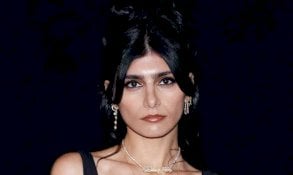
التعليقات