محمد الدخيل&
&
&
مدخل:
ربما كان (الديك) مثالاً صادقاً وحياً للإنسان الملتزم (وهو ليس ديكاً حقيقياً لكنه شخص من مدينتي يلقبه الناس بهذا الاسم) فهو يرفض استخدام كل ما أنتجته الحضارة الحديثة من منتجات كالسيارات والكهرباء، ويصر على العيش بنفس النمط الذي كان عليه العيش في مجتمعنا قبل أن تهجم علينا الوسائل الحديثة للحياة.
وحينما تذهب إلى أحد (الخبوت) حيث يعيش وحيث مسجده الطيني الذي يؤم الناس فيه تجد حصانه مربوطاً إلى شجرة قريبة من ذلك المسجد وحين تنتهي الصلاة ويبدأ جماعة المسجد في الخروج تشاهده وهو يفك رباط حصانه وينطلق إلى بيته معتلياً صهوة جواده بشموخ يذكرك بشموخ فرساننا الأوائل.
إنها حالة غريبة أو لنقل إنها حالة خاصة. ولكن .. كيف يمكن قراءة هذه الحالة؟ إنها - في رأيي - صدمة الحضارة. فالديك حين صدمته الحضارة الجديدة التي جاءت لتغير عالمه الذي ألفه وتماهى معه لم يكن من السهل عليه التخلي عن ذلك العالم وقبول هذا الشكل الجديد، فأعلن رفضه التام لهذه الحضارة الجديدة، ولكل ما تقدمه من فكر، وعلوم، وثقافة، إنه يعلن التزامه بالعالم القديم والثقافة القديمة التزاماً تاماً إلى درجة يرفض معها حتى الشكل الخارجي لهذه الحضارة الجديدة.
إن الكثيرين ينظرون للديك كرمز للجهل والتخلف، لكننا حين نتأمل الأمر جيداً، ونتأمل قناعات هؤلاء الناس، لا نجد أنهم يختلفون كثيراً عن الديك، إن الفارق يكمن في درجة الالتزام فحسب. إنهم يزعمون أنهم يقبلون الحضارة الجديدة، ولكنهم في دواخلهم يرفضون كل ما هو صميم في هذه الحضارة، ويتعاملون معه بعداء، بل وبلا أدنى رغبة في الفهم. ولكن وبما أنهم انفتاحيون - ويا لهذا الانفتاح - فإنهم يقبلون قشور هذه الحضارة وشكلها الخارجي، أما ما وراء ذلك من فكر، وثقافة، وعلوم، فإنهم أمامه - في الواقع - ليسوا سوى أقل من ديكة.
عرض وتأمل:
حاولت أن أجعل الأسطر السابقة مدخلاً للحديث عن الالتزام الذي يدعو سارتر في هذا الكتاب إلى جانب منه، وهو الالتزام في الأدب، لكن أي التزام هذا الذي يدعو إليه سارتر؟ وما معناه؟ وما هي حدوده؟ وفي أي الفنون؟ هذا ما يحاول سارتر في جانب من هذا الكتاب أن يبينه منطلقاً من موقف أولئك الذين يهاجمونه بسبب هذه الدعوة.
أولئك الذين يقول عنهم إنهم "يقرؤون مسرعين دون أن يتدبروا، ويحكمون قبل أن يتثبتوا. ص8".
إنه يدعوهم ما داموا يدينونه باسم الأدب إلى الاتفاق أولاً حول الأدب نفسه أو بالتحديد حول الكتابة.
ما معناها؟ لماذا نكتب؟ ولمن؟
إن ما يحاوله سارتر في هذا الكتاب ليس سوى الإجابة على هذه الأسئلة، أما ما سأقف عنده في هذه الصفحات فهو إجابته على السؤال الأول: ما الكتابة أو ما معنى الكتابة. هذه الإجابة التي تمثل الفصل الأول في هذا الكتاب، فما الكتابة حقاً؟ وكيف يراها سارتر؟ وكيف يميز سارتر بين نوعيها الكبيرين: الشعر والنثر، ذلك التمييز الصارخ الذي يدعو للدهشة؟!
يدخل سارتر للحديث في هذا الفصل من باب الالتزام في الفن بعامة. فيعلن أنه لا يدعو إلى الالتزام في كل الفنون (كلا لا نريد للرسم ولا للنحت والموسيقى أن تكون ملتزمة ص9) لأنه يعي أن الفنون ليست متساوية. إنها مختلفة ليس في الشكل فحسب، إنه اختلاف في المادة أيضاً "فعمل أساسه الألوان أو الأصوات غير عمل آخر مادته الكلمات ص10".
إن الصوت أو اللون مواد لا تملك قدرة الكلمات في الدلالة على شيء آخر خارجها، إنها تدعوك للوقوف عندها وليس إلى تجاوزها.. إنها ترفض أن تكون مجرد جسر للعبور.
والفنان الحقيقي لا ينظر إلى الأشياء كرموز، إنه ينظر إليها في ذاتها "إن الفنان يعد اللون وطاقة الزهر ورنين الملعقة في الصحون أشياء في ذاتها وفي أعلى درجات وجودها... يتأمل في صفات اللون أو الشكل، ويطيل فيها التأمل مبهوراً بجمالها، إنه أبعد ما يكون عن عد الألوان والأصوات لغة من اللغات ص11" ولذلك فحين جاءت ذات مرة فتاة مزهوة إلى أحد الرسامين الكبار لتقول له إنها استطاعت أن تفهم كل المعاني التي كان يرمز إليها في لوحاته أجابها ساخراً:
- حقاً؟ أرجو أن تخبريني بهذه المعاني فأنا نفسي لا أعرفها.
أما المفتش كولمبو فحين وقف في إحدى حلقات ذلك البرنامج التلفزيوني الدرامي الشهير أمام إحدى اللوحات في معرض تشكيلي وطلب من مسؤولة العرض أن تشرح له ماذا يريد أن يقول الفنان في هذه اللوحة، فقد أجابته الإجابة الوحيدة الممكنة: نحن هنا يا سيدي لا نشرح لأحد. إما أن تروقك اللوحة أو لا تروقك. هذا كل ما في الأمر.
إن هذه السذاجة التي نمارسها في عد الأشياء والأعمال الفنية مجرد رموز وكأنها بذاتها لا تمثل شيئاً، لمما يدعو للأسى، وهو ما أصبت به ذات مرة حين عاد أحد أصدقائي بعد يومين من إعارتي له رواية (موسم الهجرة إلى الشمال) ليقول لي كل ما خرج به من هذه الرواية وهو أن مصطفى سعيد يرمز لإفريقيا، وبدأ حديثاً طويلاً عن إفريقيا والاستعمار والامبريالية و.. و.. إلخ.وتساءلت حينها: هل هذا كل شيء؟! ألا يستطيع كاتب من الدرجة الثانية أن يكتب مثل هذا الكلام في زاوية ما في جريدة لا يقرؤها سوى محرريها؟ فلماذا يشقي الطيب صالح نفسه بكتابة هذه الرواية؟!
ألا تستحق تلك الأجواء السحرية التي تشيع في الرواية التوقف عندها؟ أليس هناك أشياء أخرى كثيرة يمكن التوقف عندها في هذه الرواية؟!
أليست هذه الأشياء وهذه الأجواء هي ما يعطي هذه الرواية قيمتها. وإذن .. وإذا كانت المعاني كما يقول سارتر "لا ترسم ولا توضع في ألحان ص3" وإذا كان لا أحد يجرؤ "أن يتطلب من الرسم والموسيقى أن يكونا التزاميين ص13" فماذا عن الكتابة وماذا عن الكاتب؟ إن الكاتب عند سارتر على النقيض من الرسام أو الموسيقي "فعمله إنما هو الإعراب عن المعاني ص13" وهو إنما يستخدم الكلمات لهذه الغاية.
لكن الكاتب عنده نوعان فهو إما أن يكون شاعراً وإما أن يكون ناثراً. وهنا يفرق سارتر بين الشاعر والناثر، والشعر والنثر، ويقف منهما موقفين متباينين. فالشعر "يعد من باب الرسم والنحت والموسيقى. ص13".
فهو لا يمكن أن يكون التزامياً. أما النثر فهو الميدان الحقيقي للالتزام.
يرى سارتر أن الشعر كالنثر كلاهما يستخدم الكلمات لكن الشعر يستخدمها بطريقة مختلفة. إنه في الواقع يخدم الكلمات أكثر من كونه يستخدمها، وإن الشاعر يتعامل مع مادته (اللغة) بشكل مختلف فهو يتجاوز وظيفتها الإيصالية أو النفعية ولا تعود عنده مجرد أداة بل تصبح عالماً قائماً بذاته.
وليس هدف الشاعر "استطلاع الحقائق أو عرضها ص14" ولا "الدلالة على العالم وما فيه ص14" وهو بالتالي لا يهدف إلى تسمية المعاني بالألفاظ "لأن التسمية تتطلب تضحية تامة بالاسم في سبيل المسمى ص14".
وهو ما لا يمكن أن يقبله الشاعر، لأنه يتعامل مع الكلمة على أنها شيء بحد ذاته وليس مجرد رمز لشيء آخر أو لمعنى ما.
إننا في حياتنا اليومية لا نتوقف عند الكلمات ولا نشعر بها لأنها مجرد ناقل أو موصل إلى شيء آخر. أما الشاعر فليس المعنى عنده إلا صفة واحدة من صفات الكلمة لا يزيد أهمية عن صفاتها الأخرى التي منها:
شكل الكلمة وصوتها والإيحاءات التي يمكن أن تبعثها في النفوس، طول الكلمة وقصرها، العلاقات التي تنشأ بينها وبين الكلمات الأخرى والتي قد تكون علاقات صوتية إيقاعية (سجع، جناس، توازن) أو قد تكون علاقات معنوية (طباق، ترادف).
بل إن المعنى ذاته يتأثر في النهاية بالمظهر المادي للكلمة.
لكل ذلك كان من المستحيل لكلمة أن تحل محل كلمة أخرى في الشعر،& أما إذا أمكن ذلك فإننا نكون ببساطة حيال اللاشعر، إن الجمل في الشعر تعبر عن شحن وانفعالات نفسية ولذلك فإنه "في الأعم الأغلب تسبق إلى ذهن الشاعر هيئة الجملة ثم تتبعها الكلمات ص17".
إن اللغة في الشعر تمتاز بشدة التكثيف والإيجاز ولذلك ولكل ما ذكرناه كان من طبيعة الشعر الغموض. ولربما كان هذا الغموض هو حيلة الشاعر غير الواعية - وربما الواعية أحياناً - لجعل المتلقي يتوقف أمام صنيعه بالكلمات، ويتأمل ما يقوم به الشاعر من إبداع وما يُنشئه من علاقات وروابط جديدة بين الكلمات وما يبتكر من صور خيالية إلى غير ذلك من طرق الإبداع عند الشاعر.
إن جانباً واحداً من جوانب هذه اللغة يمكن أن يتعدد ويتنوع، ويختلف الإحساس به من شخص إلى آخر.
إن الكلمة المفردة يمكن أن تحيل المتلقي إلى الكثير من المعاني والأحاسيس، وربما أحالت متلقياً آخر إلى معان أخرى.
وسأقوم الآن بتجربة بسيطة أختار فيها أول كلمة تخطر في ذهني وأرى ما المعاني التي يمكن أن تخطر لي لو سمعت هذه الكلمة في نص شعري - وأقول في نص شعري لاختلاف طبيعة التلقي الشعري عن طبيعة الاستقبال البسيطة في الكلام اليومي.
لقد خطرت في ذهني الآن كلمة (كلب) ولأنظر الآن ما المعاني والمشاعر التي يمكن أن تثيرها في نفسي هذه الكلمة:
أولاً: هناك صور متعددة لكثير من الكلاب التي رأيتها في حياتي، أو صور لمواقف كثيرة يمثل كلب ما أحد عناصرها. وثانياً الصوت (النباح) الذي تصدره الكلاب وقد أسمعه في أذني، وثالثاً فكرة الوفاء ورابعاً فكرة الرغبة في إهانة شخص ما حين يوصف بهذه الكلمة، وخامساً المرض المخيف الذي يسببه بعضها (الكَلَب)، وسادساً صور متعددة لكثير من المطاردات التي استغلت فيها الكلاب خوفي منها مصحوباً بالظلام، وسابعاً تلك الصورة المحزنة والمخيفة التي رأيتها في (الأندر قراوند) في لندن لشابة كانت تسير وتصدر نباحاً مخيفاً، والحقيقة أنني ظننت في البداية أن الصوت لكلب حقيقي مما جعلني أستغرب ذلك وحين التفتنا خلفنا أنا وزوجتي لرؤية مصدر الصوت رأينا تلك الشابة وهي تسير وتنبح، أما أطرافنا فقد تجمدت للحظات وخاصة حين مرت بجانبنا حيث كنا ننتظر أن تهجم علينا في أية لحظة، وثامناً ذلك التصرف الأرعن والمضحك للكلاب في مطاردة الأشخاص حين يسيرون ثم توقفها إذا ما توقفوا وهربها إذا ما رجعوا إليها (والواقع أن هذا التصرف يذكرني بكثير من النماذج البشرية، بل ربما كانت الكلاب قد استعارته منا نحن البشر).
إن الكثير من الكلمات سيكون شأنها شأن كلمة (كلب) فهي توحي بالكثير من المعاني والمشاعر والصفات.
وأتساءل هنا عن ذلك الشاعر العربي السيئ الحظ الذي جوبه بضحكات المستمعين والقراء حين قال بيته:
بل لو رأتني أخت جيراننا
إذ أنا في الدار كأني حمار
هل كان ضحية لظلمنا نحن المتلقين الأشقياء؟ هل كان معذوراً لأنه أُخذ بهيئة الحمار وتماسكه ومتانته، وأراد من أخت الجيران أن تراه بهذه القوة والمتانة لتقع في غرامه وتبادله حباً بحب؟ أم أنه كان شاعراً غبياً لأنه أخذ حقيقة واحدة للحمار وغفل عن بقية الصفات أو المعاني التي يمكن أن تخطر للمتلقي فاستحق بذلك سخريته وضحكاته؟
وإذن .. وإذا كان سارتر ينظر للشعر هذه النظرة المتقدمة حقاً ويجعله بعيداً أو غير مطالب بالالتزام فكيف ينظر للنثر.
يرى سارتر أن الشاعر إذا كان قد حُرم الالتزام في شعره فإن الناثر مطالب به. ويرى أن التشابه بين الشاعر والناثر لا يوجد إلا "في حركة اليد ورسم الحروف ص20" وأن النثر في "جوهره نفعي ص20"، أما الناثر فهو "الذي يستخدم الكلمات ص20" ثم تبدأ الغرابة حين يعطي أمثلة للنثر "فقد كان السيد (جوردين) ناثراً حين طلب حذاءه وكذا (هتلر) حين أعلن الحرب على بولونيا ص20".
والكاتب متكلم فهو "يحدد ويبرهن ويأمر ويرفض ويستجوب... إلخ ص20".
فالكلمات عنده "ليست بأشياء بل هي ذات دلالة على الأشياء ص20" فليس المهم "معرفة ما إذا كانت الكلمة تروق أو لا تروق في ذاتها، ولكن معرفة ما إذا كانت تدل دلالة صحيحة أو واضحة على بعض الأشياء أو على بعض المبادئ ص20".
ومن الواضح هنا أن سارتر في حديثه عن النثر لا يفرق بين مستوياته المختلفة فلا يفرق بين الكلام اليومي والكلام العلمي والمقالة السياسية والنثر الأدبي.. إلخ.
وكلنا يعرف قلق الكاتب الأدبي أمام الكلمات وبحثه عن الكلمة التي توصل أكبر شحنة نفسية ممكنة، والكم الهائل من الأوراق التي يمزقها ليعيد كتابتها من جديد أو المفردات التي يشطبها باحثاً لها عن بديل، إن هذا يدل على أن الفكرة عند الكاتب وهو يكتب ليست بذلك الوضوح الذي يراه سارتر، إنها تزداد وضوحاً وتجسداً كلما مضى الكاتب في كتابته، بل إنه كثيراً ما يجد الكاتب نفسه يكتب أشياء تختلف عمّا كان يهجس به ذهنه في البداية، والكاتب والفنان الحقيقي لا يمزق هذه الأوراق لأنها لا تتفق مع فكرته الأساس بل إنه يحتفي بها ويمضي معها حتى النهاية، لأنه يعلم أن الكتابة هي التي تكتبنا وليس العكس، وأن ما يستقر في لاوعينا يفوق في غناه وتنوعه أضعاف ما نعيه، وأن رغباتنا الحقيقية والصادقة تستقر هناك، وأن الأدب والإبداع الحقيقي هو ما عبَّر عمّا يستقر في هذه المناطق الدفينة.
إنني وأنا أمسك بالقلم الآن وأكتب لأقول أشياء لم أكن أفكر بها أو تخطر لي ببال قبل لحظات.
ولكن إذا كان مثال النثر عند سارتر هو (جوردين يطلب حذاءه) فليس غريباً أن يطلب من الناثر أن يكون ملتزماً.
وسارتر يرى أن من حقنا أن نطلب من الناثر "ما غايتك من الكتابة؟ وفي أي مشروع تريد أن تطلق لنفسك العنان في القول؟ ولم يضطرك ذلك المشروع للجوء إلى الكتابة ص20" نعم من حقنا ذلك إذا كان الناثر متقدماً لكتابة رسالة علمية. أما الكاتب الأدبي الذي يريد أن يكتب قصة أو رواية فلا أعتقد أن من حقنا أن نسأله مثل هذا السؤال. إن العمل الأدبي ليس مجرد فكرة، إنه مجموعة من العناصر التي تنتظم لتنتج لنا عملاً إبداعياً متكاملاً ليست الفكرة إلا جزءاً يسيراً منه. وفي النهاية فإن الفكرة تهدف إلى المعرفة أما العمل الأدبي فيهدف إلى خلق المتعة، وتحريك الأحاسيس والمشاعر. وسارتر لا يتوقف عند ذلك السؤال الذي يوجهه للناثر فهو يؤكد أنه "مهما يكن من شيء فلن تكون غاية ذلك المشروع هي التأمل البحت، إذ التأمل والنظر العقلي ميدانهما الصمت، على حين غاية اللغة الاتصال بالآخرين والإفضاء. حقاً قد يقصد إنسان ما إلى تسجيل نتائج تأملات لنفسه ولكن حسبه - والحالة هذه - بضع كلمات يرمي بها على الصفحة في غير أناة، وستكفيه هذه الكلمات ليتعرف بها على ما مر في خاطره ص21".
ولكن هل صحيح هذا الكلام؟
إن الأدب في معظمه ليس إلا تأملات في الكون والحياة والأفكار، يشرك فيها الكاتب الآخرين معه. وهل يجب أن تكون تأملات الكاتب لنفسه وبعيدة عن أن تعرض للناس؟ أليس من حق القارىء أن يتأمل (تأملات) مفكر كبير كسارتر نفسه أو روائي عظيم كميلان كونديرا مثلاً؟!
بل إن الفكر نفسه ليس إلا تأملات والفكرة ليست إلا نتيجة لتأمل فكرة أخرى أو موقف أو طبيعة ما.
إن ما يقوله سارتر - كما يبدو لي - يرتبط أساساً بفكرة القيمة أي هل يكتب الكاتب ليقول شيئاً ذا قيمة. ومن المؤكد أن هذا الكلام سيكون له (قيمة) إذا كان للقيمة نفسها مفهوم محدد.
إن القيمة كغيرها من المفاهيم كالحقيقة، والصدق، والخير، والجمال، تفقد بريقها ووضوحها أمام التأمل الفلسفي وتصبح مفاهيم غير محددة، وتفقد قدرتها في الدلالة على مدلول ثابت أو مستقر. إن سارتر يريد من الكاتب في مشروعه الأدبي أن يكتب ليكشف "عن الموقف قاصداً كل القصد إلى تغييره ص22" إن من الواضح أنه يريد منه لكي يكون موجوداً أن يكون فاعلاً.
وهو يريد منه أيضاً أن يكون بطلاً وداعياً إلى الإصلاح والتغيير و"أن يربأ بنفسه عن أن يلعب دوراً سلبياً مسفاً بعرضه مساوئه ووجوه شقائه ومظاهر ضعفه ص37".
وأن "عليه أن يتمثل إرادة حازمة تشق طريقها إلى النجاح عن قصد ص37". ولكن أليست (وجوه الشقاء ومظاهر الضعف) هي أصدق المواقف في التعبير عن إنسانية الإنسان؟ إن إنسانية الإنسان تتبدى بضعفه أولاً قبل قوته. وإذا كان سارتر يطلب من الكاتب أن يتخلى عن عرض مساوئه ووجوه شقائه ومظاهر ضعفه فإنه يريد أن يحرمنا من أصدق وأنبل ما يمكن أن يكتبه كاتب.
ثم هل يكتب الكاتب فقط من أجل التغيير؟ أليس في الحياة أشياء كثيرة تستحق الكتابة عنها؟ أليس هناك تفاصيل إنسانية مغرقة في البساطة تستحق التوقف عندها والكتابة عنها؟ ألا تحفل الحياة بالكثير من المفارقات والآلام؟ ألا يحق للكاتب أن يكتب مصوراً هذه المفارقات أو معبراً عن هذه الآلام؟!
ألا يكتب أحياناً مشيّعاً لقيم بدأت في الزوال لكن الدعوة إليها في الوقت نفسه تعد ضرباً من الجنون؟!
ثم لنفرض أن كاتباً كتب عن موقف ما كاشفاً إياه قاصداً إلى تغييره، ثم حدث هذا التغيير، أليس من حق الكاتب عندها أن يكتب معبراً عن سعادته بهذا التغيير، وإذا كتب معبراً عن سعادته بهذا التغيير فأي تغيير سيدعو إليه مجدداً.
إن ما يريده سارتر هو أن يجعل من الكاتب (ديكاً) عاجزاً عن التحليق والطيران، أما الشاعر فإنه عنده طائر حر له أن يحلق إلى أي أفق يشاء.
&ما الكتابة: يمثل الفصل الأول من كتاب (ما الأدب) لجان بول سارتر
ترجمة: الدكتور محمد غنيمي هلال




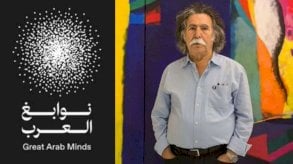







التعليقات