هل يمكن الدفاع عن شريحة من السلمين تحاول أن تعيد أو تفلتر أو حتى تقطع علاقتها بتاريخ الدين؟ حيث هي في الواقع لم تقطع علاقتها بالله أو بالوحي ولا بعقائدها الإيمانية والمعنوية، وإنما أرادت أن تضع حدا لعلاقتها التقليدية والمادية المصلحية بالتاريخ الديني، فهي رفضت قبول التبعية للتاريخ وعارضت الخضوع للماضي الاجتماعي الديني الساعي إلى أن يصبح أساسا لحياتها في الحاضر وأبت منهج التقليد، تقليد الإمام والفقيه غير المنتمي للواقع الراهن ولأسس الحياة الجديدة.
لا يمكن بناء تلك العلاقة والدفاع عن تلك الشريحة إلا بطرح نهج للتدين يستمد أسسه من أصل رئيسي بعثت من أجله الأديان ومن ضمنها الدين الإسلامي، وهذا الأصل هو ما ينتج الإيمان الطبيعي المتحرر من الزوائد التي أدخلت عليه غصبا عبر التاريخ، الإيمان الهادف إلى بناء علاقة فطرية مع الله، لا الإيمان الفقهي الساعي قبل أي شيء إلى استغلال الظروف والمصالح في الدنيا لتثبيت هوية المسلم الدينية وإلى إلغاء الآخر الرافض لهويته، وهو ما نرى انعكاساته في صراع الهوية المرتبط بالمصالح الدنيوية، ومن ضمنها السلطوية، في المجتمعات الإسلامية، ومنها في المجتمع الكويتي، بين جماعات التشدد السني والتشدد الشيعي، أو كما يسميه البعض بين السلفية السنية والسلفية الشيعية، وهو صراع تافه وسطحي ومستند إلى قضايا وأحداث سياسية تاريخية دينية، وباتت نتائجه مؤثرة بشكل سلبي على أصل الدين أي الإيمان، وتهدد بتفكك المجتمع وبدأت تؤثر سلبا على المصالح الوطنية، فأصبحنا نشاهد كيف أن الدفاع عن تلك القضايا والأحداث التاريخية - وليس عن نهج التديّن - يحظى بأولوية عند تلك الجماعات ولو أدى ذلك إلى زعزعة الأمن والسلم الاجتماعين.
فهل يمكن - مثلا - وصف الدفاع السني السلفي أو الهجوم الشيعي السلفي على صحابة نبي الإسلام بأنه أصل من أصول الدين وأحد أركانه، أم أن ذلك يعكس فحسب ما جرى من صراع تاريخي اجتماعي وسلطوي وكان يجب ألاّ يقحم الدين فيه، مثلما يحصل الآن؟ فلا همّ لمعظم المنتمين إلى ضفتي السنة والشيعة إلا الدفاع أو الهجوم على القضايا التي تحفظ هويتهم الدينية التاريخية ولو أدى بهم الأمر إلى استخدامهم أساليب غير أخلاقية نهى الدين والعقل عن استخدامها.
هل هذا الدفاع أو الهجوم يصب في مصلحة المجتمع والوطن، أم إن السلفيين والمتشددين في الجهتين غير مبالين إلا بتلك الأحداث التي لا تعكس سوى مسألة الهوية لكل طرف، فيما مصلحة الوطن وأمن المجتمع يأتيان في مرحلة متأخرة من اهتماماتهم؟
فإذا ما واصلت المدرسة الفقهية التقليدية، لدى السنة والشيعة، والتي تتبنى نشر منهج الهوية الدينية وتعتبره أحد مهامها الرئيسية في الحياة، في الظهور على هذه الشاكلة من دون السعي إلى إعادة إحياء نهج التدين المعبّر عن العلاقة الفطرية بين الإنسان وبين باريه ورفض الزوائد التي أدخلت على الدين عبر التاريخ، فإن أكثر المتضررين من ذلك هو الدين نفسه ثم المواطن وأمن الوطن وسلامة المجتمع المحلي.
إن التديّن المصلحي والمادي المستند إلى الهوية الدينية يعبر في أبرز تجلياته عن الطائفية البغيضة، إذ لا هم لأصحاب هذا النوع من التديّن إلا الإستناد إلى التاريخ للدفاع عن وجودهم وهويتهم والسعي لإلغاء الهويات الدينية المذهبية المنافسة التي عادة ما يسمى أصحابها بالخوارج الجدد أو المرتدين الجدد، فيما قضية الإيمان والعلاقة الفطرية مع الله تأتي في مرحلة لاحقة، بل قد لا تأتي، إذ يكفي لهؤلاء دفاعهم عن هويتهم الدينية، وهو دفاع يجلب لهم quot;الحسناتquot; للحصول على ضمانات تعينهم على مسألة الحساب في يوم الآخرة، حيث هنا تتحول العلاقة الإيمانية مع الله من علاقة فطرية قلبية معنوية، إلى علاقة مادية ومصلحية صرفة، ومن صور تحقيقها التأكيد على الطائفية وعلى التمسك بالخزعبلات والخرافات بهدف تقوية الوجود والهوية!!
فليس مهماً لدى هؤلاء المتمصلحين من الدين السعي لتهيئة ظروف اجتماعية ونفسية تجعل الإنسان قادرا على بناء علاقة إيمانية ومعنوية مميزة، ليس فقط لأصحاب الدين الإسلامي وإنما لجميع الأديان، بل ما هو مهم بالنسبة إليهم في الدرجة الأولى هو التأكيد، من خلال استغلال المساجد والحسينيات وغيرها من الوسائل الدينية والاجتماعية، على الهوية الدينية التي تؤدي إلى حصولهم على quot;حسناتquot; بطرق متعددة ومنها الطرق غير الأخلاقية، كالسب والشتم والغيبة والنميمة وحتى القتل والإلغاء، حيث نشاهد أمثلة متعددة على ذلك في مختلف المجتمعات العربية والإسلامية، وأبرزها تلك التي تتجلى شواهدها في العراق اليوم من إلغاء أنصار المذهبين السني والشيعي لبعضهم البعض، ومن تمادي الطرفين على الموت في سبيل الدفاع عن الهوية الدينية ولو أدى الأمر إلى انهيار الوطن والمجتمع وإبادة الأسر وتحول الإنسان إلى قاتل بالمطلق من دون أي رحمة، بل وإلى تضعضع موقع الدين نفسه، إذ سيطغى على الدين طابع العنف لأن مهامه ستكون منصبة على تأكيد قضايا الهوية والمصلحة، في حين كان على أصحابه أن يهيئوا الأجواء للحريات، الدينية وغير الدينية، لحماية موضوع الإيمان لكن للأسف فإن ما يحصل على أرض الواقع هو عكس ذلك تماما.
إن بناء علاقة إيمانية ومعنوية متميزة في المجتمع تحتاج إلى نشر فهم للدين تصب مخرجاته في هذا الإطار، فهم يخدم الجانب القيمي والمعنوي والأخلاقي للإنسان، في حين أن ما نراه ونتلمسه من تصرفات وسلوكيات أنصار المدرسة الفقهية التقليدية وأتباع التأكيد على الهوية الدينية هو عكس ذلك تماما. فالخوض في المسائل الروحية المعنوية بعيدا عن تداخلها بالمسائل السياسية والاجتماعية والمصلحية من شأنه ألا يهدد الإيمان الفطري بأي شائبة مادية ظاهرية تعرقل طريقه ومسيره.
- آخر تحديث :






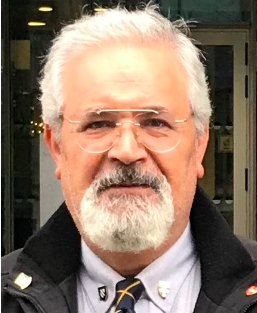














التعليقات