&
&&كرم سعيد& 
&
تنتظر تونس انتخابات تشريعية ورئاسية في 26 تشرين الأول (أكتوبر) و23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين على التوالي. الانتخابات نهاية الانتقال الديموقراطي الذي بدأ عقب ثورة تشرين الأول 2010، والإطاحة بحكم زين العابدين بن علي، وهي الأولى بعد إقرار دستور البلاد مطلع العام الجاري، وما تضمنه من تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لمصلحة البرلمان والحكومة. وتتزامن الإنتخابات مع تصاعد وتيرة الإرهاب بعد اغتيال معارضين بارزين مثل شكري بلعيد والنائب عن حزب التيار الشعبي محمد البراهمي، ووصول العنف الذروة في نهاية تموز (يوليو) الماضي باستهداف المؤسسات الأمنية وعدد من المنشآت العسكرية في جبل الشعانبي.
وتشهد الانتخابات حضوراً لا تخطئه عين لجماعة «أنصار الشريعة» السلفية وأبناء عمومتها في المشهد السياسي التونسي، لاسيما أنها استفادت من غض طرف حركة النهضة تجاه التيار السلفي في محاولتها تشويه صورة التيارات المدنية.
ويتزامن الاستحقاق مع تراجع زخم حركة النهضة، بعد العجز عن تسكين أوجاع الأزمات التونسية في إطار حكومة الترويكا التي كانت عمودها الفقري.
وتشهد البيئة الانتخابية في تونس إلى جانب عناصرها التقليدية عناصر جديدة يرشح أن تلقي بظلالها على الاقتراع، أولها تكاثر المنافسين على قصر قرطاج حيث أعلن أكثر من 30 شخصية سياسية وحقوقية العزم على الترشح. وعلى رغم تدني موقعه دستورياً إلا أن وزن المركز الرئاسي في الوعي الجمعي للتونسيين يتجاوز الصلاحيات المنصوص عليها دستورياً، ناهيك عن أن سكن قرطاج بعيداً عن وجاهته الاجتماعية هو حلم الراغبين في الانتقام من نظام بن علي.
والأرجح أن كثرة المرشحين قد تساهم في تشتيت أصوات الهيئة الناخبة، وبالتالي استحالة تحقيق فوز حاسم، ومن ثم يصبح الرئيس الفائز في حاجة إلى شرعية أقوى تمنع عودة الاستبداد من جهة، ومن جهة ثانية تضمن له ممارسة اختصاصاته من دون ضغط.
ويلاحظ حياد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية واقتصار دورها على تأمين العملية الانتخابية. واستعادت المؤسسة العسكرية في تونس حضورها على الساحة السياسية عقب رحيل بن علي، باعتبارها الضامن للسلم الأهلي ووجود الدولة. وأصبح الجيش أحد أهم عوامل الاستقرار وحفظ التوازن بين المتناقضات الفكرية والسياسية، وتأكد هذا الدور بإعلان وزير الدفاع التونسي غازي البحريني حياد المؤسسة العسكرية وعدم تدخلها في الشأن السياسي.
وثمة تضييق لافت على مؤسسات المجتمع المدني، إذ جمدت حكومة مهدي جمعة نشاط أكثر من 157 جمعية كإجراء تحفظي و»لدواع أمنية» قبل العملية الانتخابية، للاشتباه في تلقيها تمويلات مشبوهة وبعلاقتها بالإرهابيين، كما تم غلق مؤسسات إعلامية بدعوى تحريضها على العنف والخطاب المتشدد والتكفيري. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» انتقدت خطوة الحكومة هذه لتعارضها مع مرسوم تبنته الحكومة الانتقالية في 2011 يخول للسلطة القضائية وحدها حل أو تعليق نشاط الجمعيات.
القراءة الدقيقة للواقع التونسي تشير إلى أن هناك شيئاً يتحرك ويكبر مع الانفلات الأمني وتنامى الجماعات الراديكالية، الأمر الذي ربما ينعكس سلباً على موقع حركة النهضة السياسي، باعتبارها أول من منح صكاً قانونياً لوجود التيار السلفي الجهادي، وغضت الطرف عن تورطه في أعمال عنف قبل أن تتراجع وتعلن أن «أنصار الشريعة» جماعة إرهابية.
وكان رئيس الحكومة التونسية الموقتة المهدي جمعة، اعترف في أذار (مارس) الماضي بأن الخطر الأكبر الذي يتهدد تونس يتمثل في تنامي تيارات العنف الأصولي، وعودة الجهاديين من سورية. وأكدت وزارة الداخلية عودة نحو 400 جهادي من سورية، ومنع أكثر من 8 آلاف آخرين من التوجه إليها في 2013.
ويشكل تباطؤ معدلات النمو، وفشل نخب حركة النهضة الإسلامية في التجاوب مع تطلعات المواطنين، عامل ضغط على حركة النهضة وحلفائها، ما دفعها إلى التخلي عن مقاعد الحكم، وربما يفقدها قطاعاً معتبراً من المقاعد التي حازتها في المجلس التأسيسي والمقدرة بـ 89 مقعداً.
وجاء تراجع حركة النهضة في ظل ضغوط الداخل، والانتباه إلى ما حدث في مصر لجماعة الإخوان عقب إطاحة الرئيس السابق مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013. وكان بارزاً، هنا، تصريح راشد الغنوشي، الأب الروحي للحركة، والذي قال فيه «إذا خسرنا السلطة فإننا سنعود إليها، ولكن إذا خسرنا أمن تونس واستقرارها فستكون خسارة للجميع». وفي إطار تراجع حركة النهضة في صراعها مع القوى المدنية التونسية، تم سحب قانون «تحصين الثورة» الذي يمنع المنتمين إلى حزب الرئيس السابق بن علي من ممارسة الحياة السياسية، فضلاً عن مصادقة النهضة على الفصول الخلافية في الدستور، وفي مقدمها الفصل السادس الذي أثار جدلاً حول مسألة «تجريم التكفير»، وأصبح هذا الفصل في صيغته الجديدة كما يلي: «الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية. تلتزم الدولة بحماية المقدسات ومنع النيل منها ومنع الدعوات التكفيرية والتصدي لها».
قد لا تسمح البيئة الانتخابية الراهنة والتي يحكمها الاستقطاب، إلى نفاذ «النهضة» من دون شريك إلى صدارة المشهد الانتخابي، خصوصاً أنها حصلت في انتخابات 2011 على مليون و250 ألف صوت من إجمالي 7 ملايين و569 ألف صوت لهم حق الاقتراع، وهي نسبة محدودة إذا ما قورنت بإجمالي عدد سكان تونس البالغ أكثر من 10 ملايين نسمة.
لذلك فإن جهود النهضة للالتفاف على أزمتها السياسية والشعبية قد تكون نتائجها محدودة في السباق الانتخابي المقبل.
في المقابل لا تبدو الأحزاب المدنية في حال أفضل بعدما عجزت عن التلاقي والتنسيق، ناهيك عن غياب الاحتكاك مع هموم المواطن، والإصرار على إعلاء البنية الفوقية المتعلقة بالأيديولوجيا ونسق القيم التي لا تجد بطبيعتها رواجاً كافياً عند القطاعات الأوسع من الناخبين بسبب تدني الوعي الشعبي، وانشغال الجانب الأكبر من الهيئة الناخبة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس في شكل مباشر وآني على حياتها.
صحيح أن القوى المدنية نجحت في كسب جولة مهمة في إطار مسعاها لتقزيم ومحاصرة التيار الإسلامي، حين أرغمت «النهضة» على مغادرة قصر القصبة، مقر الوزير الأول، إلا أنها لم تفلح في القفز على أزماتها بشأن التواصل مع القطاعات الشعبية الأوسع.
لذلك تبدو وضعية التيار المدني شائكة، ما بين زخم في المدن وأوساط النخب الثقافية والسياسية، وغياب لا تخطئه عين في الريف والفقراء والطبقة الوسطى التي تراهن على القوى الإسلامية في الوصول إلى صدارة المشهد بعد عقود من التهميش والتراجع عاشته زمن بن علي والقوى العلمانية الداعمة له.
ومع اقتراب موعد الاستحقاق التشريعي والرئاسي تقف القوى السياسية التونسية بشقيها الإسلامي والعلماني في مفترق طرق.
وربما تسفر الانتخابات عن استمرار حركة النهضة في المشهد من دون أن تكون في الصدارة، بالنظر إلى تواري الأحزاب السلفية، الداعم الرئيسي للنهضة، عن المشهد الانتخابي، ونأي الحركة نفسها عن الجماعات السلفية المتشددة عقب سلسلة من أحداث العنف، ناهيك عن أن الحزبين اللذين يشاركان «النهضة» في الترويكا الحاكمة تصدعا من الداخل. أما القوى المدنية، خصوصاً التيار الشعبي وحركة نداء تونس، فقد تحظى بتمثيل جيد يضمن بقاءها ضمن مكونات السلطة، وبالمشاركة مع حركة «النهضة» التي أعادت صوغ تكتيكاتها السياسية ومواقفها الخارجية، وإعلانها أنها حركة تونسية لا علاقة لها بالتنظيم الدولي للإخوان.
وإذا كانت بورصة التيار المدني تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، فإن حركة النهضة بدورها تبدو قادرة على التعبئة والحشد وإحداث تغييرات جذرية في مسار المشهد السياسي، لذلك فإن خيار الحكومة الائتلافية ربما يكون ممكناً بعد أن دخلت حركة النهضة الاستحقاق الانتخابي منفردة لتترك الباب موارباً أمام التقارب مع حركة «نداء»، وكذلك فعل حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الذي يخوض الاستحقاق بلا تحالفات حزبية، ليبقى منفتحاً على المستقلين، الأقرب الى توجهاته الفكرية.
&






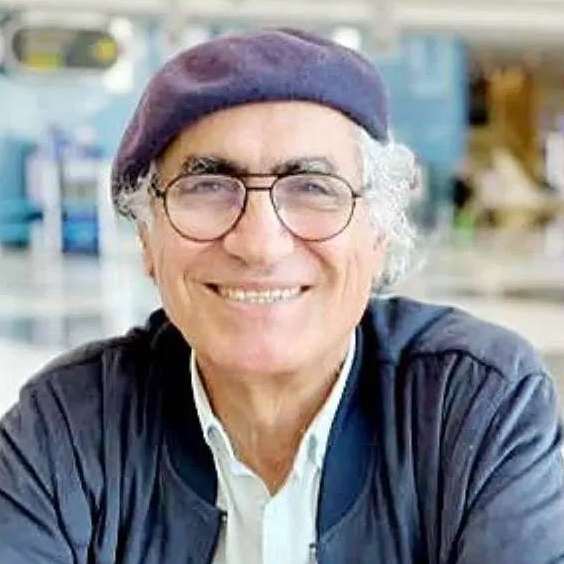










التعليقات