& يسعى الكاتب والمفكر اللبناني د.رضوان السيد في بحثه الجديد الصادر عن سليسلة مراصد بعنوان "رؤية الخلافة وبنية الدولة في الإسلام" إلى قراءة وتحليل الكثير من المقولات التي تستخدمها جماعات وتنظيم إرهابية وتستند فيها إلى القرآن والسنة النبوية وتحاول من خلالها تأسيس ما يسمى الخلافة الإسلامية أو الدولة الإيسلامية على نهج السلف، إذ يرى إن هناك عدة مفردات ترد في القرآن الكريم فهمها المسلمون الأوائل باعتبارها مفاهيم التأسيس لسلطتهم ومشروعيتهم في ظل الرسالة النبوية الجديدة. والمفردات المعنية هنا هي: الإظهار والتمكين، والاستخلاف، والتوريث، والوعد.& ويضيف إن تصور المسلمين الأوائل لسلطتهم، وفتوحاتهم، ومشروعيتها يقوم على أنهم أمة النبي المستخلف على النبوة بعد أن نزعت من بني إسرائيل، والمستخلف في الأرض المنزوعة من الفرس والروم بمقتضى الاستبدال الذي يصيب الظالمين، المرتدين عن دين الله وشرعته ومواريث نبوته. فالله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. وهذا معنى تسمية المسلمين لسلطتهم الأولى بعد وفاة النبي خلافة. فهم، أي المسلمون، خلفاء الله في الأرض ورئيسهم الذي يكلون إليه القيادة في مجال تحقيق المشروع الإلهي الذي نذرهم الله له هو الخليفة. ومع مقولة الإمام علي التي أكد فيها أنه يرى ضرورة للدولة، لا للدين أو إنفاذ حكم الله في الأرض؛ &بل لرعاية الشئون الحياتية للناس؛ أعلن قيام الدولة في عالم الإسلام الأول. لكن مقولة الإمام علي لا تعني أن الدولة بدأت يومها؛ &بل إنها تعني أن الدولة اكتمل معناها باكتمال ظهور المجتمع السياسي. ويوضح د.رضوان السيد أن عمر بن الخطاب قام أيام خلافته الطويلة نسبيًّا (عشر سنوات) بأعمال سياسية كثيرة (غير الفتوحات التي يمكن تفسيرها دينيًّا!) لكن اكتفى هنا بثلاثة أمور لها دلالتها الواضحة. أولها: تلقيبه نفسه بأمير المؤمنين؛ إذ يقال إنه أول من اتخذ هذا اللقب. والإمارة عمل سياسي بالدرجة الأولى. وثانيها: فصله بنفسه أو عن طريق قضاته في الخصومات بين الناس، وتسليم الناس له بذلك. ولا معنى لذلك إلا أن الرعية كانت تعتبره القائم على أمور العدالة، أي أنه يملك حق القهر أو مشروعيته. والقيام على العدالة حق تحتكره السلطة الشرعية (الدولة) بمقتضى تسليم الناس لها بذلك أحبوا أم كرهوا. مع أننا نعلم بيقين أن عمر لم يكن يملك الأجهزة والأدوات الضرورية لإخضاع، وإنفاذ الأحكام؛ لذا فالطاعة له كانت قائمة على الإحساس القوي بمشروعية السلطة التي يمارسها. وثالثها: إنشاؤه ديوان العطاء. ومعنى ذلك إقامة جهاز إداري لاستصفاء الضرائب (الخراج، والجزية، والعشور)، وتوزيعها. وفضلاً عن أن ذلك ليس عملاً دينيًّا؛ فإنه الدليل الأوقع على اتجاه "الدولة" بمعناها المتعارف عليه للاكتمال. وما يقال عن أن الفكرة مأخوذة عن الدول التي كانت قائمة في ذلك العصر لا ينفي أن ذلك الجهاز الإداري من أهم الشواهد على وجود الدولة أيامه، ولو عن طريق استعارة الأجهزة، والنماذج الموجودة في البيئة التاريخية والسياسية آنذاك. ويكشف د.السيد في بحثه عن الظلال، والأغطية الدينية التي يتخذها الصراع السياسي في عالم الإسلام الثقافي، ومجاله السياسي. ويرى أن تلك الأردية من الشفافية؛ بحيث يسهل تمييز خطوطها السياسية، والاجتماعية عن تلك التي تتخذ لحمة دينية، أو عقدية بحتة. هكذا تلبس قضية "شرعية السلطة" أو كيفية الوصول إليها إذن لبوسًا دينيًّا؛ إذ تدور في إطار مصطلحات ثلاثة؛ اثنان منها قرآنيان، والثالث يمكن إرجاعه بالمعنى أيضًا إلى القرآن. وهذه المصطلحات المترادفة هي: الشورى، وأولو الأمر، والجماعة. أما المصطلح الأول فهو قرآني. وقد اشتهر في عصر الصحابة حين أطلق على الستة الذين يقال إن عمر رشحهم وهو على فراش الموت بعدما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي خلال صلاة الفجر، ليختاروا من بينهم واحدًا منهم لإمارة المؤمنين، يبايعه الناس من بعده؛ فسموا "أهل الشورى"، أو "أصحاب الشورى". وبالنسبة لمصطلح "أولو الأمر"؛ فإنه الأمر المعني به السلطة، أي صاحبها، أو مستحقها بطريقة شرعية. وقد استخدم في نقاشات القرن الثاني الهجري في بدايات الصراع بين الفقهاء، والحكام مرادفًا لمصطلح الشورى. ثم صار يطلق في العصور المتأخرة على سلاطين الأمر الواقع من جانب متملقيهم. وسرعان ما حل مصطلح الجماعة محل المصطلحين الأولين فظل في ساحة الصراع السياسي طوال العصور، دون أن يعني ذلك أنه لم يستخدم في عصر "الفتنة"، وطوال القرن الأول. ويتطرق إلى مؤلفات من القرن الخامس الهجري لعدد من الفقهاء لتبيان وجهة نظرهم في المستجدات على المستوي السياسي، وأهم تلك المستندات: ظهور "الدولة السلطانية". أما الفقهاء الذين راقبوا الظاهرة، وكتبوا عنها فهم: الماوردي الشافعي (٤٥۰ه/ ۱۰٥۸م) وأبو يعلي الحنبلي (٤٥۸ه/ ۱۰٦٥م) و الجويني الشافعي (٤۷۸ه/۱۰۸٥م). وقد اختلفت أنظارهم لتلك المستجدات. فقد كان هناك من جهة السلام الذي ساد العلائق مع الخلافة (كسلطة سياسية) منذ النصف الثاني من القرن الثالث. وهو السلام الذي جعلهم ممثلي الدين، وحملة الإسلام في الداخل وإلى العالم. ومع الاعتراف للخلافة بالطاعة والنصرة؛ فإن هؤلاء ما كانوا يرون لها دورًا في الدين، ولا قدسية معينة تفرض بقاءها أو سلطتها. فهي قامت على "الإجماع" المتوارث. وهذا ما رآه أبو يعلي (٤٥۸ه/ ۱۰٦٥م) الحنبلي. والحنابلة آنذاك كانوا ما يزالون يحملون ميراث "محنة خلق القرآن"، وما خلفته لهم من زعامة في العامة، واستقلال في الحياة الدينية والاجتماعية. وقد وقفوا مع الخلافة في محنتها مع البويهيين. أما الماوردي فقد كان أعمق إحساسًا بالمتغيرات، وأكثر اقتناعًا بأنه لا عودة إلى الوراء. ولذا فقد رأى أن احتضان الخلافة ضروري للإبقاء على دولة الإسلام وإن لم يكن الإسلام/ الدين، والإسلام/ المجتمع مهددين. وهكذا أراد إعطاء الخليفة دورًا من جديد في الجماعات، وصلوات الجمعة على سبيل التأدب ولحفظ الهيبة. ولم ير ضررًا في التأكيد الاجتماعي والديني على الخليفة كرمز للاستقرار والاستمرار والوحدة السياسية لدار الإسلام. & & ويوافق الجويني ( ٤۷۸ه/ ۱٩۸٥م) المارودي فيما يتعلق بدولة القوة، وإمارة الاستيلاء، لكنه يختلف معه ويهاجمه بشكل مباشر في مسألتين: الأولى أنه لم يمضِ بالأمر إلى نهايته في نصرة "الدولة السلطانية" هذه. والثانية في حرصه المبالغ فيه على الخلافة. صحيح أن الخلافة ذات لبوس ديني لعراقتها وتاريخيتها وتمثيلها القديم للإجماع المتوارث. لكن "الخلافة" اكتسبت ذلك اللبوس لأمرين اثنين مهمين: حفاظها على وحدة الدار والمجتمع (منع الفتنة الداخلية)، والجهاد (دفاعها عن دار الإسلام). ويضيف "قد لمح المستشرق الألماني tilman nagel في كتاب له عن الجويني وكتابه "غيث الأمم". اتجاهًا من جانب الجويني لعلمنة الدولة والسلطنة. فقد فهم أن الخلافة كانت دولة دينية. لكن الحقيقة أنها لم تكن كذلك حتى في عصورها الأولى. صحيح أن الخلفاء حرصوا على تلقيب أنفسهم بلقب "خليفة الله" منذ أيام عبد الملك بن مروان (٦٥-۸٦ه/ ٦۸٤-۷۰٥م) وربما قبل ذلك. لكن المسلمين عبر العصور ما اعتبروا أن للمنصب قداسة خاصة أو سلطات ذات طابع ديني. ويبدو تحديد الفقهاء للإمامة والخلافة بأنها "حارسة الدين وسائسة الدنيا" موهمًا في هذا المجال. فلم تكن الخلافة هي التي حرست الدين في كل العصور الإسلامية الوسيطة والحديثة؛ بل هو الذي حرسها ودافع عنها بقدر ما رأى أن مصالحه مهددة بتهددها ولو من الناحية الرمزية. لقد كانت مشكلة الدولة في الإسلام الوسيط (والخلافة هي الدولة الأم) أنها ضعيفة الجذور في أصل المشروعية، وأنها لم تستطع التغذي باستمرار من ذلك النبع الثري للشرعية من جهة، وما استطاعت التحول إلى دولة بحد ذاتها من جهة ثانية. وهكذا ظلت الأمة وجماعتها هي المقدس، وهي مناط الاستخلاف، وهي المشروعية التأسيسية والعليا. تهب كل ما عداها مشروعية فرعية بقدر ما ينضوي تحت لوائها. وقد زالت الخلافة منذ أمد وبقيت الأمة وكارزماها (إجماعها، وعدم اجتماعها على الضلالة!). فالأمة في الإسلام هي الشرعية التأسيسية. والشرعيات الفرعية المؤقتة (بما فيها الخلافة التاريخية) شرعيات مصالح ترتبط بتلك المصالح وجودًا وعدمًا. يذكر أن "مراصد" هي سلسلة كراسات علمية محكمة تصدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، وتعنى برصد أهم الظواهر الاجتماعية الجديدة، لا سيما في الاجتماع الديني العربي والإسلامي.& &
- آخر تحديث :







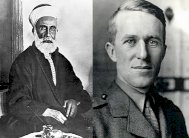





التعليقات