د. شاكر النابلسي
يكاد الشعب العربي أن يكون الشعب الفريد في تاريخ الديمقراطيـة الإنسانية من حيث انه لم يمارس الديمقراطية طيلة خمسـة عشر قرناً إلا في فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاثين عاماً وهي فترة الحكم الراشدي - الذي ذهب ثلاثة من خلفائه قتلاً، وتلك ظاهرة لها دلالة بالغة في علم الاجتماع&- وعلى وجه الخصوص فترة الخلفـاء: أبو بكر وعمر بن الخطـاب، وعلي بن أبي طالب ، والتي لم تتجاوز مدتهـا على وجه التحديد غير سبع عشرة سنة فقط، كانت فيها الشورى بدائية عفوية بحكم زمانها وقُصـر تجربتها. وبذا انتفى مفهوم الديمقراطية أو الشورى بمسمَّاها الإسلامي، وأصبحـت حبراً على ورق في زمن عثمان. وامتد هذا الوضع السياسي منـذ ذلك الحين إلى الآن، قُرابة خمسة عشر قرناً، لم يفز فيها الشعب العربي بفترة حكم واحدة استطاع فيها هذا الشعب أن يقول كلمة حق في سلطان جائر بكل حرية دون خوف أو تعذيب، ودون رقيب أو حسيب. وظلت الشورى أو ما يُسمّى بالديمقراطية الإسلامية في فكر الخوارج وفي فكر المعتزلة شعاراً يرفعونه في وجه السلطة من وقت إلى آخر، علماً بأن شورى المعتزلة كانت منقوصة حيث نادى فريق منهم بشرط النسب القرشي للحـاكم وهو مبدأ& قبلي غير ديمقراطي - في حين أن الخوارج كانت هي الفرقة الإسلامية الوحيـدة التي لم تشترط النسب القرشي في الحاكم. وكانوا يرون أن أي عربي فاضـل يمكن أن يكون حاكماً، كما قال عبد العزيز الدوري (الديمقراطية في فلسفة الحكم العربي، ص72، 73).
ومن هنا، كان الحديث العربي في هذا العصر عن الديمقراطية العربية حديثاً صعباً وقاسياً، كما كان حديثاً مستجداً يُنشئ من جديد، لأنه كان بلا جـذور وبلا أصول ممتدة وقوية. فقد ظل الفكر الفلسفي السياسي في التاريخ العربي هامشياً في دوره. وكأن التاريخ الحقيقي للديمقراطية العربية قد بدأ في هذا العصر فقط. وإن كـان البعض يدّعي أن للديمقراطية العربية أو الشورى الإسلامية جذوراً، فإن هذه الجذور لا تتعـدى أن تكون جذوراً قصيرة ودقيقة، مثلها مثل جذور العشب القصير الرهيف.
إضافة لذلك، فإن الدولة العربية الحالية لا تختلف عن الدولة العربية الإسلامية كما عرفها التاريخ منذ معاوية بن أبي سفيان، والتي كررت نفسهـا، وما زالت تُكرر نفسها إلى اليوم. أي؛ منذ أن تأسست في المجتمع العربي الإسلامي الدولة بمعنى الكلمة، الدولة بوصفها مؤسسة قهرية تضع نفسها فوق المجتمع، وتحكمه باسم الدين وباسـم المصلحة العامـة، أو بغير ذلك من الشعارات. ومن هنا أصبحت المُشكلة هي مشكـلة من يحكم، وكيفية انبثاق الحكم من إرادة المواطنين واختيارهم، وهي مشكلة الديمقراطية.
يُجمع معظم المفكرين السياسيين والمؤرخين على أنه لا يوجد شيء بذاته في الحياة السياسية يُدعى الديمقراطية كتجريد شكلي. فالديمقراطية ليست مفهومـاً مطلقاً لأنها ترتبط بالحرية ارتباطاً مباشراً. والديمقراطية حركـة سياسية معينة، تحملها قوى وحركات اجتماعية معينة وتناضل من أجلها.
&
الأسباب الاجتماعية لتخلف الديمقراطية العربية
تعود الأسباب الاجتماعية لتخلف الديمقراطية العربية الى عدم احترام قيمة الإنسان العربي، وإلى تخلّف الفـرد العربي، وإلى عدم إمكانية الإصلاح الاجتماعي باتباع الطرق الديمقراطية، وإلى غياب التعليم وغياب المؤسسات الدستورية، واستمرار الصراعات الطائفية والقبلية والدينية، وإلى اختفاء قوة الطبقة الوسطى، وإلى عدم تزامن التطور الاجتماعي مع التطور الاقتصادي، وإلى تأصيل الروح الطائفية والعشائرية بين الأحزاب السياسية، وإلى انتشار التخلف الحضاري في المجتمع العربي، وإلى حصار الإنسان العربي في ثالوث متكلِّس يتمثّل في أيديولوجيـة العائلية والمؤسسة الدينية والدولة المتخلفة، وإلى غياب السياسة من فكر العامة. ويمكن تفصيل كـل هذا& على النحو التالي:
&
-&&& إن احترام الفرد وقيمُتُّه في المجتمع العربي مفقود. وهي القيمـة الأساسيـة التي تستند إليها الديمقراطية الليبرالية. وتلك واحـدة من عوائق تحقيق الديمقراطية في العالم العربي. فالمجتمع العربي ما زال مجتمعاً قبلياً طائفياً عشائرياً، الولاء فيه لفكر القبيلة والطائفة، وليس لفكر الحقيقة. وعلينا أن نسعى إلى إيجاد نوع من التوازن بين حقوق الشخص وأهميته وحقوق الجماعة في طريقنا إلى الديمقراطية. فما زلنا بعيدين عن هذا التوازن بُعداً كبيراً.
-&&& إن التخلف الفردي المتمثل بالأمية والفقر والتمثل الجمـاعي المتمثل بفقدان التنظيم وفقدان الأحـزاب ودور المرأة والمستوى الثقافي والجامعات ومعاهد الأبحاث ومستوى الأحزاب الموجودة والنقابـات، كل هذا كان مساعداً على وضع العوائق في طريق الديمقراطية العربية. كذلك، فإن فقـدان التجارب والصيغ التي تُطرح كبدائل للنظام الديمقراطي وضياعنا بين جاذبية الأصالة وجاذبيـة التراث والمتغيرات، كل هذا ساهم إلى حـد كبير في وضع عوائق في طريـق الوحدة. فلا نزال إلى الآن في ضياع كبير لا ندري على ماذا نحافظ، وماذا يجب أن نترك ونتخطى للوصول إلى صيغ وأشكال جديدة.
-&&& يطرح بعض المفكرين العرب السؤال عن إمكانية تحقيق الإصلاح الاجتماعي باتباع الطرق الديمقراطيـة. ويستدركون بأن تجربة العرب الديمقراطية البرلمانيـة لفترة قصيرة نسبياً أقنعتهم بأن هذا النظام فاشل تماماً. ولكن علينا أن نعلم ان النظـام الديمقراطي الناجح يتطلب وجود جمهور متعلم، وأحزاب سياسية منظمة، وقيادة نيّرة. فلقد كان الهدف الرئيسي للنظم الدستورية التي ولدت بعد الحرب العالمية الأولى بلوغ الاستقلال، وقد تحقق ذلك.
-&&& إن غياب التعليم وغياب المؤسسات الدستورية واستمرار الصراعات الطائفية والقبلية والدينية تعتبر عوامل مؤثرة في عدم اندماج الفرد مع السلطة. كما تؤثر هذه العوامل من جهة أخرى على مفهوم المشاركة السياسية والتي تعتبر الديمقراطية أبرز مظاهرها. وكلمـا زاد تطور المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للفرد زادت مشاركتـه السياسية فكراً وعملاً. وكلما انخفض هذا المستوى قلّت مشاركته السياسية. فالديمقراطيـة ليست قالباً سياسيـاً يُطبَّق في الهواء وإنما تُعبِّر عن نضج الإنسان بعد إشباعه.& فلا ديمقراطية دون نضج، ولا نضج دون ديمقراطية.
-&&& اختفاء قوة الطبقة الوسطى من& المجتمع العربي لكونه مجتمعاً قبلياً وعشائرياً. وساعد على عـدم التكوين الطبقي في المجتمع العربي تقاسم كل أفراد المجتمع نفس القيم العقلية التقليديـة. وإذا كان من الممكن تقويم التطور الديمقراطي في المجتمع العـربي، فيمكن القول بأنه متوقف على نجاح وجود قوة الطبقة الوسطى وزيادة الوعي السياسي لدى المواطنين، وقدرة النخبة السياسية على تجاوز أنانيتها.
-&&& عدم تزامن التطور الاجتماعي مع التطور الاقتصادي في أنحاء كثيرة من العالم العربي، مما نتج عنه مقاومة اجتماعية للتطور الديمقراطي. وقد تُرجمت هذه المقاومة إلى الواقع بظهور سلوك التردد والتشكك وعـدم الثقة باتجاه النظام.
-&&& وجود الروح الطائفية والعشائرية متأصلة في معظم الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة العربية رغم أسماء هذه الأحزاب التي تدل على الحداثة والمعاصرة.
-&&& وجود طابع الزعامة والطاعة العمياء لها. فكما أن العشيرة بشيخها فالحزب بزعيمه، إذا أقبل أقبل معه الحزب وإذا أدبر أدبر معه الحزب أيضاً. والزعيم في حزبه أكثر ديكتاتورية من السلطان في قصره.
-&&& إن وراء الفشل الديمقراطي في العالم العربي " تاريخ كامل من التربية الفكرية السياسية. فالتفكك العقلي وحرية الثقافة والرأي والتردد بين مفاهيم قديمة فقدت فعاليتها الواقعية ومفاهيم حديثة دخلت لتصوغ الواقع على شاكلتها دون أن تُطوَّع كفايةً، كل ذلك أدى إلى فقدان الفكر لقدرته على وضع يده على الواقع والإمساك به والسير معه. وعلينا أن ننتهي من الإرهاب الفكري الذاتي الذي هو شرط استمرار الإرهاب السياسي، وسبب تقهقرنا الدائم نحو التوحّش والبربرية"، كما يقول برهان غليون، (مجتمع النخبة، ص 289، 292).
-&&& إن الإنسان العربي يعيش في ظل حصار ثالوث متكلّس وجامد. فهناك أولاً أيديولوجية العائلة الهرمية على أساس الجنس والعمر. وهناك ثانياً المؤسسة الدينية التي تُغرق المؤمنين في بحر التقاليد التي ترسَّخـت وجعلتهم يرضون بمصيرهم وفقرهم على أنه قضاء وقدر، ثم هناك ثالثاً الدولة التي يطول ذراعها دونما حماية للمواطن بوضع قوانين أو دساتير حقيقية.
-&&& إذا كانت هناك أزمة ديمقراطية، فإنها تبدأ من مسألة الشراكة الممكنة بين الحاكم والمحكوم في تقرير السياسة. كما أن أزمة الديمقراطيـة تبدأ من فكر العامة ولا تنتهي في فكر الخاصة.& وفي فكر العامة تغيب السياسة كمحظور، ويُحكى عنها كمحرَّم مقبول شعبياً،& كقولهم "السياسة كناسة"، و "السياسة وجع راس"، و "من دخل السياسة غرق في النجاسة" الخ.
&









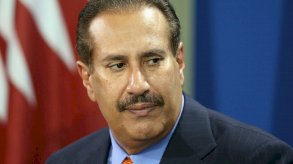


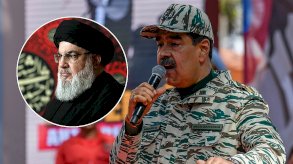
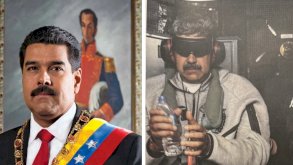
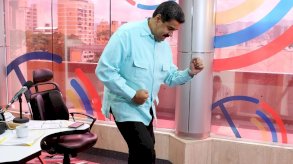

التعليقات