كريم عبد
&
&
(العراضة) التي تحولت مظاهرة أو استعراض عسكري أو شبه عسكري، كلها تجليات لظاهرة واحدة. ظاهرة امتازت بـها الدول الشمولية والأنظمة الديكتاتورية كتعبير عن أيديولوجيا تنظر للمجتمع المعني باعتباره مصدر قلق، لذلك فالمطلوب تحويله إلى كتلة واحدة، كتلة يجب أن تكون قوية ومتماسكة، مثلما يجب أن تكون خاضعة ومنتظمة في خضوعها، والخضوع هنا كلمة لا تُستخدم بل يُستعاض عنها بـمصطلح شائع، هو ( التأييد )، تأييد الحزب والثورة. وكل هذا لا يـجري اعتباطا ً، فهناك ( هدف ) و(قضية ) و ( مبادئ ) تعمل جميعها من أجل تقوية وتفعيل (الجبهة الداخلية) ضد العدو الخارجي وعملائه في الداخل!! فبدون إشاعة مشاعر القلق الجماعي من خلال أجهزة الإعلام الرسمي، أو كما يفعل هذه الأيام علي عقلة عرسان وفاضل الربيعي وموفق محايدين وأمثالهم من أشباه المثقفين البعثيين أو المرتبطين، لا يمكن تبرير فعاليات مقحمة على مشاعر الناس من هذا النوع.
العراضة إذن، أو المظاهرة أو إقلاق وتجييش المشاعر الجماعية، ليست مجرد نزوة أو حالة استثنائية، بل هي بالإدمان الناتج عن التكرار والتعوّد، تصبح قاعدة يراد لها أن تكون أقرب إلى العادة اليومية أو الروتين. فالقيادة في أنظمة كهذه، وبحكم شعورها ومعرفتها بلا شرعية النظام الذي تديره، تريد تحويل الخضوع إلى قاعدة وثقافة كي تلغي أية بوادر محتملة لأية معارضة سياسية أو ثقافية تهدف لطرح سؤال شرعية النظام الدستورية على بساط البحث. فسؤال الشرعية في واقع المجتمعات الخاضعة للأنظمة الشمولية، موجود في جوهر الأزمة وتفاصيلها. إن كل شيء تقريباً يؤدي إلى سؤال الشرعية، بدءاً من هبوط مستوى المعيشة مروراً بحرية الرأي أو قتل البشر في أقبية الأجهزة السرية أو الموقف من قضية الأقليات القومية والدينية...الخ، وعلى هذا الأساس تصبح أية معارضة حقيقية ممنوعة في ظل هذه الأنظمة، خاصة إذا أصبح رئيس اتحاد الكتّاب العرب في مقدمة مؤدلجي أنظمة القمع والطوارئ والتضليل.
ولذلك لا يمكن لجم المعارضة وتغييبها إلا من خلال العراضات ( المظاهرات ) الوطنية الشاملة والصخب المتسع ( للجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة )!! ولكن ما هو السياق الذي أنتج هذه الظاهرة، أي الذي حول العراضة ذات المنشأ الريفي المناسباتي والمحدود إلى مظاهرة تجتاح المدينة طولاً وعرضاً؟ !
&كمحاولة للإجابة على هذا السؤال، يمكن القول: إن ظاهرة ( العراضة ) بما هي مشهد شعبي متوارث في المجتمعات العربية حيث كان الطابع الريفي هو الغالب، تثير جملة من المعاني الفلكلورية والأنتربولوجية المتعلقة بتداعي الجماعة المعنية للإعلان عن مناسبة اجتماعية أو دينية أو حدث ما، كجنازة شخصية مهمة في العشيرة أو المنطقة، يُراد تأكيد أهميتها ودورها وربما دور ورثتها أيضاً. أو في الأفراح أو مواسم العمل الجماعي وما يرافق ذلك من طقوس وأهازيج قد تختلف في بعض التفاصيل لكنها تلتقي من حيث الجوهر في معنى واحد هو تأكيد التفاف الجماعة حول تلك الشخصية وقيمها، أو حول الحدث ووحدة الموقف منه.
فالعراضة هنا هي خروج من العزلة الفردية إلى الاحتفال الجماعي وتأكيد الروابط والوشائج الإنسانية المباشرة والتواصل مع طقوس وعادات قديمة متوارثة هي بمثابة هوية جماعية تعود إلى مئات وربما آلاف السنين في المجتمعات ذات المنشأ التاريخي البعيد كما تؤكد بعض الكشوفات والحفريات التاريخية في العراق لناحية تشابه بعض تلك الطقوس والعادات الجماعية في المآتم والأفراح في العراق القديم مع ما هي عليه في العراق المعاصر حيث اغتنت وتطورت عبر العصور ودخول الأديان والتغيرات السياسية المتعاقبة وأحداثها التي غالباً ما اقترنت بالمآسي والمرارات.
وعبر كل ذلك كانت العراضة بما تمثله من تعبيرات ومواقف عبارة عن تجسيد لثقافة الجماعة ومستوى تطورها وبالتالي موقفها من ذاتها ومن الآخرين بكل ما ينطوي عليه ذلك من أبعاد نفسية واجتماعية أو سياسية، الأمر الذي يعني بالضرورة تأثر هذه الظاهرة بالواقع والعوامل الخارجية ذات الصلة بحياة الجماعة المعنية ومصالحها المعنوية والمادية. فمع نشوء الدول الحديثة في البلدان العربية وتطور إيقاع الحياة المعاصرة، خفّت ظاهرة العراضة وما شابـهها من طقوس وعادات واختفى بعضها لصالح تجليات جديدة هي أقرب لحياة الإنسان المعاصر ومشاغله ومتطلباته، وقد تزامن ذلك أو تناسبَ طردياً مع تراجع دور العشيرة وتحسن ظروف العيش نسبيا واتساع المدن وتزايد دور الدولة ومؤسساتها في حياة المجتمع.
ومنطقياً فان تطورات من هذا النوع تحتاج دائماً إلى صمام أمان يجعلها تتقدم بما يكفل خدمة إنسانية الإنسان وحاجاته الروحية والمادية. وإذا كان كل ذلك بالنسبة للمجتمع المعاصر مرتبط بدور الدولة ونوعية النظام الذي يديرها، وما يعنيه ذلك من نوعية التطورات الحاصلة في المدن والأرياف وطبيعة العلاقة بينهما ومتعلقات ذلك من تفاصيل كثيرة تبدأ من نوعية الموقف من حرية المرأة مروراً بمستوى التعليم وتوجه وسائل الإعلام وصولاً إلى الشرعية الدستورية لنظام الحكم. وكل هذا يتعلق بمستوى النضج الاجتماعي الذي يطبع إيقاع المجتمع والدولة بطابعه، والذي يعني واقعياً وجود أو عدم وجود مجتمع مدني وموقف الدولة من هذه القضية بالذات.
فالمدينة لن تصبح مدينة حقا وسكان الريف لن يتطور وعيهم ومستوى عيشهم بمجرد وجود الدولة، أو زيادة عدد المدارس أو مكننة الزراعة واتساع ظاهرة التصنيع، فكل هذا يمكن أن يوجد حيث تفرضه الظروف الموضوعية ولكن يمكن أن يوجد إلى جانبه التضخم وغياب الحريات العامة والاضطراب السياسي. وما حدث في بعض البلدان العربية أمر يدعو للتأمل والتساؤل، وما نقصده تحديداً هو تفكك العلاقات الريفية ودخول المكننة الزراعية واتساع المدن وما يعنيه ذلك من تفكك في بعض الطقوس والعادات والقيم دون نشوء بدائل مدنية نوعية جديدة في طريقة الحياة الفردية والجماعية تجعل الماضي ماضياً والحاضر متجددا ومفعماً بمعان وطموحات جديدة تشكل هويته كزمن آخر مختلف أكثر جمالا وفائدة.
إن ما حدث في العديد من التجارب هو تطور عشوائي داخل بنية المدينة، وقد تجسد هذا التطور العشوائي في الحياة الاجتماعية بأشكال مختلفة، اقترن دائماً بـهزات اختلط فيها العنف بالتخلف وأصبح الواحد يبرر وجود الثاني، فالبؤس الذي يأتي به الفلاح الذي ضاق به الريف معيشياً وهو يبحث عن أسباب لتحسين حياته في المدينة، هو في الغالب يظل بؤساً وربما أصبحت الحياة في المدينة أكثر مشقة وصعوبة بالنسبة له، فالمدينة ستطالب هذا المواطن بالتخلي عن عاداته الريفية التي قد يعتبرها هو قيماً رئيسية في الحياة. والمدينة تطالبه بالتخلي عنها دون أن تقدم له بديلاً مُقنعاً في الغالب، لا على صعيد مستوى المعيشة ولا على صعيد العلاقة بالآخرين، أي دون أن تقدم له تعويضاً وهي تجبره على ذلك التخلي. فليس ثمة فرص عمل متوفرة دائماً وأن توفرت فإن مردودها لن ينقذه من بؤسه المعيشي المزمن.
إن الأعداد المتزايدة الوافدة على المدينة من الأرياف نتيجة لشظف العيش سوف تجلب تقاليدها وعاداتها معها، السيئ منها والمقبول، والمدينة الراكدة في الغالب وغير المالكة لعوامل تطور اقتصادية وحضارية فاعلة، هي غير مالكة أيضاً لقرار قبولهم فيها أو رفضهم، لذلك فهم سيأتون دائماً ومضطرين في الغالب، ليتجمعوا على أطراف المدينة وهوامشها. هوامشها السكنية وهوامشها الاقتصادية وهوامشها الثقافية حيث حيرة الوعي وعذاب المشاعر واللاجدوى والمستقبل غير المضمون.
وهذا لا يعني أن سكان المدن سعداء أو أنانيين أو ضنونين بالسعادة على أولئك الريفيين بالضرورة، لأنه من الصعب القول بوجود سعادة حقيقية في مدن تعيش حياتـها وتواجه مصائرها عشوائياً أو في ظل الفوضى المنظمة.
في هذه الأجواء الخانقة وداخل هذه التجمعات السكانية الباحثة عن خلاص دون جدوى، ستنشأ الأحزاب الثورية والانقلابية، وسيصبح ( البحث عن خلاص ) ثقافة أساسية عند الجماعات المتعلمة والمحرومة من فرص العمل، فالدول التي تنشأ في ظلها جماعات ثورية وانقلابية هي دول عاجزة عن توفير فرص عمل وأمان وضمان اجتماعي لمواطنيها، وهي ظاهرة لا يستطيع إيقافها أحد ما دامت عوامل إنتاجها موجودة.
ومع نشوء التنظيمات الثورية وتطور النـزعات الانقلابية سيجري باستمرار تغيير في النظر لظواهر الحياة وتفاصيلها، للإنسان والأدب والدولة والقيم وقضية الحرية والعدالة. تغيير يكون عادة مصحوباً بالتوتر والحدية، ويصبح العنف بالتدريج مرغوبا ومطلوباً، حيث تصبح ( البطولة ) قناعاً سهل الارتداء، ويتداخل الصحيح بالخطأ والخير بالشر بطريقة لا يمكن التدقيق فيها، فيصبح بوسع أي بلطجي أو دجال أو كاتب رخيص أن يوهم الناس بأنه بطل، دون أن ننسى بان النـزوع نحو البطولة هو كثيراً ما يعبر عن الشعور بالنقص، أو يصبح ملحّاً عند بعض المصابين بمختلف أنوع العصاب النفسي، أو عند تلك الشخصيات المصابة بالرغبة المرضية الهادفة إلى السيطرة على الآخرين.
وفي هذه التداخلات والاختلاطات تكمن وتتجسد أزمة الفكر الثوري والتنظيم الثوري، بحكم نشوئهما في ظل أجواء الاختناق والتوتر والتخلف هذه، وهو السبب أيضاً في فشل التجارب الثورية أحزاباً وأنظمة. فهذه الهيئات لم تنشأ نشأة طبيعية وحضارية بالمعنى الحقوقي والسياسي، لذلك فهي لا تمتلك حلولاً من هذا النوع، ولأنـها نتاج الاضطرابات والتوتر وقادمة من رحمها فهي مسكونة بعقدة السيطرة والخوف من الاضطراب المضاد.
وإذا عدنا إلى موضوع ( العراضة ) سنجد بان عودتـها إلى بعض البلدان العربية وتطويرها من قبل الأنظمة الثورية واستعمالها على هيئة مظاهرات واستعراضات عامة، لم يأت اعتباطاً، وربما كانت التجربة العراقية من التجارب النموذجية بـهذا الصدد، فحتى خمسينات هذا القرن كانت الأرياف العراقية تشهد، عند كسوف القمر، عراضات ليلية مثيرة وربما كانت فريدة من نوعها، حيث يضيء الفلاحون مشاعلهم قادمين من أعماق بساتينهم متجمعين عند ضفاف الأنـهار مرددين هتافات صاخبة مفادها ( يا حوته يا بلاعه هدي قمرنه بساعه ) معتقدين بأن حوتاً قد ابتلع القمر، وعلى هذا الحوت أن يترك قمرهم بسرعة. وليس بخاف ما يرمز إليه القمر عبر التاريخ عند الشعوب البسيطة، على أن علاقة العراقيين بالقمر لم تنته فصولاً، فهو حاضر في خيالهم بشكل ملحٍّ وحضوره في أشعارهم وأشعارهم الشعبية بشكل خاص يتخذ طابعاً احتفالياً ورمزياً، وعلى صعيد الجمهور فحتى نـهاية الخمسينات ومطلع الستينات، وهو العصر الذهبي للعراضات ( المظاهرات ) الوطنية التي كانت تُقام ليلاً نهاراً. كان الكثيرون يؤكدون انهم شاهدوا صورة الزعيم عبد الكريم قاسم على القمر!! وكانت تلك العراضات كثيراً ما تتخذ طابعاً عفوياً بحكم استبشار العراقيين بالزعيم باعتباره منقذاً على وشك أن يضع حداً لأزماتهم، ومعاناتهم المزمنة. لكن ومثلما حدث في العديد من تجاربهم السابقة سرعان ما اكتشفوا مرارة الوهم ووجدوا أنفسهم يدفعون ثمن أخطاء منقذهم العتيد رغم نزاهته المعروفة. على أن ظاهرة العراضات الوطنية لم تنته في العراق بل أصبحت خلال الثلاثين سنة الماضية أكثر تنظيماً وقصدية من قبل النظام الذي يخصص لها أجهزة خاصة ويبدد من أجلها الملايين، وفي الفترات الأخيرة من عهد النظام السابق، أصبح رئيس الجمهورية هو الذي يطلق النار في هذه العراضات، لا تأكيدا لانتمائه لهذا الجانب العنيف من فلكلور متخلف ذي منشأ ريفي فحسب، بل وأيضاً تأكيداً على طبيعة سياسة الدولة في هذا المجال، سياسة تجييش المشاعر وإخضاع الجمهور لشعارات موحدة وإجبارية ولا فكاك منها. وكل هذا يعني عملياً بان المواطن الجيد هو الخاضع جيداً لشعارات السلطة ومفاهيمها، أو حسب التعبير الحزبي ( المواطن الجيد هو البعثي الجيد ) على خلفية شعار آخر يقول ( كل مواطن بعثي وأن لم ينتم )!!
ومن المفارقات القريبة التي لا بد من ذكرها هنا، هي أن النظام في الفترات الأخيرة أخذ ينظم جنائز جماعية للأطفال العراقيين الذين يموتون بسبب سوء التغذية وعدم توفر الأدوية بسبب الحصار الاقتصادي من جهة وسياسة التجويع المتعمد التي يتبعها النظام ذاته من جهة أخرى، محوّلاً تلك الجنائز المؤلمة إلى عراضات لدعم سياسته العدمية. ومكمن المفارقة هو أن تلك الجنائز صارت تتزامن مع تنظيم عراضات لم يشهد لها العراق مثيلا، وتتمثل بالاستعراضات الشعبية - العسكرية التي كانت تشهدها بغداد بين وقت وآخر، حيث يقتاد آلاف العراقيين من مختلف المحافظات للمساهمة فيها، وما يعنيه ذلك من تبديد لأموال طائلة بإمكانـها إنقاذ المئات من أولئك الأطفال الذين كانوا على وشك الموت، لكن ذلك بالنسبة للسلطة كان يعني توقف العراضات الجنائزية في حين المطلوب استمرارها وفق أعراف النظام، وذلك لكي يبقى قمر التخلف والرعب والموت زاهياً مهيمناً على عراق البعث الحزين المحطم.














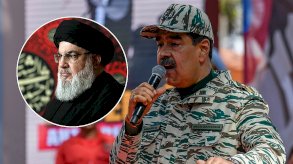
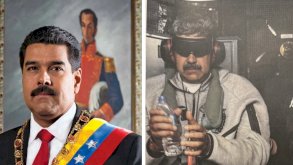
التعليقات