ترجمة نضال نعيسة عن السنداي تايمز: بدأت الحكومة البريطانية على الصعيد المحلي والوطني العام، إستراتيجية قائمة على التعددية الثقافية، دفعها إلى ذلك أعمال شغب عنصرية حدثت في ثمانينات القرن الماضي. وتم الإجماع فيها على إيلاء الاحترام لأنماط الحياة المختلفة، وأنماط الحياة هذه كانت تصنف، وبشكل مأساوي، كجاليات مع زعمائها المحليين القائمين عليها.
لقد كان ذلك ناجعاً، بطريقة ما، فلقد تقلصت العنصرية في الواقع، لكن التكلفة كانت باهظة. فإن استحداث الجاليات كان من شأنه أن يستعيض عن العنصرية بالقبلية، فاندلعت لذلك حوادث شغب قبلية في العام 2005 بين السود والآسيويين في بيرمينغهام. وكان سبب ذلك هو التعددية الثقافية. فقبل أن يخبرهم المجلس بأنهم كانوا أعضاء لـquot;جاليةquot;، كانوا مجرد شعب يعيش معاً في نفس المكان. فـquot; العداوةquot;، كما يكتب كنعان مالك، لا تسري في دم الآسيويين أو الأفارقة- الكاريبيين، ولكنها في الشيفرة الوراثية الـquot;دي.إن. إيه لسياسات التعددية الثقافية.
وفكرة استحداث الجاليات تحت مسمى التعددية الثقافية كانت اعترافاً بعجز وعدم كفاءة الحكومة. فحينما أراد توني بلير أن يحارب التطرف بين quot;الجاليات الإسلاميةquot;، قال بأن ذلك ليس من صلب عمله، ولكنه من صلب عمل quot;زعماء الجاليةquot;. لقد أصبحت بريطانيا منطقة محظورة على الملونين. ويخبرنا كتاب من الفتوى إلى الجهاد هذه الحكاية المؤرقة، وبقسمه الأكبر، وعلى نحو مثير للإعجاب. فمالك هو في المكان الأنسب لفعل ذلك. فهو كان قد ولد في الهند وقدم إلى بريطانيا في سن الخامسة. ووالدته كانت هندوسية، أما أبوه فقد كان مسلماً، ولكنه لم يكن ذا تنشئة دينية. فالعنصرية أو العرقية، وليس الدين، هي التي شكلت راديكاليته المبكرة، وفعلت ذات الشيء بالكثير من الملونين في هذا البلد.
العنصرية هي السبب الذي تأتلف حوله كل المذاهب والألوان. إنها عدو عالمي من الممكن النيل منه بالإيمان بالتنوير العالمي، وبأن هناك قيماً يمكن أن تطبق بشكل عقلاني وعادل على كل المجتمعات البشرية. فشق العالم إلى جاليات، والاحتفاء بالاختلاف بأية أثمان، هو أمر مناهض تماماً لإستراتيجية التنوير.
إن فتوى آية الله الخميني - الحكم بالإعدام- الصادرة ضد سلمان رشدي بسبب روايته التجديفية المفترضة quot;الآيات الشيطانيةquot;، في العام 1989 قد مهدت السبيل لنحر العالمية ووقف تقدمها. وينظر مالك إلى تلك اللحظة، بحق، كدقيقة وخطرة جداً. فهناك كاتب بريطاني يتخفى متوارياً عن الأنظار، وهناك كتب تحرق. وفي ذات العام الذي ينهار فيه جدار برلين. لقد كنا على وشك وضع أهوال شموليات القرن العشرين وراءنا، حين داهمنا طغيان ديني بشكل ظاهري متحدياً كل أحلامنا بالتقدم.
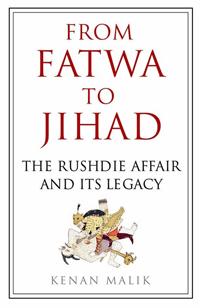 واكتشف الكتـّاب، بغتة، بأن حرفتهم المهمـّشة آنفاً، اندفعت بقوة إلى الخط الأمامي. وقد مرّت دار نشر بنغوين، ناشر كتاب رشدي، بهذه التجربة الحاسمة، مبقية على طباعة الكتاب بالرغم من التهديدات الماثلة. ولكن، وبطريقة أخرى، فقد كسب الخميني. ففي تموز/ يوليو من العام الماضي، سحبت دار نشر راندوم في أمريكا نشر كتاب شيري جونز quot;جوهرة المدينةquot;، بسبب مخاوف من عمليات انتقام إسلامية، وقد أدى الكتاب بعد شهرين من ذلك إلى حرق فرع دار النشر في لندن quot;جيبسون سكويرquot;. وأثناء ذلك، فقد أظهر الكتـّاب خوفاً بشكل مفهوم. وهنا يقتبس مالك قولاً لحنيف قريشي :quot; لا يمتلك أي شخص، اليوم، الجرأة على أن يكتب آيات شيطانية، ناهيك عن نشرها. الكتابة اليوم في وضعية الخوف، فالكتـّاب يروعونquot;.
واكتشف الكتـّاب، بغتة، بأن حرفتهم المهمـّشة آنفاً، اندفعت بقوة إلى الخط الأمامي. وقد مرّت دار نشر بنغوين، ناشر كتاب رشدي، بهذه التجربة الحاسمة، مبقية على طباعة الكتاب بالرغم من التهديدات الماثلة. ولكن، وبطريقة أخرى، فقد كسب الخميني. ففي تموز/ يوليو من العام الماضي، سحبت دار نشر راندوم في أمريكا نشر كتاب شيري جونز quot;جوهرة المدينةquot;، بسبب مخاوف من عمليات انتقام إسلامية، وقد أدى الكتاب بعد شهرين من ذلك إلى حرق فرع دار النشر في لندن quot;جيبسون سكويرquot;. وأثناء ذلك، فقد أظهر الكتـّاب خوفاً بشكل مفهوم. وهنا يقتبس مالك قولاً لحنيف قريشي :quot; لا يمتلك أي شخص، اليوم، الجرأة على أن يكتب آيات شيطانية، ناهيك عن نشرها. الكتابة اليوم في وضعية الخوف، فالكتـّاب يروعونquot;.
وبالنسبة للمتحمسين الإيرانيين الما بعد ثوريين، فالقيم الليبرالية الغربية كانت فقط على مبعدة خطوة أخرى على طول الطريق المعادي للإسلام الذي بدأ مع الحملات الصليبية. وهكذا فقد تم توظيف، أو تجنيد الخطيئة الاستعمارية لاستيلاد مواقف مناقضة للغرب. هذا بالرغم من أنها كانت تجند باسم الأتوقراطية الدينية المتوحشة.
حقيقة الخميني الإسلامية كانت هراءً على أرض الواقع، فلم تكن في الأصل سوى محض محاولة شيعية لانتزاع السلطة من السنة والسعوديين. ولقد نجحت. فقد أعطت الفتوى، وبضربة واحدة، هوية عولمية جديدة لأي أسلامي حديث العهد بالتطرف. وعلى نحو مباغت، ولدهشته، وجد مالك، حتى اليوم، شباناً مسلمين علمانيين، ويساريين يتحولون إلى متطرفين إسلاميين. لقد كان الخميني قد شرعن سخطهم وذلك بتحويل أنظارهم من العدو الأممي للعنصرية نحو الصورة المحددة، لرجل واحد فقط، وكتابه.
لقد حدث هذا بالرغم من واقع أن معظم القرّاء المسلمين للآيات الشيطانية، كانوا قد أظهروا قدراً من اللامبالاة حيالها قبل صدور الفتوى. لقد كان لتكثيف التركيز على قضية واحدة محددة، واستغلال توافه السياسة، هو ما جعل الفتوى ذات فاعلية كبيرة. نعم، حفظ شيوخ الإسلام درسهم جيداً. فلقد تم استغلال الصور الكارتونية لمحمد على نحو مواز بذات الدقة.
وهذا ما يدعم واحدة من السجالات المحورية لكتاب مالك ألا وهو إن الإسلاموية ليست، كما يردد البعض بتكاسل، مجرد ارتداد، أو انعكاس لوجهة نظر ما قبل قرووسطية، أو أنها كانت كذلك. فلم يكن هناك أبداً إسلام من نمط الخميني أو القاعدة، فهذه حركات عصرية على وجه الدقة. ويجب أن يضاف هذا إلى الحقيقة المثبتة بإتقان، أن الغالبية العظمى من الإرهابيين الإسلاميين قادمون من الطبقة الوسطى المثقفة، من ذلك النمط من الناس القادرين على فهم واستخدام العصرنة.
إن وجهة نظر كهذه تعتبر تحدياً للمتشددين على اليمين واليسار. فالبعض على اليمين قد ساجل بأن الإرهاب الإسلامي هو، بطريقة ما، متأصل أو جوهري في الإسلام نفسه، وبأن القرآن هو كتاب يدعو للحرب. ولكن جل الدين هو تفسير، والأخذ بهكذا وجهة نظر يعني دحض 1500 عاماً، على الأقل، من الأدلة التاريخية التي تفضي إلى العكس من ذلك. وعلى جبهة اليسار، فإنه ينظر للإرهاب على أنه رد فعل ضد الشرور الغربية، وبشكل رئيسي الاستعمار. ولكننا دأبنا على تصدير الشرور للعالم الإسلامي لعدة قرون، غير أننا لم نشهد الإرهاب الإسلامي إلا منذ بضعة عقود خلت فقط. فالحقيقة هي كالتالي، إن انتشار قوة الفتوى، جنباُ إلى جنب مع الصور الكاريكاتورية جعل الأمر واضحاً، الإرهاب الحديث هو من صنع الحداثة. القاعدة هي شيء واحد، وواحد فقط: إنها ماركة.
يتناقص كتاب من الفتوى إلى الجهاد في ثلثه الأخير كثيراً. وحتى ذلك الحين، فإن مالك يقوم بعمل خارق لاستخلاص العبر من خلال الروايات. وبعد ذلك يهبط به إلى مجرد سجال، وهذا ما سيقلل من تركيزه حيث وجب أن يتوسع. هذا يعني أيضاً، أنه يتفادى،عملياً، القضية الأكبر من الكل..
هو يريد أن يدافع عن قيم التنوير العالمية، ولكنه لا يجابه المشكلة الحقيقية مع هذا---- وهم الناس. فنحن مخلوقات قبلية، تتطلب الأعداء والهويات الاستثنائية. والحضارة تكبح راهنا جموح قبليتنا، والذي هو لماذا كانت التعددية الثقافية فكرة همجية كبيرة. غير أن الحضارة أمر محلي، وليس عولمياً. والخميني والقاعدة والليبراليون حاولوا جميعاً أن يتعولموا. ولكن النتيجة كانت، وعلى نحو دائم، مذبحة. أما بالنسبة للغرب، فإنها، تقليص هائل لحرياتنا، ليس أقلها حريتنا بالتعبير. فلن يرغب أحد الآن، بنشر آيات شيطانية، ولن يعبر أي شخص مطار دون أن يعذب ويهان. هذه هي العصرنة والحداثة.
لقد كان ذلك ناجعاً، بطريقة ما، فلقد تقلصت العنصرية في الواقع، لكن التكلفة كانت باهظة. فإن استحداث الجاليات كان من شأنه أن يستعيض عن العنصرية بالقبلية، فاندلعت لذلك حوادث شغب قبلية في العام 2005 بين السود والآسيويين في بيرمينغهام. وكان سبب ذلك هو التعددية الثقافية. فقبل أن يخبرهم المجلس بأنهم كانوا أعضاء لـquot;جاليةquot;، كانوا مجرد شعب يعيش معاً في نفس المكان. فـquot; العداوةquot;، كما يكتب كنعان مالك، لا تسري في دم الآسيويين أو الأفارقة- الكاريبيين، ولكنها في الشيفرة الوراثية الـquot;دي.إن. إيه لسياسات التعددية الثقافية.
وفكرة استحداث الجاليات تحت مسمى التعددية الثقافية كانت اعترافاً بعجز وعدم كفاءة الحكومة. فحينما أراد توني بلير أن يحارب التطرف بين quot;الجاليات الإسلاميةquot;، قال بأن ذلك ليس من صلب عمله، ولكنه من صلب عمل quot;زعماء الجاليةquot;. لقد أصبحت بريطانيا منطقة محظورة على الملونين. ويخبرنا كتاب من الفتوى إلى الجهاد هذه الحكاية المؤرقة، وبقسمه الأكبر، وعلى نحو مثير للإعجاب. فمالك هو في المكان الأنسب لفعل ذلك. فهو كان قد ولد في الهند وقدم إلى بريطانيا في سن الخامسة. ووالدته كانت هندوسية، أما أبوه فقد كان مسلماً، ولكنه لم يكن ذا تنشئة دينية. فالعنصرية أو العرقية، وليس الدين، هي التي شكلت راديكاليته المبكرة، وفعلت ذات الشيء بالكثير من الملونين في هذا البلد.
العنصرية هي السبب الذي تأتلف حوله كل المذاهب والألوان. إنها عدو عالمي من الممكن النيل منه بالإيمان بالتنوير العالمي، وبأن هناك قيماً يمكن أن تطبق بشكل عقلاني وعادل على كل المجتمعات البشرية. فشق العالم إلى جاليات، والاحتفاء بالاختلاف بأية أثمان، هو أمر مناهض تماماً لإستراتيجية التنوير.
إن فتوى آية الله الخميني - الحكم بالإعدام- الصادرة ضد سلمان رشدي بسبب روايته التجديفية المفترضة quot;الآيات الشيطانيةquot;، في العام 1989 قد مهدت السبيل لنحر العالمية ووقف تقدمها. وينظر مالك إلى تلك اللحظة، بحق، كدقيقة وخطرة جداً. فهناك كاتب بريطاني يتخفى متوارياً عن الأنظار، وهناك كتب تحرق. وفي ذات العام الذي ينهار فيه جدار برلين. لقد كنا على وشك وضع أهوال شموليات القرن العشرين وراءنا، حين داهمنا طغيان ديني بشكل ظاهري متحدياً كل أحلامنا بالتقدم.
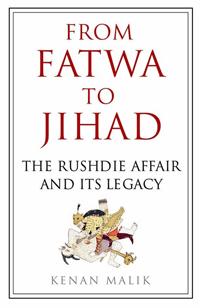 واكتشف الكتـّاب، بغتة، بأن حرفتهم المهمـّشة آنفاً، اندفعت بقوة إلى الخط الأمامي. وقد مرّت دار نشر بنغوين، ناشر كتاب رشدي، بهذه التجربة الحاسمة، مبقية على طباعة الكتاب بالرغم من التهديدات الماثلة. ولكن، وبطريقة أخرى، فقد كسب الخميني. ففي تموز/ يوليو من العام الماضي، سحبت دار نشر راندوم في أمريكا نشر كتاب شيري جونز quot;جوهرة المدينةquot;، بسبب مخاوف من عمليات انتقام إسلامية، وقد أدى الكتاب بعد شهرين من ذلك إلى حرق فرع دار النشر في لندن quot;جيبسون سكويرquot;. وأثناء ذلك، فقد أظهر الكتـّاب خوفاً بشكل مفهوم. وهنا يقتبس مالك قولاً لحنيف قريشي :quot; لا يمتلك أي شخص، اليوم، الجرأة على أن يكتب آيات شيطانية، ناهيك عن نشرها. الكتابة اليوم في وضعية الخوف، فالكتـّاب يروعونquot;.
واكتشف الكتـّاب، بغتة، بأن حرفتهم المهمـّشة آنفاً، اندفعت بقوة إلى الخط الأمامي. وقد مرّت دار نشر بنغوين، ناشر كتاب رشدي، بهذه التجربة الحاسمة، مبقية على طباعة الكتاب بالرغم من التهديدات الماثلة. ولكن، وبطريقة أخرى، فقد كسب الخميني. ففي تموز/ يوليو من العام الماضي، سحبت دار نشر راندوم في أمريكا نشر كتاب شيري جونز quot;جوهرة المدينةquot;، بسبب مخاوف من عمليات انتقام إسلامية، وقد أدى الكتاب بعد شهرين من ذلك إلى حرق فرع دار النشر في لندن quot;جيبسون سكويرquot;. وأثناء ذلك، فقد أظهر الكتـّاب خوفاً بشكل مفهوم. وهنا يقتبس مالك قولاً لحنيف قريشي :quot; لا يمتلك أي شخص، اليوم، الجرأة على أن يكتب آيات شيطانية، ناهيك عن نشرها. الكتابة اليوم في وضعية الخوف، فالكتـّاب يروعونquot;. وبالنسبة للمتحمسين الإيرانيين الما بعد ثوريين، فالقيم الليبرالية الغربية كانت فقط على مبعدة خطوة أخرى على طول الطريق المعادي للإسلام الذي بدأ مع الحملات الصليبية. وهكذا فقد تم توظيف، أو تجنيد الخطيئة الاستعمارية لاستيلاد مواقف مناقضة للغرب. هذا بالرغم من أنها كانت تجند باسم الأتوقراطية الدينية المتوحشة.
حقيقة الخميني الإسلامية كانت هراءً على أرض الواقع، فلم تكن في الأصل سوى محض محاولة شيعية لانتزاع السلطة من السنة والسعوديين. ولقد نجحت. فقد أعطت الفتوى، وبضربة واحدة، هوية عولمية جديدة لأي أسلامي حديث العهد بالتطرف. وعلى نحو مباغت، ولدهشته، وجد مالك، حتى اليوم، شباناً مسلمين علمانيين، ويساريين يتحولون إلى متطرفين إسلاميين. لقد كان الخميني قد شرعن سخطهم وذلك بتحويل أنظارهم من العدو الأممي للعنصرية نحو الصورة المحددة، لرجل واحد فقط، وكتابه.
لقد حدث هذا بالرغم من واقع أن معظم القرّاء المسلمين للآيات الشيطانية، كانوا قد أظهروا قدراً من اللامبالاة حيالها قبل صدور الفتوى. لقد كان لتكثيف التركيز على قضية واحدة محددة، واستغلال توافه السياسة، هو ما جعل الفتوى ذات فاعلية كبيرة. نعم، حفظ شيوخ الإسلام درسهم جيداً. فلقد تم استغلال الصور الكارتونية لمحمد على نحو مواز بذات الدقة.
وهذا ما يدعم واحدة من السجالات المحورية لكتاب مالك ألا وهو إن الإسلاموية ليست، كما يردد البعض بتكاسل، مجرد ارتداد، أو انعكاس لوجهة نظر ما قبل قرووسطية، أو أنها كانت كذلك. فلم يكن هناك أبداً إسلام من نمط الخميني أو القاعدة، فهذه حركات عصرية على وجه الدقة. ويجب أن يضاف هذا إلى الحقيقة المثبتة بإتقان، أن الغالبية العظمى من الإرهابيين الإسلاميين قادمون من الطبقة الوسطى المثقفة، من ذلك النمط من الناس القادرين على فهم واستخدام العصرنة.
إن وجهة نظر كهذه تعتبر تحدياً للمتشددين على اليمين واليسار. فالبعض على اليمين قد ساجل بأن الإرهاب الإسلامي هو، بطريقة ما، متأصل أو جوهري في الإسلام نفسه، وبأن القرآن هو كتاب يدعو للحرب. ولكن جل الدين هو تفسير، والأخذ بهكذا وجهة نظر يعني دحض 1500 عاماً، على الأقل، من الأدلة التاريخية التي تفضي إلى العكس من ذلك. وعلى جبهة اليسار، فإنه ينظر للإرهاب على أنه رد فعل ضد الشرور الغربية، وبشكل رئيسي الاستعمار. ولكننا دأبنا على تصدير الشرور للعالم الإسلامي لعدة قرون، غير أننا لم نشهد الإرهاب الإسلامي إلا منذ بضعة عقود خلت فقط. فالحقيقة هي كالتالي، إن انتشار قوة الفتوى، جنباُ إلى جنب مع الصور الكاريكاتورية جعل الأمر واضحاً، الإرهاب الحديث هو من صنع الحداثة. القاعدة هي شيء واحد، وواحد فقط: إنها ماركة.
يتناقص كتاب من الفتوى إلى الجهاد في ثلثه الأخير كثيراً. وحتى ذلك الحين، فإن مالك يقوم بعمل خارق لاستخلاص العبر من خلال الروايات. وبعد ذلك يهبط به إلى مجرد سجال، وهذا ما سيقلل من تركيزه حيث وجب أن يتوسع. هذا يعني أيضاً، أنه يتفادى،عملياً، القضية الأكبر من الكل..
هو يريد أن يدافع عن قيم التنوير العالمية، ولكنه لا يجابه المشكلة الحقيقية مع هذا---- وهم الناس. فنحن مخلوقات قبلية، تتطلب الأعداء والهويات الاستثنائية. والحضارة تكبح راهنا جموح قبليتنا، والذي هو لماذا كانت التعددية الثقافية فكرة همجية كبيرة. غير أن الحضارة أمر محلي، وليس عولمياً. والخميني والقاعدة والليبراليون حاولوا جميعاً أن يتعولموا. ولكن النتيجة كانت، وعلى نحو دائم، مذبحة. أما بالنسبة للغرب، فإنها، تقليص هائل لحرياتنا، ليس أقلها حريتنا بالتعبير. فلن يرغب أحد الآن، بنشر آيات شيطانية، ولن يعبر أي شخص مطار دون أن يعذب ويهان. هذه هي العصرنة والحداثة.











التعليقات