حين سقط تمثال الديكتاتور في بغداد نشب عراك طاحن في صالة مشاهدة التلفزيون. اشتبك ستة شبان سودانيين بمجموعة من العراقيين المحتفلين بسقوط الديكتاتور. ما قاله يوسف السوداني كان قد أشعل الشرارة: سينيك الجنود الأمريكيون نساءكم ... لم أنتم فرحون جداً؟
حاول الأفغان وبضعة شبان نيجيريين فض العراك. أما الإيرانيون فخرجوا من الصالة، وأخذوا يتفرجون من الشبابيك. سالت دماء كثيرة ، ونقل شاب سوداني إلى المستشفى. بعد أن شُجَّ رأسه، وفقد الوعي. وقبل أن تصل شرطة مكافحة الشغب، كانت تنبعث من الصالة رائحة كريهة، أما أثاث الصالة فقد حطم بالكامل.
تفرجت على المعركة بأعصاب باردة من باب الصالة. لقد مضى أكثر من ثلاث سنوات على وجودي في محطة استقبال اللاجئين في هذه المدينة الإيطالية الصغيرة، وقد شهدت عدة معارك طاحنة. وقد تنشب بسبب مسحوق غسيل أو لباس داخلي نسائي، وهذا ما حدث مع لباس بروين الكردية.
مرة أخبرت بروين النزلاء الأكراد بأنها شاهدت شاباً باكستانياً وهو يسرق لباسها الداخلي من حبل الغسيل. وهكذا اندلعت معركة شرف بين الباكستانيين والأكراد لم تتوقف إلا بعد ثلاثة أيام. وقد استعان مدير المحطة بالشرطة بعد أن عجز الحراس في المحطة عن وقف القتال.
ما أثار فضولي في معركة صالة التلفزيون هو علي البصراوي، كان يحضن حقيبته ويجلس في زاوية الصالة مبتسما كالمجانين. هذا الشاب الرقيق تغير كثيرا ًمنذ وصوله إلى المحطة. دعوته في المساء لشرب القهوة في غرفتي للاطمئنان عن أحواله وتوديعه. كان قد قرر إكمال مشوار رحلته إلى فنلندا. لست مقتنعاً تماماً بهذا القرار. نصحته بالذهاب إلى ألمانيا أو إلى أي بلد آخر، فربما تكون فرص العمل أفضل. تحدثنا طويلاً ذلك المساء عن أحلامه، ومخاوفه، وخططه. أخبرني أنه تمكن من سماع صوت أمه. كانت تحدثه بحب، وتسدي له النصح، لكنها كانت تعاتبه أيضاً على ما حدث لرأسها في الغابة اليونانية. كان سعيدا هو الآخر بسقوط الديكتاتور، رغم قلقه من فكرة أن تتوقف الدول الأوربية عن منح اللجوء للعراقيين. قلت له قد تتغير الأمور في البلد ونعود جميعا إلى بيوتنا وأهلنا. غير أنه ذكرني بحقيبته الرصاصية. ليس لي أي أهل، ولا أصدقاء، ولا أمل...كل ما أملكه حملته في حقيبتي...أتمنى أن أتمكن من أخذ أمي إلى مكان آمن، ومريح، فالمسكينة تعذبت طويلاً ...
يخيل لي في كثير من الأحيان، أنني سأقضي حياتي في الكتابة عن القصص والسورياليات التي عايشتها في دروب الهجرة السرية. أنه سرطاني الذي لا أعرف كيف أشفى منه. أخشى أن أنتهي بطريقة كوميدية مثل نهاية الكاتب العراقي خالد الحمراني. ظل طوال حياته يكتب عن السوق الشعبي القريب من سكنه. وحين أزيل السوق وشيدت مكانه بنايات سكنية، انتحر الحمراني، مخلفاً ست مجاميع قصصية، جميعها، تحاكي عالم السوق ودهاليزه.
مرة كنت أتحدث مع روائي شاب ألماني حول بعض تجاربي الشخصية في الهجرة السرية، وأفكاري في تحويل ما عشته إلى مادة أدبية متخيلة. وعندما جاء دور الشاب الألماني في الحديث أخبرني، أنه لم يكتب شيئاً يستحق الذكر، وإنه يعتقد بأن صغر سنه، وقلة تجاربه في الحياة هي سبب هذا العقم. شعرت أنه كان يريد أن يقول بأنه يحسدني على كل التجارب الحياتية الغريبة والمؤلمة التي عشتها. وبدل أن يمنحني ما قاله امتيازاً، شعرت بخجل شديد. فقد نبهتني ملاحظاته من جديد، على حقيقة أي كائن محطم وتافه هو أنا. تملكني خجل مرّ يشبه خجل ذلك الرجل الذي تحدث عنه تاركوفسكي: رجل يتعرض لحادث في الشارع فتقطع ذراعه، وحين يتجمع المارة حوله بانتظار وصول سيارة الإسعاف، يخرج الرجل منديلاً، ويحجب ذراعه من نظرات الآخرين إليه...
لكن حكاية علي البصراوي، كانت تغويني طوال الوقت للكتابة عنها، وعلى الرغم من أنها مثقلة بالأسى والعتمة مع مشاهد قليلة من سينما العالم الثالث التي تحاول استجداء عواطف مشاهدي الغرب، غير أنها أكدت لي في كثير من الأحيان على شعرية الوجه الإنساني المخبأ كجوهرة تحت ملايين الأطنان من زبالة هذه الحياة التافهة. وربما لكوني شاعراً، وأعيش لاجئاً في مثل هذا المكان ـ زريبة الأبقار، أملك قلباً قاسياً، أو ربما دماغاً لا يخلو من حكمة العبث السخيفة... دماغٌ يحاول أن يعبر بكلمات شحيحة، عن غضبه وشغفه بجوهر الرعب الإنساني، في آن واحد. لكنني كلما التفت إلى شجرة، أو تأملت ليلة مليئة بذئاب الشك، تفتق في قلبي ينبوع من الحزن الطفولي الساذج. أنا أعتقد بأن على الكتابة أن لا تعرج بسبب العاطفة المتواضعة التي تفوح من قمصان الجموع البشرية، والتي تتشابه، كمجموعة من المراحيض في حمام واحد. لكن حكاية علي، تسللت إلى دمي، وتمكنت من حلب دموعي ليالي عديدة. لقد بكيت على قلبي المتحجر، وبكيت لأن العالم أنقى وأجمل مما هو عليه بكثير.
حين وصل علي البصراوي إلى محطة اللاجئين في العام الماضي، حدثت ضجة كبيرة. أقام النزلاء حفلة صاخبة من الضحك والسخرية، حول ما كانت تحويه حقيبته الرصاصية. حقيبة سفر تصميمها يعود إلى خمسينيات القرن الماضي. وحال وصول علي، استدعى المسؤولون الشرطة التي حجزته ثلاثة أيام ثم أطلقت سراحه، لكنها لم ترجع له الحقيبة إلا بعد ثلاثة أشهر. أثناءها تم فحص الحقيبة في مختبرات العاصمة. و مدير المحطة صدمه خبر إعادة الحقيبة بجميع محتوياتها.
في تسعينيات القرن المنصرم، كان علي يعيش مع إخوته السبعة الذين يكبرونه سناً في أحد الأحياء البائسة في البصرة. كان والده حارساً ليلياً لبضعة محلات تجارية في وسط المدينة، وكانت أمه، مثل أغلب الأمهات العراقيات، عبارة عن كائن صبت على رأسه وحول الحزن والظلم والوحشية. يسهل للغاية نفي وجود الله عند معرفة يوم واحد من حياة أم عراقية. قد تبدو هذه المشاعر مجرد عاطفة رومانسية ساذجة. لكن لو كانت هناك كاميرات خفية تعرض للعالم ما يحدث للمرأة في بيوت الكراهية العراقية، لتكلم الحجر، شاتماً وجوده ومن أوجده. أخوة علي كانوا قد ورثوا عن أبيهم الإدمان على تحميل الأم كل مصائب ومشاكل الفقر والأقدار. كانت تضرب من أجل أتفه الأسباب. وكانت الأم تعاتب دوماً ربها الذي لم يرزقها ببنت، تعاونها في أمور البيت وتعطف عليها. لم ينس علي بسهولة، ذلك اليوم الذي واصل فيه الأخ الأكبر لكم رفس المرأة المسكينة إلى أن غابت عن الوعي، و لأنها لم توقظه كي يذهب إلى السوق بحثاً عن عمل. كان رد فعل الأم الوحيد، على ما تتلقاه من عنف وإهانة، هو الجلوس قرب دولاب الملابس القديم والبكاء، ومناشدة الأولياء الصالحين لتخليصها من ظلمها. كان علي صبياً آنذاك. وكانت الأم تضمه إلى صدرها وتنتحب. ربما كانت تحضن ولداً سيكبر ليضربها.
يقول علي إنها حين تتعب من البكاء كانت تخرج من دولاب الملابس، حقيبتها الصغيرة . الشيء الوحيد الذي تملكه - حقيبة سفر قديمة، فيها مشط خشبي، ومرآة، وصورة للإمام علي، وقرآن ملفوف بقطعة قماش خضراء، وصورة لها بالأبيض والأسود، حين كانت شابة، تجلس مع أبي على الكورنيش. كانت تفك فوطة رأسها السوداء، وتبدأ بتمشيط شعرها الأبيض مثل البلهاء ساعة بكاملها، وهي تدندن بلحن أغنية قديمة، تتحدث عن الحنين إلى الأم.
لكن ربما لقي دعاء المرأة المتواصل لتخليصها من هذه الحياة، آذاناً صاغية لدى شياطين السماء. فقد ماتت فجأة بالسكتة الدماغية . لينتظر علي بعد موتها سنوات أخرى، قبل أن يحقق انتقامه من أخوته وأبيه كومة الخراء الذي يعيش اليوم مشلولاً فوق كرسيه المتحرك.
خطط علي لكل شئ بهدوء ودقة لأكثر من عام. كان القرار هو الهروب إلى إيران أولاً. وفي ليلة الرحيل دخل غرفة أمه، وأخذ حقيبتها ثم تسلل هارباً. كان صديقه عدنان ينتظره في طرف الزقاق وهو يحمل معولاً ومسحاة في شوال. أشعل الصديقان سيجارتين وانطلقا صوب المقبرة. كانت السماء صافيةً، وثمة قمرٌ بحجم الألم ينير القبر الذي نبشه الصديقان. وبقطعة قماش برتقالية، نظف علي عظام أمه ثم وضعها في حقيبتها القديمة.
حمل علي أمه في الحقيبة وهرب إلى إيران. كان سعيدا بانتقامه. متخيلاً وجوه الجميع الممتقعة كما وجوه الموتى حين يكتشفوا الأمر. ولم تفارقه حقيبة العظام طوال رحلته الثانية إلى تركيا عبر الجبال. كان ينام في الوديان مع المهاجرين الآخرين، وهو يحضن الحقيبة بقوة، وحب، وتقديس. كانت حقيبته الغريبة ومبالغته في الحرص عليها، سبباً للتندر والهزء. لكنه لم يكن يأبه لذلك، ولم يكن يفضي بسرّ الحقيبة لأيٍّ كان. عمل طوال عام في اسطنبول في معمل لصناعة البالونات، كي يقدر على مواصلة رحلته في دروب الهجرة السرية. وطوال عام، وعلي، يحدث أمه في الليالي، عن البلد البعيد الذي اختاره للعيش بسلام. وعن رغبته في البدء بحياة جديدة ونسيان العذاب. لكنه صار يعاني بسبب الأم التي حشرها في حقيبة...
وحين حلت أقسى أيام البرد في اسطنبول، كان علي قد اتفق مع مهرب للسفر معه مشياً على الأقدام عبر الحدود التركية اليونانية. فالشتاء هو أفضل الفصول لعبور الحدود، حيث يتكاسل الجنود حراس الحدود عن القيام بدورياتهم اليومية. رغم أن علي كان خائفاً من موضوع النهر الذي سيعبرونه. لكن المهرب طمأنه وأكد له بأن العبور سيكون بواسطة قارب يكفي الجميع، فلا يمكن السباحة في نهر بارد. رغم ذلك اشترى علي أكياساً من النايلون، وقام بلف عظام أمهً.
ما أن سارت المجموعة خلف المهرب في الغابة حتى صاح جنود الحدود اليونانيين على المجموعة، وأمروهم بالتوقف. لكن المهرب طلب منهم أن يعدوا خلفه بأقصى سرعة، هاربين في ظلام الغابة، بين الأشجار الكثيفة. تاركين أطراف الأغصان تجرح وجوههم، وتمزق معاطفهم الشتوية. كان علي يركض بأقصى سرعته، وهو يضم الحقيبة إلى صدره، محاولاً أن يلازم المهرب لكي لا يظل طريقه، إلا أن اصطدم في جذع شجرة، ليرتد إلى الخلف ويسقط أرضاً، وتتناثر عظام أمه في ظلام الغابة. انحنى على الأرض، وهو ينزف من مقدمة رأسه، محاولاً جمع ما تناثر من العظام بذعر وإرباك. كان يتلمس العظام بحذر، قبل وضعها في الحقيبة من جديد. مسح الدم من فوق عينيه، وواصل الهرب مترنحاً. كان صياح الجنود يصل من بعيد بين الحين والآخر.
لقد نجت المجموعة من كمين جنود الحدود بإعجوبة، وبفضل ذكاء المهرب، ومعرفته دروب الغابة. لكن شاباً إيرانياً وآخر كردياً تاها في الغابة، وربما أمسك بهما الجنود. أما بقية المجموعة فقد وصلت إلى العاصمة أثينا بسلام. وسلم المهرب من تبقى منهم إلى مهرب يوناني عجوز، لنقلهم عبر البحر إلى إيطاليا.
أثناء مكوث علي في بيت في أثينا لتهريب المهاجرين، فحص ما في الحقيبة. كانت عظام أمه، والمرآة، والمشط الخشبي، وصورة الإمام علي، والقرآن كلها في مكانها. لكن ما كان مفقوداً هو الرأس الذي كان يلامس رأسه ويحنو عليه ...
أكيد أن علي سيمضي مع حقيبة العظام إلى مكان آمن يدفنها فيه، و لا أحد غيره يعرف الطريق إليه. وقد يسمع هو وحده إحدى أغاني الأم التي ضاع رأسها في تلك الغاية ...
2007







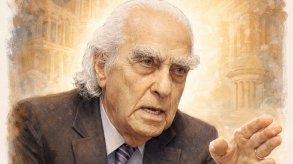

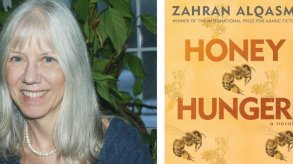

التعليقات