رغم أني أعيش في القرن الحادي والعشرين، إلا أني رجل إغريقي الهوى : يؤمن بأن السعادة الحقة تأتي فقط من طريق المعرفة، المعرفة بكل دروبها ومجاهيلها الغامضة. لذلك تروق لي فكرة قطع الخيوط مع العالم، أحياناً، والاكتفاء بقراءة الكتب، مصدر المعرفة. فالحق أن هذه القراءة المفتوحة لا النهائية، توفر لي ما لا يمكن أن توفره خبرتي البسيطة والمحدودة مهما تنوّعت بالعالم. فالعمر، عمر الفرد منا، جد قصير، مهما طال. ونحن بالكتب، نضيف إلى أعمارنا وخبراتنا، عوالم وحيوات مضافة، أحياناً لا يحصيها عد ولا عدد. وأظن أن هذه الفكرة، فكرة قطع الخيوط، ليست جديدة على عالم المثقفين، بل هي حلم قديم، لا أشك أنه راود كل مثقف، في مرحلة ما من حياته. حلم العزلة، والاكتفاء من هذا العالم الظالم، بأفضل ما أنتجه كبار أدبائه وفلاسفته وعلمائه وموسيقييه، كزاد يومي، أين منه زادنا المادي الفقير.
إنني أحيا، منذ ولدتُ، في أرض صراعات. أرض استنفدت روحي، وأنهكت جسدي. ولما كان الخروج منها، متعذراً، فقد وجدت ملاذي في الكتب. ملاذ هو الأنسب لي، أنا المحاط بزنزانة أسمها أرض فلسطين، وببشر لا يعرفون من الحياة إلا جانبها القاسي المظلم.
بيد أنه من الإجحاف حصر المسألة في أسباب كهذه فحسب. فالحق أن كل مثقف، علماني وحالم، سيجد نفسه، في لحظة ما من العمر الذاهب، وقد ضاق ببلده وضاقت بلده به. حتى ليبدو هذا الأمر كقانون غير مكتوب، لكنه شبه حتمي، يقع تحت طائلته معظم المثقفين. فلا جغرافيا، ولا طوبوغرافيا، مهما كانت، تتسع لأرواح وأحلام المثقفين. لا في عصرنا الحاضر ولا في الأزمنة القديمة.
إن المثقف الحديث، كصنوه المثقف القديم، مطرودُ الأمكنة، إن جاز التعبير. مطرود البلاد، مطرود الفضاءات. وليس ذلك عن ترف فكري، بل عن حاجة روحية حقيقية عميقة. ففي الأخير، وطن المثقف في نصّه، لا في الجغرافيا. في أفكاره التي تتبدل وتتحوّل كل يوم، لا في مدينة أو قرية. وبما أنه ما من نص بشري مكتمل، فإن وطن المثقف، غير منجز ولا مستقر بالنتيجة. عملية تبدو معقدة؟ دون شك. لكنّ الأكثر تعقيداً منها، هو ألا نتفهم حاجة المثقف الحديث، إلى نزوع العزلة، وإلى السفر بجميع أنواعه : الجغرافي منها والفكري إلخ.
قد يتساءل أحدهم، ولماذا المثقف بالذات؟ ولماذا هذا التمييز يختص به المثقف دون غيره من الناس؟ والجواب ليس سهلاً، مع أنه ليس مستحيلاً بالطبع. ومكمن عدم السهولة ها هنا، أن الموضوع مركب، ومتشابك، وليس بسيطاً، كما هو الشأن مثلاً، مع الأطباء أو المهندسين. فهؤلاء يعملون على أشياء مباشرة، ويأخذون جزاءهم المادي والمعنوي، غالباً، دون التباسات أو سوء فهم. أما المثقف، فطبيعة عمله ذاتها، يكتنفها الغموض، لأنها غير مباشرة ولا حسية. بل هي تاريخ من تحوّلات وتراكمات الأفكار، لا يؤتي ثماره، حتى بعد ممات صاحبه، في بعض بل في غالب الأحيان. ولكي أبسّط المسألة، وآتيها من آخرها، أقول بأن المثقف الحديث يتعامل مع أفكار وأحلام. أي مع أمور لا مردود مادياً لها. وغالباً ما تكون بلاده، لأسباب تاريخية عديدة، في غير حاجة لعمله هذا. بل غالباً ما تنظر إليه بعين الشك والريبة، وأحياناً بعين الاستهتار والعداء. لذلك، يمكن تلخيص عمل المثقف عموماً، بأنه عمل من أجل حلم لن يراه. أجل : يعمل المثقف من أجل حلم لن يراه. وتلك ليست من عندنا، بل هي مقولة الألماني هنريش بول. قالها في زمانه ومكانه الأوروبيين، وها نحن ذا نقولها ونعيدها في زماننا ومكاننا العربييْن. أجل. نحن جميعاً نعمل من أجل حلم لن نراه على الأرجح : لن نراه متحققاً في حياتنا. ولن يراه أولادنا ولا أحفادنا كذلك. فنحن، أقصد المثقفين، في واد غير ذي زرع، وشعوبنا في صحراء أخرى أفدح. وكلما سفحنا سهراً وحبراً، زادوا هم تخلفاً ومعاناةً ورجوعاً إلى الوراء. لا بأس ! إنه نوع من مصادفة قدرية، أو تاريخية، لو راق هذا التفسير للآخرين ! هم يدفعون الثمن ونحن ندفعه مضاعفاً مرات. فما يجري عليهم من آلام مادية ومعنوية، يجري علينا نحن أيضاً. ثم يُزاد عليه عبءُ وعينا الشقي وشقاء كوننا مثقفين.
منذ ربع قرن، بلوتُ أشكالاً عدة من الأرق. يمضي أحياناً يومان، بدون أن أذوق ذرة نوم واحدة. إنها حالة شرسة غير إنسانية من الصحو المدمّر. أكون خلالها قد امتلأت وفاض كيلي وقدرتي على احتمال المزيد من ابتذالات الحياة. أكون محبطا تماما من لا جدوى دوري ووظيفتي كمثقف. أقول لنفسي ما قاله آلاف الكتّاب من قبلي، وما سوف يقوله عشرات الآلاف من بعدي، على الأرجح : ما جدوى أن تكون مثقفاً، في دول لا يزال الفقيه فيها هو المؤثر والقائد؟ حقاً ما جدوى ذلك ! إنك، فحسب، وكما لو كنتَ سادياً، تعذّب نفسك وتُلحق بها الأذيين المادي والمعنوي لا أقلّ. فالثقافة، والكتابة كتتويج لها، أشبه بمشروع انتحار ذاتي لكاتبها، في هذه البلاد. ومع ذلك، وهذا هو العزاء الأكبر، العزاء الشخصي الذاتي الحميم _ تظل الكتابة، هي أيضا، الخلاص الذاتي لصاحبها، في ذات الوقت.
في بلاد تعوّدت شعوبُها على دور [ القطيع ] التاريخي، ما أصعب أن يبحث المرء عن صوته الأصيل كفرد. إنه بهذا الصنيع الخطِر، إنما يسبح ضد التيار العام : التيار الهائل الكاسح ذي المرجعيات المحددة بصرامة، والتي لا يمكن الفكاك منها إلا بجهاد ثقافي وبشق النفس المهجوسة بالتمرد. فذلك التيار لا يعيش في عصره وإنما في أزمنة عتيقة غابرة، أُقفلَ قوساها من قبل أن يولد المرء بمئات السنين.
إن أشدّ ما يؤلمني على الصعيد الشخصي والعام، هو رؤية مواطني بلادي، وهم يتصرفون في حياتهم اليومية، وكأنما من منطقة سوء التفاهم، مع حقيقة الوجود وجوهر الحياة البشرية من حولهم.
إنهم ضحايا فهْم ما معيّن للتاريخ، ولكينونتهم وصيرورتهم. فهُم، في الجوهر الثقافي منهم، لا يقبلون الآخر مثلاً. ولن يقبلوه إلا إذا تحوّل إلى صورة فوتي كوبي عنهم. وهذا بالطبع من المستحيل، فضلاً عن أنه مرفوض ومستهجن، ويلحق فقراً فادحاً في معنى الحياة الإنسانية ذاتها.
لقد تعالت في العقود الأخيرة، أصوات كثيرة، تنادي بالدولة الدينية، كنوع من خلاص يوتوبي مؤكد. هذه الأصوات طمّت وعمّت، حتى وصلت إلى أعماق بيوتنا كمثقفين وكتّاب. وحتى تراجع أمامها بعضٌ منا، فأُجبروا على أن ترتدي بناتهم وزوجاتهم النقاب، دون أن يستطيعوا منع ذلك، بالإقناع، أو بشيء قريب منه. ذلك أن ثقافة المجتمع من حولك، هي التي تؤثر، وهي الأقوى، حتى لو ظننتَ عكسَ ذلك.
إنه نوع من نسق ثقافي عام، يجد المثقف العلماني نفسه عاجزاً أو يكاد عن مقاومته، فيجتاح كل أخضر الحياة من حواليه، ويحيله إلى صفرة الموت.
وإني أعيش، في هذه الصفرة المجتاحة، منذ عقدين على الأقل. أحاول أن أتدبّر أموري، وأن أحتفظ بأفكاري لنفسي أو لقرّاء بعيدين، دون أدنى جرأة على إفشائها بين الأقربين مني. فالجو العام يقمع هذه الأفكار والرؤى، ويعاديها بأجهر الأصوات.
من هنا، تزداد حاجتي إلى العزلة، الروحية والجسدية، مع مرور كل يوم. ويزداد شعوري بالغربة والاغتراب، يوماً بعد يوم أيضاً.
قبل أشهر، فرضَ ابنُ أختٍ لي، فرضَ النقاب على أمه، وقد شارفت على الخامسة والخمسين. لم أستطع أن أفعل لها، وهي أختي، شيئاً. الغريب أنها استاءت في البداية، وبعد شهر واحد فقط، صارت [ تُنظّر ] للنقاب وفوائده العميمة !
ترى ما الذي نفعله نحن المثقفون ها هنا !
وهل حقاً، نفعل شيئاً ذا بال، وسط هذا الخراب العميم؟
لا بأس !
سنظل على عهدنا : نمتدح المعرفة ونعاقرها، وبالأخص، لأننا محاطون بمحيطات من الجهل. فالمعرفة وحدها هي من تُحرّر الحيوان البشري، وتجعله إنساناً. ووحدها هي من تُوصل إلى السعادة. أما هؤلاء الناس، فلا بد، قبل أن يصلوا إلى الدروب الموصلة، من أن يدفعوا الثمن. فلقد دفعته شعوبٌ عدة قبلهم، وما يجري على العموم يجري بالتأكيد عليهم.
وإلى أن يأتي ذلك الزمن الجميل : زمن تحررهم من جهلهم وخرافاتهم، سنظل نحن ننزع إلى العزلة، كقرينةٍ للمعرفة، وسنظل نعاقر الكتب، مبتعدين عن إبتذالات الواقع ما أمكن، حتى لو بدا ذلك للبعض، كنوع جبان من الخذلان والهروب.












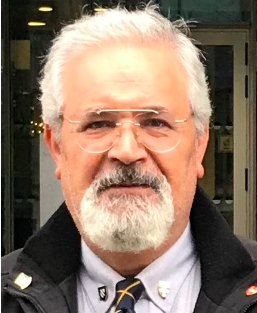














التعليقات