لولا المأخذ أنّ المقال يذهب مذهب الحدّة لكانت صفة المشروع المذكورة لغواً، إلاّ أنّ القوسين يغنياننا من ذلك موضوعياً، وينحياننا من الهفوة وان كانت متصفة بالصواب،لأنّ النظراء لهم قانونهم العام في قراءة ما هو لصيق بالبحث، أو سبل المقال وهي شتى. وهذه الكتابة هي رهينة نظّارة ورقابة الخلائق. (المشروع) هنا كتعريف عام هو دعوى، لا تكلّف لإيجادها في بضاعة الحركات الإسلامية، لمن أراد كشف التكثير المتراكم تاريخياً، وهو ليس بمسكوت عنه. فالحركات والأحزاب والمذاهب والجماعات (وهذا هو التفريق العام الأول يتبعه تفرع متسلسل لا متناه) كلها تتناظر وتتقاتل على صواب/ وأو أصوب الطرق إلى ما هو مبتغى البشرية من خير و سعادة و فوز.
ولكن من لطيف الاتفاق أنها جميعاً رغم هذه المفازة المُهلكة تتشارك بصوت متحدٍ واحد، أنّ الإسلام هو المشروع الشامل لكل الحياة في كلّ زمان وفي كلّ مكان.
والصوت الوحيد هذا هو الفريد الأوحد في أعمال المتعدد السياسي الإسلامي، الذي يقوم متحداً لهنيهة، حتى يُقرع جرس السؤال الثاني: إذن وكيف الطريق لهذا المشروع؟
هنا ينفرط العقد الفريد كسلسلة الخرز ما إن تقطّعت حتى تأخذ كلّ خرزة مذهبها، فيستحيل على الاتحاد المتفتق أساساً لمّzwj; شمل الجموع، وهو كما معلوم في مذاهب البحث العلمي شرط لا مندوحة منه لكلّ جهة تسعى لإثبات ملكيتها لـ (لمشروع) ومعانيه وصفاته. ففاقد الشيء لا يعطيه، والدعاة إلى المشروع يجب توفّر الصفات فيهم ومن أولاها التناسق والانسجام بين الفئة الواحدة. هذا الوضع لا يقف ثابتاً على هذا النحو، فتوابع مهلكة تتوالف باتساع الزمان والمكان كشرط ثابت للرزية الكبرى.
مما لا يخفى على الأعين المجردة والتي لا تكليف على تضلعها / وأو تَمكُنِها من أسباب البحث والدراية، أنّ الشتات الإسلامي قاعدٌ على تناحرٍ محمول في أحشاء هذا الجسد الموصوف، منذ أولّ طلوعٍ، على خلافٍ عظيم، وعلى هرجٍ متسلسلٍ من الأجيال الأولى للجسد ذاك، فأمست الرزية من الثوابت المتكررة، وخلاف ذلك من قاعدة الشواذ. فالتفريق استبطنه (الكيان الإسلامي) في الأيّام الأولى، وفي لحظات وفاة الرسول(ص) حتى استحال بعد ذلك قتالاً لم يُخمد فتيلهُ إلى يومنا هذا.
والحادث الذي قفز من الواقع المريض إلى كينونة هذه الحركات أنها كرّرت عوامل التشتت والتناحر بتواصل، وتتابُع حاملةً طروحاتها ونقائضها في آن، في توليفةٍ كلّفتها آماداً طويلة من استنزاف الطاقات والوسائل والفعلية والمصداقية، ممّا لم تُبق من شروط دعوى (المشروع) وعناصره شيئاً في عالم الأشياء وقيامة المسائل.
و(المشروع) الذي بقي منذ قرون حيّاً ودائماً، هو ولادة الفئات من الفئات كشرائح تنفرد من بعضها البعض لتأخذ أشكالها تخصيصاً، ولكن الذي بقي مصاحباً لهذه الحيوية الدائمة، الدعوة إلى (المشروع) الذي لا يملك عناصر وجوده (حتى الآن) ولا عوامل تُلصقه بالواقع، وهذه الأخيرة من المراتب الدنيا في البحث عن المقبول في غياب الأفضل.
إذن الممانعة على تبصير الوقائع كما هي لا كما تُغلّف بمشيئة مقصودة إنّما ربيبة التهويل التقديسي للكثير مما لا تقبل هوية كينونته أفعال التقدّس علاوة على انتفاء الحاجة إلى ذلك أصلاً.
ومداومة الممانعة شريطة ضرورية ليس لدفع البحث، والتبصير شأواً إلى الوراء فحسب، وإنّما لإبقاء دعوى (المشروع) حيّة، والإيمان بها وبحقانيتها واجباً حملاً على الديمومة المحمولة بنزف. وإن كانت شرائط المتعلقات الضرورية، وشريعة العلائق القانونية لا تقول بذلك، كضرورات المشاهدة والمصادقة فإنّ الديمومة هذه ومن دون تضاد تنتفي بعامل الوقت الذي وحده -على الأقل- يَشهد على خواء الواقع وخلوّه من ملموسات الدعوى، لكن جيوب دعاة (المشروع) تدوم فيها قرينة دائمة للدعوى لا تنفد وهي تعليق شروط حدوث (المشروع) بالإيمان به. ومن هنا يتحول هذه الأطروحة موضوعاً والإنسان من وسائله (خلاف ما يبغيه الإسلام في جعله الإنسان هو الموضوع الأساس) في توليفة مستمرة لا نهاية لمطافها. وفعل الاستغراب هنا ينتصب قائماً ليتسائل عمّا هو مزدوج/ نقيض بين الوسائل المُتبعة لدى أهل (المشروع) من دراية وبحث وجرح وتعديل لتقويم شتى الأديان، والأفكار، والمذاهب، لتفضيل دعواهم بين ما هو قائم/أو مطروح من نُظمٍ وأحزابٍ وأفكارٍ، ولكنه وعلى الطرف الآخر يصطف هؤلاء الأهل في رصيصٍ يَحولُ بيننا وبين الضفتين: (المشروع) نفسه، وتلك الوسائل الضرورات في التنقيب والبحث.
وبما أنّ الدعوى في جلّ الوضع تحتكرُ لباس التمثيل، يصبح أداء الدفاع عن الإسلام كما هو من الهوان في ملابسةٍ مستعصية تجرّعنا أهوالها جميعاً. فـ (الطالبان) في أفغانستان هو الأكثر حضوراً في الإسلامية إلى منزلةٍ يبدو فيها الأوحد الإسلامي بفعل الاحتلال لكل ما هو رمز إلى هذا الانتماء، حيث كان يجلد ويربت على ظهور ووجوه النسوة المنقبات بالخرطوم المطاطي. فالمقارنة، والتحميل، والنقد، والقراءة البصيرة تستحيل هزاءً في هذا التصدع البنيوي القاتل، لا ينفع معه فعل (التجاوز) المُمخرج لاستحالته هو الآخر قاتلاً، ولو بدا هو المفضّل الموضوعي لدى أهل المشروع عموماً، والسلفية/ وأو النصوصيين خصوصا.ً فالتجاوز هو من الأفعال الباطنية المقدسة لدى فئة المشروع التي تحتكر الاجتهاد (الجهد المبذول لتحسين الوضع وتطويره) لصالح زمان معيّن وأناسٍ مُعيّنين. وتخلق بالاجتهاد نفسه (على نطاق معين) شرعية ذلك بتبرير منع الكشّاف عن التاريخ والموضوع، بدفعه خارج دائرة البحث (غير الإسلامي) عن الإسلام نفسه تحت أوصافٍ أقلها الجهل وأعلاها التآمر. ولكن ما أصبح من المرض المقيم في جسم الفئات هذه عدم الاستعداد النفسي لمعرفة المسافة الشاسعة بين لا جدوى الدفاع النظري، وبين الواقع الذي يكرر فعل التأزم.
فإذا كانت الصراعات الإسلامية مع غير المسلمين -الغرب في الأساس- قد طغت على دائرة الموضوع، ومن ثمّ عواقبه من صنع لواقعٍ أليمٍ يعاكس رغبات ومقاصد الحركات الإسلامية كما هو مزعوم، فانّ الصراعات بين المسلمين والمسلمين كانت ذات باسٍ شديد. هل يقول أحد أنّ عمراً، وعثماناً، وعلياً قُتلوا بفعل المؤامرات الخارجية؟ بالطبع لا.
والحسين بن علي لم يُذبح بسيفٍ إنكليزي، أو يهودي، أو هندوسي. والحديث يتغمق إذا جرّت تلابيبه على حقول أموية، وعباسية، وسلجوقية، وأيوبية، وفاطمية، وصفوية، وعثمانية علاوة على فرقٍ ومذاهب تفرّقت عقائدياً لتتخندق وتُعسكر المواجهة في ما بينها. ومن على هذه الشرفة يعتاد الواحد إذا ألهب اندفاعه، رؤية ما لا يروق لأهل (المشروع) سماعه والخوض فيه، مودعين تلابيب ذلك إلى المهوى التاريخي الذي لا يرتد قابلاً على المكاشفة والمسائلة، لأن ذلك من الأفعال الماضية (تلك أمة قد خلت). وما يحيّر الناظر أن (المشروع) القائم لا يملك غير تلك الأفعال الماضية التي تلقي بظلالها على كلّ حركات وسكنات وأنفاس هؤلاء الأهل، وهي كلها محمودة/ وأو تُستحسن إذا بدت أنها من الرذائل.
فالشورى المجلوبة في موازاة الديموقراطية (البضاعة الغربية) ليس لها صنع في مكان أو زمان، ولم تكن الشورى في مداولة الحكم والسلطة شيئاً في عالم الحدوث الفعلي.
فالسقيفة وهي أولى مسارح الاصطدام بالمتطلب الاجتماعي إلى المداولة والسلطة بدت كعملية جرّ الحبل بين فرق متصارعة، حتى انتخب رجل من القوم كبيراً لهم دون سند موضوعي، وأودع الأمر فيه، ما لبث حتى استرده من الذي أهدى إليه الأمر بعد أن مضى الأول إلى ربّه. ومما لا يُحمل محمل الظن الخبيث كما يومئ صاحب (الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة) أن ثاني الخلفاء، أودع الأمر كالكرة وبوصية إلى ثالثهم بامتياز واحد منهم ممثلاً عن الأمة، ونزلت بعد ذلك كرة هذه السلطة حتى ارتطمت بصفوف الفرق المتخندقة، شاهرين سيوفهم ليأخذها كلّ فريق إلى نفسه حتى صاح أحدهم : تلقفوها.
ومضت كرة السلطة تطوف على أمواج دماء القوم، حتى استقرت فرسخاً من الزمان لدى بني أميّة، إلى أن قُبضت من لدن العبّاسيين حمراء من الدم في صيرورة لم تحمل يوماً أفعال الشورى المزعومة لدى أهل (المشروع).
والأمر هنا ليس له من قرار، فشخوص الزمان كلهم نجباء التاريخ على ذمة قراءة الحركة الإسلامية. ومن تتبَّع هفواتهم وزلّاتهم فهو واحد من اثنين:
الأول، كذاب أشِر يبغي الفساد بتشييع الملفّقات بين الخلائق. والثاني، مريض النفس لا يلتصق إلا بما هو جلّاب لعساكر المرض والفتنة التي تهلك مقاصد الحياة والشريعة (القانون).
إن الموضوع لا يستكين من الإلحاح حيث دعوى (المشروع) قائمة تمضي على اثنين، فالحركات الإسلامية تكفّر كل فرقة من الناس لا تدعوا إلى الاحتكام إلى شرع الله. والاحتكام هنا هو المبهَم الموضوعي لا يملك أوصافاً ولا شروحاً ولا تصانيف (كما تظهر جليّة في الدعوى) لأن القانون وهو متطلب اجتماعي لصيق بالزمان والمكان، وهو نتيجة حركة الناس في واقعهم، يمضي اليوم بين عظيم المتغير في طرق الحياة، ووسائلها وإمكاناتها ومقاديرها. وبما أن الله سبحانه لم يشأ تفصيل سبيل الناس إليه، تاركاً لهم أمور معيشتهم لمدى تحسين عقولهم، ومقدرتها على إجتراح المصالح، والحسنات التي تدر عليهم رغيد العيش، فقد بلغ رسول الله (ص) : أنتم أعلم بأمور دنياكم. والعلم هذا القرين بالعقل، والأخذ بأسباب الحسن المنطقي، والمصلحة المتفقة بإجماع الخلائق، لهو من أفقر العناصر في تاريخ المسلمين غير الشوروي (من الشورى)، والذي سبق ذكره، وذكر أسماء المتداولين له. وتختص الحركة الإسلامية المعاصرة بعملية الممانعة على الشورى، جعلت من كلّ قائمة لها تشطيراً تلد منه حركات جديدة لا شوروية لا تقوم إلّا على الاستبداد (بملاحظة الحركات الإسلامية في كل بلاد الأرض). والقصد هنا أنّ الشورى لا تجد لها سبيلاً في النظم والمراتب داخل الحركة الإسلامية. وفي غفلة من الناس أجمعين تستند الحركة الإسلامية مراراً وتكراراً على المتكأ التاريخي غير القائم بما أنزله الله سبحانه في دعوى (المشروع) . وبما أن الحركة نفسها تعلم أن هذا الاستناد يتعارض مع مضمون الشريعة ومقاصدها إذا جلبت رسومها وتفاصيلها، فهي لا تبيّن ذلك تاركة إيّاها للمكاشفة الفردية التي تُتهم في العاقبة بفعل الاعتزال -المصطلح التاريخي- عن الأمة، وموالاة الكفر وأتباعه لضرب الحصون (المنيعة) للمسلمين. وفي هذه المحطة تنزل الحركة الإسلامية مرتبة من دعواها لتسلك سلوكاً دنيوياً في الدفاع عن الدعوى، باستقدام المقارنة (وهي هنا فعلٌ عَلماني غير مستند على نص أو قائم ديني) بين (رذائل الديموقراطية) وفضائل الدين الإسلامي الذي يستبطن المذموم تجاه القياس المُشرعن القائل بالحكم الإلهي. فالمقارنة هنا باطلة لا يتسع لها الموضوعي من البحث في استكشاف العناصر، بالتوسل على أسباب العلم المحمود لدى الحركة الإسلامية، وغيرها من مجاميع البشر. فـ (محمد الفاتح) السلطان الإسلامي العثماني الذي كان ماضياً على قانون لم يكن بغير ما أبلغه النص الإسلامي فحسب، وإنما صانعاً موقع التضاد، والتعاكس مع السبيل الإلهي، ليس على مستوى النقاش، أو التفضيل، أو المباخسة فكراً ونهجاً وإنما لحرمته في الجرم بحق الإجتماع العام؛ هو أحد رموز الإسلاميين المعاصرين، المحمودين، المستَنَدين عليهم في افتخارٍ يزيّن دعوى (المشروع) في كلّ خطاب وفي كلّ محفل، وقد قيل في ذمته حديث يُنمى إلى الرسول (ص) : (لتُفتحنّ القسطنطينية فنعم الأميرُ أميرها ونعم الجيش جيشها ولو كنت في ذلك الزمان لقاتلت تحت رايته) وهو محمد الفاتح الذي فتح المدينة المذكورة في عام 1453م. لكن الفاتح العثماني وصل عرشه بفعل العُرف (ولهذا قانونه غير الإلهي) المشير إلى جواز قتل السلطان للاخوة والأقارب خشية فتنة النزاع. وبما أن العرف يجد له سبيلاً في المشرعن الفقهي لاحقاً يحمل معه فرصة التفادي من الحرج القائم، فان فاتحاً لم يقف عند هذا الحدّ، وإنما تخطاه وتخطى أعظم حرمة إلهية (ألحا كمية) ليس باجتهادٍ عقلي في مصالح العامة (كما تفعل الديموقراطية)، بل حولّ العرف (الجريمة هنا) إلى قانون مدوّن (أي مُعَلمن-عَلماني) عمل به في (دولته الإسلامية) حتى ألفاظها الأخيرة. وإن الخليفة الذي نابه في العرش، وهو محمد الثالث فقد نزل منزلة العامل بهذا الحكم، فلم يُلجم التحذير الإلهي بعواقب من قَتل دون وجه حقٍ رغبته الظالمة، فهاجر النص الإلهي إلى النص البشري وذبحَ تسعة عشر إنساناً من إخوانه في الدم واللحم، لاستبطان الإشارة التي وردت في نص الفاتح إلى النزاع على السلطة، وهو الملموس الأشهر، والأهم في تاريخ المسلمين والذي ينقض الشورى/ وأو المشاركة الخلقية في صنع السلطة المأمورة بأمر الله، والتي تسمى بالديموقراطية في بلاد الغرب.
ومحمد الثالث لم يفعل مذبحته من فراغ، فأخوه الفاتح الثاني سبقه إلى ذلك بقتل أخيه الرضيع في المهد لا يعرف شيئاً من أمور السلطة والقانون. هذه التوليفة مسكوت عنها في أدبيات الحركة الإسلامية، والصارخ الواضح هو فضيحة السلطة، والمذابح في أوروبا المسيحية، قبل أن تتفق على فض النزاع بصناديق الاقتراع التي تحمل رغبة الجامعة الخلقية. وبما أن الحركة الإسلامية تحمدُ هذه الفضيلة (نزولاً عند الرغبة في الإمساك بزمام السلطة!)، فضيلة مشاركة الناس في انتخاب هيئة الحكم، تقوم عالية الصوت: وللمسلمين انتخابات كانت تجري في السقيفة. تلك السقيفة التي ذكرناها كيف فض النزاع إلى التنصيب الذي فتح الباب أمام المذابح.
ولو أن همّ الناس ليس تتبع أفعال وتاريخ وسياسة الحركات الإسلامية، بل الانصراف إلى اللحاق بموكب السيرورة الحياتية، إلا أن السؤال عن أحوالها الآنية، وتقاسم السلطة والحكم في ما بينها، يقوم منتصباً يشحذ بعض التطبيق الإلهي/ وأو حتى الانتخابي البشري، فلا يجد إلا أن الجاري من الحركة الإسلامية يمكث ساكناً جامداً يبحث هو نفسه عن مخرج إلهي /وأو بشري - في أغلب الأحوال- لمأزقها في توزيع المراتب والأحكام، ودائماً فإن فعل التشظي والإنشطار هو حلّال مشاكلها وأزماتها. فالحركات الإسلامية في كُردستان والجزائر ومصر والسودان واليمن ولبنان وافغانستان وباكستان، وفي أرجاء المعمورة تقاتلت وتضاربت وتناقضت وتخالفت. وكلّ هذه الحركات لم تعط شيئاً لمجتمعاتها الخلقية من أسباب، ووسائل التمكين من الحياة السليمة الآمنة (وهي من مقاصد الشرع الإلهي ليتفرغ الخلق إلى عبادة الله عزّ وجل في اطمئنان وأمن) فأصبحت وأمست أجزاءً في جسم النزاع والخراب والدمار: لم تجلب للجوع غير القحط، وللهرج غير قناة الدم، وللخراب غير الخراب.
فالجوع والخوف والهرج والارتداد على صيرورة الحياة (التي أبلغت بمجتمعات شمالية- أوروبية من مذهب الديموقراطية، مبالغ من العظمة الدنيوية ما لم يفقدها العدل والإنصاف والحسن الأخلاقي الاجتماعي الذي نحتمي به نحن الفارّون، وكذلك أهل (المشروع) حين تضيق بهم سبل النجاة) جعلت من شعوب الإسلام مجاميع تتوسل على أسباب البقاء في حالٍ لا تحمل بأي شرط عوامل الجدال على ما هو أفضل في البقاء الإلهي أم البشري لأنها لا تملك في كلتا الحالين أسباب التأهيل ولا الموضوع يتّسع لها، لانتفاء قانون السبب القرين بالمجتمعات الباحثة عن التحسين والإحسان. فالباحثون عن الخبز والأمن لا ينفعهم الخطاب النظري في تمجيد التاريخ البشري بهالات التقديس الديني، وهو تاريخ في جلّه غير محمود باتباع تفاصيله واستخراج قوائم بنيانه فكراً وحكماًً.
الحركات الإسلامية اليوم تبحث لها عن مأوى بين مجتمعاتها، غير ميّالة عن نزاعاتها وتفرقاتها وتوسلاتها في شتى الطرق الدينية والبشرية، من قوة وسلطة وديموقراطية. الذين يفكرون بعقولهم يدركون كنه العجز في دعوى الحركة الإسلامية امتلاكها لـ (لمشروع). ولو كان ذلك صحيحاً لوجدت سبيلاً لفض نزاعاتها وتهالكاتها وعجزها. إن قبلت الحركات الإسلامية أم لا، فإن زخم الصيرورة الحياتية الجارية ينطق ضمناً بالوداع: للمزعوم (مشروع) الحركات الإسلامية.
- آخر تحديث :







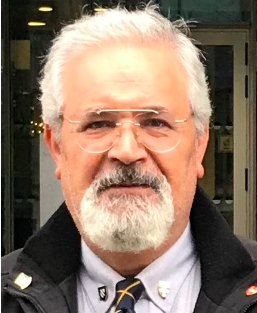













التعليقات