أثينا، مدينة أخرى من المدن التي عرفتُها على دروب المشاة. عندما تقول ذلك فإنَّك تعني أنَّك عرفتَ حاراتِها، وشوارعَها، ونوافذَ البيوت التي تمنح للمارة الغرباء مشاهدَ الورودِ المزروعة، وترسل من حولهم روائح الحبق.
وعندما تكبر قليلاً وتقلّلُ من العودة إلى أثينا، ينعدمُ عبقُ الحبق، وتتحوَّل زهورُ النوافذِ إلى ذكريات.
وشيئاً فشيئاً تنسَى أسماءَ الشوارع، وكلَّما كبرتَ تفقد الشغفَ في الإصغاء إلى الموسيقى الآتية من جميع الأمكنة، وكأنَّك لم تعد تعرفُها ولا تعرفك.
العلاقةُ بالمدن على الأقدامِ غيرُها على عجلات.
وأجملُ تلك العلاقاتِ بالنسبة إليَّ في الحافلة الكهربائية التي عرفناها صغاراً في بيروت. فالحافلةُ تزدحمُ بالناس، وترمي بينهم الألفة، وتحوّلهم إلى رفاقٍ وأصدقاء، ولو أنَّ الحوارَ الوحيدَ بينهم حوارُ العيونِ والوجوه.
كما أحببت الترامَ في لشبونة. أحببتُه بقدر ما أحببتُ لشبونة، وصوت أماليا رودريجيش، التي كنت أحبُّها ذاتَ زمن أكثرَ من فيروز، لكنَّ العيبَ والحياءَ وعشرةَ الخبز والملح حالت دونَ هذا الشَّططِ غيرِ المعقول، ولا أزال أحنُّ إلى أماليا وإلى ألحانِ الفادوا التي –مع الاعتذار- هي أجمل من القرويات اللبنانيات وأدواتهن الموسيقية المحدودة.
ولكلّ مدينةٍ أداة، سيدتها، البوزوكية اليونانية التي رقصَ على أنغامها البحَّار زوربا، سيد اللامبالاة والتسكعِ الجميل في مرافئ البلاد.
كلَّما تتقدَّم في السن ينقص عددُ أصدقائِك في المدن. لم يعد لي أحدٌ في أثينا اليوم. لا في مقاهي ساحة الدستوه ولا في مطاعم تلة «البلاطة» الشعبية. ولم أعدْ أذكر أسماءَ الشوارع. وما حاجة لذلك في أي حال، فقد فقدتُ الهمةَ في السَّفر حتى من أجل الاستعاداتِ الباهتة.
وحتماً لم تعدِ المدينةُ تذكرني في أي حال، أو تنتظرني، أو يعني لها شيء أنني فقدت كلَّ علاقة معها.
فقد تحولت مع الزمن إلى مشّاء محترف، لا تعني لي الأسماء والحدائق شيئاً. وصار كل حلمي من الدروب أن أعود إلى لندن وأتفقد مفترقاتها على مداخل الحدائق، وأمر بمكتبة «ووتر ستون» بحثاً عن آخر ما وصل إليها من كتب. ويبدو أن العلاقة السليمة الوحيدة مما تبقى لي هي العلاقة مع الكتب. فأصدقائي أيضاً تقدموا في السن، وفقدنا بدورنا أصدقاء مشتركين، واهتمامات مشتركة، ولم نعد نضحك للنكات ذاتها، ولا نطرب للألحان نفسها، أو حتى نرغب في الاستماع إليها.
وكل ما يحول إلى كتاب، أو مقال، لا يعول عليه.

















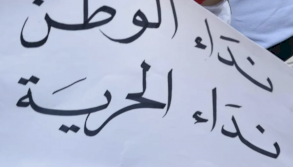



التعليقات