قبل يومين مرّت الذكرى الحادية والخمسون لوفاة عميد الأدب العربي طه حسين. ومثله لا نحتاج لمرور ذكرى ميلاده أو ذكرى وفاته لنقف أمام منجزه الفكري والأدبي والأكاديمي، والأثر الذي تركه في بنية الفكر العربي بإثارته أسئلة غير مسبوقة، وكان له من المؤلفات ما أثار حملات ضده، حدّ تقديمه للمحاكمة، كما هي الحال مع كتابه «في الشعر الجاهلي»، رغم أن القاضي، يومها، ارتأى حفظ القضية إدارياً وعدم تقرير أي عقوبة بحق الرجل، في موقف مشرف في تاريخ القضاء المصري، وكان للهزة التي أحدثها الكتاب أثر في إعادة النظر فيما كانت تعدّ مسلمات أو بديهيات جرى توارثها، دون إخضاعها للمساءلة، فلدى طه حسين جرأة على منازلة أي فكرة يراها خاطئة، رغم علمه المسبق بأن ذلك قد يؤلب عليه الحملات، وهذا دأب كبار المفكرين الذين نذروا فكرهم لكسر حال الجمود في تطوّر أممهم، وإزالة ما تراكم من تخثر في شرايين الفكر.
كتاب آخر لطه حسين لا يقلّ أهمية، هو «مستقبل الثقافة في مصر» الذي قدّم مقاربة مختلفة للثقافة والتعليم، فحين ابتعثته وزارة المعارف المصرية، في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين لتمثيلها في مؤتمر اللجان الوطنية للتعاون الفكري وفي مؤتمر التعليم العالي اللذين عُقدا في باريس، فشهد المؤتمرين وكذلك مؤتمرات أخرى عقدت هناك في الفترة ذاتها ناقشت الثقافة من بعض أنحائها، فسمع فيها آراء أثارت في نفسه، على ما يقول، خواطر وعواطف وآمالاً، فمَنّى نفسه بأن ينتهز فرصة ذلك لتدوين ذلك، فلم يلجأ إلى كتابة تقرير منمق عن المهمة التي ابتعث إليها، وإنما عكف على كتابة الكتاب فأنجزه بعد عام واحد فقط، راسماً فيه خريطة طريق، ما انفكت الحاجة تزداد إليها حتى اللحظة، لا لمصر وحدها، وإنما للعالم العربي كله.
بعد صدور الكتاب، في عام 1938، جُوبه طه حسين بحملة شعواء من الكائدين، زعموا فيها أنه تنكّر لعروبة مصر، ومن يقرأ الكتاب بعناية سيكشف زيف هذا الادعاء، فانطلاقه من أن مصر متوسطية أقرب إلى أوروبا منها إلى اليابان أو الصين لا ينطوي على نفي عروبتها، هو الذي قال في ثنايا الكتاب إن مصر تلقت الإسلام «لقاءً حسناً، وأسرعت إليه إسراعاً شديداً، فاتخذته لها ديناً، واتخذت لغته العربية لها لغة»، وفي مكان آخر من الكتاب أشار إلى اتصال العقل المصري بأقطار الشرق القريب: فلسطين وبلاد الشام والعراق اتصالاً منظماً مؤثراً ومتأثراً بها، كما اتصل بالعقل اليوناني منذ عصوره الأولى، وفي خاتمة الكتاب حثّ العميد بلاده مصر على أن تضطلع بما وصفه ب«واجبها» نحو الأقطار العربية، فتكون «مشرق النور لما حولها من أقطار».







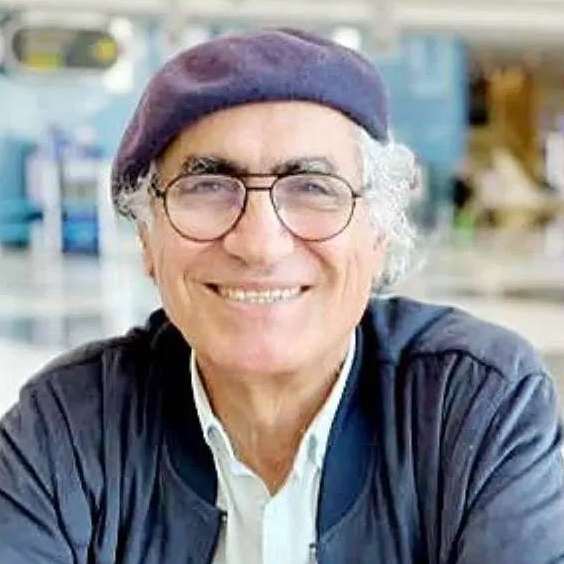











التعليقات