قصيدة النثر، حاضرة باستمرار في تفكير خزعل الماجدي وفي نظرته المستقبلية إلى تطور الشعر العربي، وهو لا يتردد من طرحها في كلّ مناسبة ثقافية، على أنها النموذج الذي يدفع هذا الشعر باتجاه تحقيق الاندماج الكلي بواقع الإنسان وبواقع الثقافة. وبغض النظر عن كونها ( قصيدة نثر) أو ( نصاً مفتوحاً)، فهي عنده تملك من المزايا الجمالية ما يؤهلها للعب هذا الدور في حياة الأدب العراقي المعاصر. وعندئذ ليس من المستغرب أنْ يرسم صورة كاريكاتورية لعملية التحول من قصيدة التفعيلة إلى قصيدة النثر، فيقول: لم تتحقق ثورة الحقيقة إلا عندما ترك الشعر أسطوله الموسيقي الجبار ومعداته البلاغية الإطنابية ونزل يخوض داخل النثر يأخذ منه الإيقاعات الصغيرة التي لا تنتهي والمواضيع البسيطة التي تخفي داخل أمواجها كسر المطلق وتوترات الوجود. وزبدة ما حققته قصيدة النثر بحسب زعم خزعل الماجدي، هو أنها هجرت ( الأسطول الموسيقي الجبار) و( المعدات البلاغية)، باتجاه ( الإيقاعات الصغيرة والمواضيع البسيطة). غير أنّ الناظر في تاريخ هذا النموذج الشعري بالعراق على وجه الخصوص؛ أعني الشعر صاحب ( الأسطول الموسيقي الجبار، والمعدّات البلاغية) مقارنة بالنموذج الآخر المتمثل بقصيدة النثر أو النصّ المفتوح، سوف ينتهي إلى نتيجة مفادها أنّ النموذج الأول كان على صلة بواقع الثقافة العراقية وبمشكلاتها الأساسية، وكذلك على صلة بالصراع الوجودي للإنسان العراقي وقدّم صورة عن طبيعة المجتمع العراقي وتحولاته الجوهرية على صعيد السياسة والاقتصاد والثقافة والأعراف. وصارت القصائد والنصوص التي كتبها الزهاوي والرصافي وعلي الشرقي والشبيبي والجواهري وحسين مردان ونازك الملائكة والسياب والبياتي ومحمود البريكان وبلند الحيدري وحسب الشيخ جعفر، عصب التحولات التي طرأت على المجتمع العراقي، وخزانة لـ ( انتيكات فكرية) تكشف عن الرؤية التي اشترك فيها هذا المجتمع في الصراع التاريخي المحتدم الذي طبع تاريخ العراق الحديث. وعلى الرغم من أنني أنحاز تماماً إلى نموذج قصيدة النثر أو النصّ المفتوح إلا أنّ معظم النماذج العراقية مقارنة بالنماذج العربية لا تحوز على الشروط التي تجعلها وثيقة فاعلة في تاريخ الثقافة العراقية المعاصرة. وظلت قصيدة النثر منذ السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، غير قادرة على إنتاج نماذج شعرية شبيهة بـ ( النهر والموت، والمومس العمياء، وحفار القبور، ومجنون عائشة، وعين الشمس، وقمر شيراز، وحارس الفنار، والتصحّر، وقارة سابعة، والرباعية الأولى، والرباعية الثانية، والطائر الخشبي، والأخضر بن يوسف، وشجر إيثاكا، ونشيد اوروك...). ويعلم القارئ أنّ هذه النصوص، تنطوي على مجموعة من الإشكاليات الثقافية والتاريخية، النابعة من صميم الصراع الاجتماعي الانطولوجي في مرحلة زمنية معينة، حاضرة بقوة هي والمكان في هذه النصوص التي لا تمحى من ذاكرة القارئ بسهولة. إنّ الشاعر العراقي في هذه العقود الثلاثة، يتعامل مع جمهور القراء على أنهم كائنات غير مقيدة بقيود تاريخية أو جغرافية، إنما كائنات خرافية بوسعها أنْ تتحوّل من طور إلى طور آخر بالسرعة التي تسمح لهم أنْ يفهموا هذه التشكلات الشعرية الغرائبية، ويتعامل مع الموروث الثقافي والشعري على أساس جملة من المفاهيم المحرّفة عن دلالاتها الأصلية، أو المفهومة بشكل مغلوط. وفي جلسة خاصة جمعتني بأدونيس والنحاتة المعروفة منى السعودي، تساءل عن أسباب ( عقم القصيدة العراقية المكتوبة في هذه العقود الثلاثة)، وكان تساؤله تساؤل المنتظر الشغوف بآخر فتوحات الشعرية العراقية التي اعتاد الشعراء العرب أنْ يكونوا تلامذتها الأوفياء. إنّ قيمة رأي هذا الشاعر الكبير، تأتي من خلال قراءته الدقيقة للمشهد الشعري بالعراق في هذه العقود الثلاثة. لقد كان مفهوم عقم القصيدة الذي تحدثنا فيه، يتجه مباشرة إلى مسألة أساسية هي أنّ هذه القصيدة تحيا خارج التاريخ العراقي الساخن، مثلما تحيا خارج التاريخ الثقافي السائد لا رغبة في تغييره إنما رغبة في الهرب من إشكالياته الجوهرية وأسئلته الوجودية.
إنّ الشعر العراقي يمرّ بأزمة معرفية حقيقية، لا أزمة جمالية، فالشعر عبر تاريخه الطويل لم يمر بأزمة جمالية خالصة، إنما الأزمة الحقيقية هي أزمة وعي بالكيفيات التي يصبح فيها الشعر يسكن في العصب المهتاج للواقع التاريخي الملبّد بغيوم التغيير، وبسبب ذلك كان الشعر في العصور العربية المظلمة يمارس نشاطاً جمالياً متميّزاً لكنه كان بعيداً عن تصوير الإشكالية التاريخية، وكان يمسّ ظهر الواقع مسّاً مبتهجاً بالفتوحات الجمالية المتمثلة بزخارف بلاغية فاقعة الألوان، ومن هنا كان شعر هذه الحقبة يحيا خارج اللحظة التاريخية.
قبل أنْ نقرأ ما كُتِبَ عن الشعر، يتعيّن علينا أنْ نقرأ الشعر نفسه؛ بمعنى آخر أنْ يداهم الشعر حسّاسيتنا الثقافية، ويشاكس ذاكرتنا الشعرية التي تربينا على ثمراتها لعقود طويلة، ويورطنا في مشروعية مشروعه الجمالي، نقرأ ذواتنا وهي تطوف في صوره ومجازاته، يقتبس موسيقانا ليعيدها إلينا على نحو آسر كأنها غريبة عنّا.
يشدّد صديقنا ( الشاعر المبدع حقيقة لا مجازاً) خزعل الماجدي على أنّ قصيدة النثر باتت ( تأخذ مادتها من النثر حيث البساطة والمواضيع العادية والإيقاع البلاغي البسيط بدلاً من الإيقاع الموسيقي الصارم وترك الأسلوبية الفخمة المتعمدة)، بيد أنّ من يقرأ المتون الناضجة لهذه القصيدة بالعراق سيكون أمام متون ( متعالية) بالمعنى الفنومينولوجي للمتعالي، إذْ لا يتّجه الوصف عادة إلى الجوهر الحقيقي لموضوع الظاهرة، إنما ما ينطبع منها في الشعور وما يمكن بعد ذلك تشييد منظومة رمزية منه، وهذا ما يفسّر لنا المرجعية الظاهراتية لقصيدة النثر ومن ثم النصّ المفتوح الذي ينّظر له الآن خزعل الماجدي، على الرغم من أنّ انفتاح الأجناس على بعضها مسألة باتت تشغل حيّزاً في الأدب العربي منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وفي ظلّ الحضور الطاغي لهذه المرجعية الثقافية، التي لا تلبث أنْ تغذّي بقوة جذور القطيعة مع كلّ نموذج قبلي يشكّل ثباتاً في المنظومة الثقافية الجمعية سواء في اللغة أو البلاغة أو الموسيقى، يتشكّل ( النصّ المفتوح) ليتجانس مع مرحلة تاريخية جديدة تستند إلى قطيعة كلية مع قيم المرحلة السابقة سياسياً واقتصادياً وثقافياً. ولعلّ هذا ما يسوِّغ لنا أنْ نطلق على ( النصّ المفتوح) نعوتاً عدّة، من بينها أنه ( نصّ لا مرجعيّ)، وهو من أكثر النعوت الملاصقة لموصوفها. فما بين هذا النصّ والإشارة إلى خارج يمكن تحديده، ثمة تنافر دائم، ومقصود أيضاً.
إنّ دراسة تعاقبية لـ ( المرجع) في القصيدة العربية قديماً وحديثاً، تكشف عن تحوّل جذري في ستراتيجية هذا المرجع بين ( الحضور الكلي)، و( الحضور الشفيف)، و(الحضور المقطوع). وإذْ يتجلى النمط الأول في كلّ تراث العرب من الشعر العمودي منذ الجاهلية ما عدا الشعر الصوفي الذي استبدل ( الحضور الرمزي) محلّ ( الحضور الكلي)، فإنّ النمط الثاني يتجلى في ( شعر التفعيلة) الذي محافظاً على العلاقة بين الشعر والواقع بطرائق متفاوتة. أما النمط الثالث، فهو نزوع متطرف لقطع الصلة بين اللغة وسياقاتها الدلالية المحتملة. في النمط الأول، تطغى أسماء الأماكن والأشخاص والوقائع الحقيقية، والمثول الوضعي للكلمات في اللغة الشعرية، والصور اللاحقة التي تنسلّ عن الصور السابقة، والمعنى الذي يولد من رحم الاحتمال لا من رحم المستحيل، والتعبير عن الفردي والشخصي والمحلي والواقعي والأرضي، لا التعبير عن الكلي والمطلق والميتافيزيقي والباطني واللامنطقي والسريالي والفوضوي.
في النمط الثاني، تبنى الجملة على أساس مرجعي ثم تبتعد عنه شيئاً فشيئاً، كما في[ عيناك(مرحع حقيقي) ...غايتا نخيل ... ساعة السحر].
في النمط الثالث، تدمر الجملة كلّ الأسس المرجعية، وتجعل القارئ يقف بلا ذاكرة، وينشئ مايريد قوله من الجملة الواحدة نفسها. وكلما أراد أن يضمّ الجمل إلى بعضها في سلسلة واحدة، خاب سعيه.
هوامش:
1ـ الوقفة العروضية والوقفة الدلالية.
2ـ عدم قدرة الإستعارة أو المجاز أو عناصر الصورة مجتمعة على استمرارية ضمان الإثارة الشعرية المطلوبة، فتم تحول إلى خلق الصورة بأساليب أخرى وعناصر جديدة كالسرد والحكي والإيماء والايحاء والتمسك بفكرة (نقص الصورة)، وكذلك الصورة الذهنية وليس البلاغية.
3ـ ليس بوسعنا القبول بالتقسيم الرباعي للشعرية العربية العمودي، التفعيلة، النثر، النص المفتوح، بل إن التقسيم هو: العمودي، التفعيلة، النثر، لكنّ الذائقة العربية غير مستعدة لقبول هذا التحول فتم من العمودي الكلاسيكي إلى التفعيلة وظلت هذه البقايا الكلاسيكية عائقاً أمام تطور القصيدة العربية، لأنّ الوقفة العروضية وصراعها مع الوقفة الدلالية أدى إلى عدم اكتمال مشروع الحداثة من جهة، وإلى عدم اتضاح الرسالة الشعرية في الشعر نفسه، ومن هنا جاء التحول الثالث وهو قصيدة النثر، وكان حقّه أن يكون التحول الثاني.
انقر على ما يهمك:
عالم الأدب ملف قصيدة النثر مسرح قص شعر الفن السابع مكتبة إيلاف





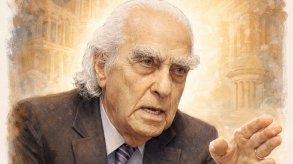

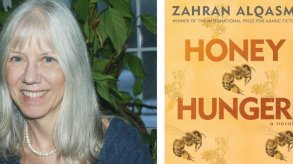

التعليقات