إيلاف من لندن: اليوم، مررتُ بشارع خلفي في حي عشوائي، أبرز معالمه مدرسة ابتدائية تشغل مبنى مستأجراً، ومكتوب على فنائه الخارجي: "الوطنية شعورٌ صادق". المدرسة ابتدائية كما أشرتُ، أي أنها تعنى برعاية الطفولة وبتربية الأطفال، تعنى بالوعي الجديد للكائن الطفل، وعيٌ جديد لموجودات سابقة، أهمها، في بلاد العالم القديم، مصطلح "الوطنية"، ثم يأتي هذا المصطلح موصوفاً بأنه شعورٌ، فالوطنية شعور وليست فكرة تعاقدية، لأنها فكرة تدار بلا حقوق وبلا واجبات، ما جعلني أعود بالذاكرة إلى فحص دقيق حول المفردة في الدول العربية، وحتى في كافة دول العالم الثالث، لأفتش فيها عن معنى يخرج مفردة الوطنية من الشعور إلى الحقوق والواجبات، ويخرج بها إلى علاقة تعاقدية ما، لكنني لم أجد. ثم إن تلك المفردة، إلى كونها شعوراً مبهماً، فإنها تأتي لتتصف بالصدق!. الصدق الذي لا علاقة له بالشعور داخل إطاره المحايد، فالصدق لا يحمل معنى حين يرتبط بالمشاعر المبهمة إلا معنى واحداً هو أن يلغيها، لأنَّ المشاعر إن لم توصف فإنها ليست محايدة، فإن كانت محايدة فهي غير موجودة.
هذه العبارة التي اعترضتْ صباحي، أعادتني إلى كتاب السويدي خلف علي الخلف "لنكتب عن السويد"، الصادر حديثاً عن دار جدار للثقافة والنشر – الإسكندرية، مالمو، فالكتاب يتحدث عن قيم يتم تفريغها من محتواها من خلال الممارسات القانونية، ويتم تحويلها لخدمة مصالح الأفراد من خلال إعلانات حقوق الإنسان، ويتم توظيفها للقمع من خلال ضبط العلاقات في فضاء من الخُواء: "السويديون لا يستخدمون التعابير السلبية. فقد تسمعها الغابات وتكف عن الغناء. (...) على سبيل المثال؛ هناك قطار سويدي بطيء بطيء بطيء.. أظنه أبطأ قطار في العالم، يسمونه القطار اللطيف!" (ص59).
ازدواجية المعايير
ما دوَّنه خلف علي الخلف في يومياته حول السويد الذي يتجاوز في ممارسات ما تفعله الديكتاتوريات في العالم القديم بمراحل متقدمة، يضعنا أمام خطورة الوعي الإنساني بالتزييف المنظّم والمخدوم إعلامياً، فأنت في السويد ضحية مؤكدة لا يرى أحد ما تعانيه، ولا تستطيع المقاومة، قد تقاوم ديكتاتوريات الشرق وتبرر ما تقوم به، لكنك في السويد تُنتهك في منطقة غير مصنّفة ولا مرئية، فيذهب حقك في النضال: "السويدي شخص لطيف جداً، يبتسم في وجهك دائماً، حتى وهو يطعنك في ظهرك، لا يتخلى عن ابتسامته!" (ص63). ثم تأتي رمزية البط في كتاب الخلف لتدل على ازدواجية المعايير حين يتعلق الأمر بعلاقة عكسية بين ما يروجه الإعلام الرسمي وبين ما تتم ممارسته على أرض الواقع: "فجأة؛ ترك السويديون الاهتمام بالبط؛ والأيائل كذلك، ودون إعطاء إشارة؛ دلالة على الانعطاف، انتقلوا للخطابة في قضية اللاجئين" (ص77). فالبط، ورمزيته الهامة في كتاب الخلف، يتحول إلى أداة إدانة مرعبة يمكن من خلالها مصادرة فئة كاملة من قِبل شعب مزدوج الفكر والمشاعر والسلوك: "صعد الخطيبُ الذي رحب باللاجئين من قبل، دون أناقة تذكر، (...)، قال وهو يغالب الدموع: يا شعبنا العظيم، أيها الشعب المحب للآخرين والسلام، اكتشفنا أن هؤلاء اللاجئين، يأكلون البط" (ص79)، فماذا يترتب على خطاب كهذا في بلد عنصري في حقيقته لا في المبادئ التي يعلنها: "شهقت النساء أولاً، الشهقة التي يتدرب عليها السويديون كحرف من حروف اللغة، شهق الرجال، شهق بعض اللاجئين الذين يشعرون بالاندماج في أدمغتهم. التلفزيونات، الراديو، الصحف، شبكات التواصل، الإذاعات المدرسية، إذاعات القطارات والحافلات... نقلت الخطاب الحزين المشحون بعاطفة مصنعة في مصانع إيريكسون. عمّت البلاد حمّى السخط على اللاجئين لم ينجُ منها حتى الأطفال، الذين اشتروا بمدخراتهم دببة صغيرة للاجئين مصنعة في الصين، قبل فترة قصيرة، فاشتروا دمى ملونة من البط، من الصين أيضاً، وخرجوا بمسيرات مدرسية تطالب بحماية البط من الأشرار" (ص80).
.jpeg)
ثم إن الكاتب، وهو يكتب عن تجربته المرّة في السويد بحياد وشفقة ظاهرة، يركّز على ظاهرة التزييف، تلك التي تضمن وجودها أنظمة يتم تفريغها من بُعد التفاعل الإنساني الطبيعي إلى وجود حقوقي لا علاقة له بالحس الإنساني مطلقاً: "على القادمين الجدد إلى هذه البلاد المتقدمة أن يتعروا من ثيابهم وسحناتهم ولكناتهم وثقافتهم وأديانهم أيضاً؛ وكتمرين صباحي يصرخون مثل صرخة طرزان في الغابات: الاندماج التام حتى في المنام" (ص86). وهي، أي آلية التزييف والخداع، منهجية عمل حكومية تتم من خلال السيطرة على الإعلام الرسمي، وحتى المستقل: "الريح الحكومية في السويد تجعل الكلمات تميل، بالاتجاه الذي تريد" (ص99). والسويد هي الدولة المشرّعة لنظام اجتماعي عنصري قانوي يصعب فضحه: "وصلتُ كوبنهاغن، حيث تمشي العنصرية في الشوارع عارية، دون لصق ابتسامة على وجهها كشقيقتها السويدية" (ص106). والسويد بلد الحريات فيما يتعلق بخارج حدوده فقط: "حاذر أن يدب بك الحماس بعد قراءة قانون حرية التعبير وتنتقد هذي البلاد علناً، (...)، حتى إن كتبت لن يحاسبك أحد، لكنك لن تجد مكاناً لنشره سوى تعليقه على حبل غسيل داخل منزلك الضيق" (ص111). مع ما يرافق هذه الرقابة من عمل تطوعي يقوم به كتّاب سويديون للبحث عن الأفكار غير المرغوب فيها: "يبحثون عن الكتابات الضالة التي تشعر البط بالاكتئاب والمواطن السويدي بالتردد والحيرة. لن يسجنك أحد كما في بلادك المنكوبة، لكنك سترمى في مستنقع العزلة والنسيان ويشطب اسمك الذي من أربعة أرقام من سجل الوجود، هذا كل ما في الأمر" (ص112).
تاجر الموت حلماً للبشرية
وأخيراً، يضعنا الكاتب وجهاً لوجه أمام ثقافة تحترف تزوير الحقائق، وتمارس التضليل كإرث قديم، وكأنها تعلمت من "نوبل" أسلوبها المنهجي في التزييف والخِداع: "هذا هو مقام القداسة على مرمى حجرٍ منا، وهؤلاء هم السويديون، تأملهم جيداً لقد جعلوا من حمل اسم تاجر الموت حلماً للبشرية" (ص122). ففي كتابه الذي صدر منتصف هذا الشهر، كانون الثاني (يناير) 2024، استطاع خلف علي الخلف مساءلة الشعارات الإنسانية والإعلانات الحقوقية والحملات الإعلامية والأفكار المسبقة حول العالم المتحضر، لنقف أمام سؤال يشبه السؤال عن عبارة: "الوطنية شعور صادق"، فمن المستفيد من خلق ثنائية تهدف إلى خلق اللَّبس سوى الإنسان؟ الإنسان الذي حتى عندما يصل لمصافّ الآلهة فإنه يفشل دائماً كما يقول إدوارد سعيد، وهو ذاته الإنسان الذي حين يسن القوانين فإنه يوظفها لمصلحته الفردية، فالقانون شكل من أشكال الإكراه الاجتماعي؛ كما يقول فرويد. لكن الخلف لا يصور قوانين السويد بوصفها مجرد شكل من أشكال الإكراه الاجتماعي فقط، فهي قوانين مكتوبة بعناية، لأنها حين تُطبّق على فئة هي الحلقة الأضعف، كاللاجئين في المجتمع السويدي، فإنها تتحوّل إلى شكل من أشكال العنصرية والدهس والقمع والمصادرة والنبذ، تحت مبررات كثيرة، أهونها أن اللاجئين المتوحشين يأكلون البط!










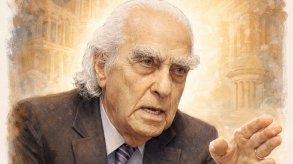

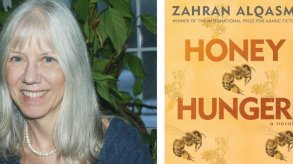

التعليقات