ما خرجتُ للشارع ورأيتهنّ سوداواتٍ كالغرابيب السود، إلا وعدت للبيت مكتئباً. إنها كآبة مَن يعيش في خضم العصور الوسطى، وهو يتنفس هواء القرن الحادي والعشرين. كآبة من يعرف أنه فشلَ في مسعاه، شكلاً ومضموناً، وأنه سليل قافلةٍ من التنويريين الفاشلين. قافلة بدأت خطاها الأولى منذ بدايات القرن الماضي، ولمّا تزل. قرن كامل من هباء الجهود، ومن خيبة المسعى. منذ رفاعة رافع الطهطاوي ومحمد عبده وحتى آخر وأحدث تنويري عربي. كلنا فشلنا، وكلنا حصدنا حصاد الهشيم. فلا التربة صالحة للزراعة، ولا المناخ يساعد، ولا البذرة قابلة للنمو. وها هي ذي القرائن: عرب القرن الحادي والعشرين يتجلببون بالجلاليب والنقابات، نساء ورجالاً، وحتى فتياناً وفتيات. يزدادون عدداً كل يوم. وكلما انضم إليهم وافد جديد، كلما تحسستُ فشلي وفشل جماعتي من جديد. لقد صار الفضاء أسود، وعدنا من حيث بدأنا، بل أسوأ مما بدأنا. أكان السبب في أننا أردنا حرق مراحل وحقب بأكملها، فتخلّينا بذلك عن سُنن التاريخ وقوانينه وعما تقول مناهج العلم والتفكير العلمي؟ أكان السبب في الاستعمار بكل ما عليه وفي تلك القوى الوطنية التي جاءت مِن بعده، فسامت شعوبها سوء العذاب؟ أم هو في هذا وذاك وذلك مضافاً إليه تكويننا ونسقنا الثقافي والحضاري؟ إرثنا التاريخي بكلمتين؟ أين تراها تكمن الأسباب الحقيقية لهذه الردّة عن التنوير التي يسمونها quot; صحوة إسلامية quot;؟ منذ أربعة عقود وكل مساعي التنوير في العالم العربي، تنكفىء وتتراجع. تنكفىء وتتراجع، فيما يتقدّم ويعلو تيار واحد ووحيد هو تيار الإسلام الإخواني، بكل تفريعاته ومواليده الجدد. انهزم اليساري الماركسي وانهزم القومي العربي، وانهزم تيار الوسطية، ولم يبق في الساحة فاعلاً ومكتسحاً سوى هذا التيار؟ فأين تكمن الأسباب؟ وما هي؟ ولماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن؟ أسئلة تحتاج إلى كتب لا مقال. أسئلة فوق مقدرة كاتب هذه السطور على تلخيصها في كبسولة سريعة. لكن دعوني آخذ سبباً مركزياً، يبدو لي أنه أُسّ وأساس وأب وأم كل الأسباب الأخرى، السياسية منها والاجتماعية وحتى الاقتصادية: ذلك هو النسق الثقافي والحضاري للعرب والمسلمين. ففي هذا النسق التاريخي، تكمن العلّة الكبرى، ويصحّ اعتبارها مرجعاً لكل ما يحدث. إن من الصعب بل يكاد يكون من المستحيل، تغيير وتثوير هذا النسق الثابت. فهو نسق يحيل إلى الكمال وعلى الكمال، ولا يشكو حامله من نقص هنا أو هناك. نسق يزعم امتلاك الحقيقة المطلقة، بكل وجوهها، ولماذا؟ لأنه ببساطة مربوط بالمقدس ومرتبط بشكل عضوي بالإلهي: هذا الإلهي الذي هو محور الحياة ههنا على هذه الأرض، والذي لا يحول ولا يزول. نسق صالح لكل الأزمان والأمكنة. فكيف لك أن تزحزحه قليلاً وأنت البشري الخطّاء؟ ومَن أنت لتفعل ذلك؟ مثقف؟ وماذا تعني هذه الكلمة؟ وهل هم حقاً بحاجة إلى مثقف حديث، مع غرابة وقع الصفة، ولديهم كل هؤلاء المشايخ الأفاضل؟ كلا هم ليسوا بحاجة إليك، فلتذهب إذاً إلى حال سبيلك، مع دعواتهم الصادقة لك بالهداية والرجوع عن الضلال! هذا كلام سمعته من بعض علية القوم في بلادي. وأسمعه كل يوم من وسائل إعلامنا المرئي منها والمكتوب. فما العمل؟ ما العمل مع محيط بلغَ فيه التخلّف حدّ أنه صار أعمى وله كل هذه العيون؟ بل صار أسوأ من الأعمى، لأنه لا يرى إلا ما في داخله هو من أوهام واستيهامات. لا يرى خارج أرنبة أنفه، ولا يهمّه متغيّرات الواقع من حوله، بقدر ما يهمه أنه هو الصح وغيره من كل مخاليق الدنيا على خطأ. يبدأ القرن الحادي والعشرون، وما من دولة فيه ولا حكومة تريد لنفسها أن تكون ذات طابع ديني، إلا هنا في بلاد العرب والمسلمين. يبدأ القرن الحادي والعشرون، وما من شعب من شعوب المعمورة يريد الدولة الدينية نظامَ حكمٍ له، إلا نحن أو جزء كبير منا. لقد تعلمن العالمُ المتحضر كله، وثمة شعوب تسعى جاهدة للحاق به، إلا نحن. فنحن نريد العكس: تأسيس دول دينية، بعدما فشلت الدولة الوطنية، ويا حبذا لو أعدنا ميراث الخلافة. لكي نعود فنحكم العالم بالسيف والنار. هذا هو حلم أحلامنا، الحلم المسكوت عنه، في وعينا ولا وعينا سواء بسواء. لكأننا ننطلق، من شدة ما انهزمنا تاريخياً، من عقدة الانتقام والثأر التاريخي. فهل بمثل هذه العُقد النفسية والتاريخية سنبني دولاً ويكون لها مكان تحت الشمس؟ طبعاً الجواب معروف. ومع ذلك، نصرّ على ما نريد، وننظر إليه على نحو خلاصي، وكأنه حل سحري يُخلّصنا، بطرفة عين، من كل مشاكلنا وهمومنا. فإن جاء أحد بفكرة ما أو منهج ما أو نظرية ما، وحاول أن يجتهد فيها، قاومناه وخطّأناه، بل حاربناه وقتلناه، فإن لم يكن قتلاً فيزيائياً، فلا أقل من القتل المعنوي والرمزي. وآخر مَن نريد قتلهم، بعد تخوينهم وتكفيرهم، هم الليبراليون العرب الجدد. بدعاوى عديدة منها أنهم عملاء للغرب والصهيونية العالمية، وأنّ هذا الغرب هو أول مَن يتخلّى عنهم مقابل مصالحه، وأنهم مبتوتو الصلات والوشائج بأرضهم وتاريخهم، وهلمّجرا. دعاوى تافهة لا تستحق عناء الرد عليها. وأسباب تُساق لكي يرجع الليبراليون عن خيارهم الفكري والحضاري، لكنها أسباب لا تثبت للتمحيص ولا للتدقيق.
فحتى لو تخلى الغرب عن المثقفين العرب الليبراليين، وهو متخل فعلاً، في الكثير من المواطن والأماكن، فإنّ ذلك لا يؤثر ولا ينبغي له أن يؤثر في صدقيتهم مع أنفسهم ومع مجتمعاتهم، وفي مواصلة طريقهم الشاق والمبهظ، نحو مستقبل أفضل لشعوبهم ولنظمهم السياسية. فالمثقفون الليبراليون، ذهبوا إلى خيارهم الليبرالي هذا، عن قناعات فكرية عميقة، في المقام الأول والأخير. قناعات، لم تأت عفو الخاطر، ولا مجاراة لحقبة تاريخية راهنة، سادت فيها الديموقراطية الغربية بوجهها الليبرالي الإنساني، فانعكست نعيماً على مواطنيها وأثبتت نجاحها في غير صعيد [ مع أنّ هذا مهم جداً ومُلهِم ولا يصحّ أن نتجاهله ] بل لأنهم، وهم المهمومون بقضايا وهموم شعوبهم ومنطقتهم الرازحة في التخلف، أيقنوا أن لا طريق آخر سوى طريق الحرية وإطلاقها في كل شأن من شؤون بلدانهم المتأزمة بما يرزح فوقها من ليل الديكتاتوريات الثقيل. فهذه الحضارة الباذخة في الغرب، والتي هي وليدة الليبرالية، هي خلاصة الفكر والاجتهاد البشري: خلاصة الحضارات وأفضلها. كذلك، جاءوا لوصل ما انقطع. فلقد كانت ثمة ليبرالية وبعض تقاليدها، في النصف الأول من القرن العشرين، تعمّ بعض بلدانهم، إبان العصر الملكي، في مصر والعراق وغيرهما، قبل أن يستولي عليها العسكر الثوريون والتحرريون.
إن الليبرالية خيار، وهم اختاروه. وقناعة وهم حملوها. وإذا كان الغرب يكيل بمكيالين، ويحمل وجهيْن: وجهاً لشعوبه وحلفائه، ووجهاً لغيرهم، هو على الأغلب قبيح، فإن ذلك، لا ينتقص من صواب الفكرة. فمن يطالع تاريخ الأفكار في العالم، يعرف جيداً، افتراق الفكرة عن التجسيد العملي لها في كثير من الأحيان. فالعالم لم يكن ولن يكون أفكاراً فقط، بل أفكار ومصالح.
لقد جرّب العرب المعاصرون، وطوال ستين سنة تقريباً، العديد من المدارس الفكرية ذات الطابع التقدمي، كأساس للحكم. ولقد أثبتت مجريات تاريخهم القريب، فشل هذه المدارس، ليس فقط لعيوبٍ نظرية فيها، وإن كان هذا صحيح في الأغلب الأعمّ، بل أيضاً وفي المقام الأول، لعيوب وخطايا، في من حملوا هذه الأفكار، وفي من طبقوها على الأرض.
ولقد جاء الآن خيار الليبرالية، كمنظومة فكرية وحضارية، تُقدّس الفرد البشري وتضمن له كافة حقوقه، فلا يكون رقماً في قطيع، ولا رعية لسلطان، ولا عبداً لرئيس أو ملك. بل إنسان يتمتع بكامل حقوقه كمواطن في دولته المدنية، وحقوقه مصانة ومكفولة بقوانين وتشريعات هي فوق الجميع: وبالأخص فوق جبروت السلطة ورأس النظام وأزلام هذا النظام.
هذا ما ينادي به الليبراليون العرب الجدد، بعد أن أُشبعتْ شعوبهم ظلماً وعدواناً من رجالات وجلاوزة السلطة الغاشمة في المنطقة العربية، على مدار التاريخ. فكل حاكم لدينا هو الله أو ظلّه على الأرض. خليفةً كان أو ملكاً أو رئيساً. وليس هذا فحسب، بل إنّ كل من يحيط به ويكون قريباً منه، هو أيضاً إله أو نصف إله. ولقد آن لهذه المهزلة التاريخية العظمى أن تنتهي. وهي لن تنتهي بالرجوع إلى تراثنا الديني والفكري والأدبي، واستلهام ما فيه، فهذا التراث بوجوهه المتنوعة، لا مكان فيه لحقوق الفرد، ولا لحقوق الشعوب، لأنّ هذه الكلمة هي كلمة حديثة بامتياز، وعمرها في العالم كله، أقل من ثلاثة أو أربعة قرون. بل كل المكان فيه للسلطان والخليفة والأمير، وهذا لا يعرف إلا الظلم والعدوان، منهجاً ومدرسة، في التعامل مع رعيته ومواليه. لذا لا بد من استلهام الغرب العظيم في هذا المجال، فمنه نُحتتْ مفردة الفرد ومنه نُحتتْ مفردة الشعب ومنه نُحتتْ مفردة الحقوق. ولسنا، لو فعلنا هذا، بدعاً، فكل شعوب عالمنا المعاصر، تستلهم الغرب، بما هو موطن أفضل النظم السياسية في العالم المعاصر قاطبة. أما أن نملأ فضاءنا وشوارعنا بالغرابيب السود، وبالذقون المهوشة، وبالجلابيب، كفعل نكوصي مرَضي، فذلك كله عبث صبياني، لا يليق بأمة تعيش في القرن الحادي والعشرين، وتنوء تحت ثقل تخلّفها الباهظ. أمة سبقتها حتى دول أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية، فتنفستْ هذه هواءَ عصرها، بينما نحن نتنفس هواء الكهوف ما نزال. ونظنّ أنه الهواء الطلق الوحيد في العالم.
إنّ مشهد الفضاء الأسود، والغرابيب السود، ليقضّ مضجعي ويحرمني من النوم، شخصياً. فليس هكذا أحلم لبلادي، ولا هكذا أحلم لشعبٍ أعيش بين ظهرانيه. ولكَم أحلم، لو ينتهي هذا المشهد من الواقع، فينتقل إلى السينما التوثيقية، كمشهد يدلّنا، على ما كنا فيه، وما عانينا منه، في الماضي القريب. أحلمُ؟ لا بأس. على الأقل أحلامي تنويرية، ما دام التنويرُ يعوز واقعي وحياتي!






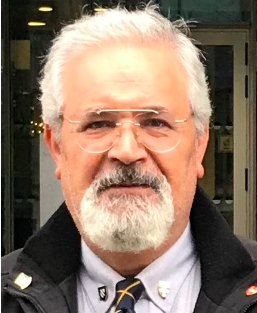














التعليقات