الكتاب: هل الله موجود / دراسة لمشكلة الإلوهية في الوجودية والإسلام.
تأليف: دكتور مصطفى عبد المعبود.
طبع: مكتبة مدبولي.
الهدف الصادم
يتعرض الكتاب الذي بين أيدينا إلى آخطر قضية شغلت وسوف تبقى تشغل العقل البشري مهما كان شأنه ودوره وذكاؤه، تلك هي قضية العلّة الأولى لهذا الوجود المدهش، أي قضية الإلوهية كما عبّر عنها المؤلف. وفي الكتاب الذي نحن بصدده يقتصر على إثارة المشكلة عند كل من الإسلام وا لوجودية مقارنة وموازنة على نحو نقدي رصين في تصوري، ناضج كما أرى.
الكتاب قد يشير من عنوانه إن الكاتب يريد إثبات وجود الله الذكي الحكيم الرحيم ردا على الوجودية الملحدة التي مثّلها بشكل واضح الفيلسوف الراحل جان بول سارتر، على إعتبار أن هناك وجودية مؤمنة كان كارل ياسبرز يمثلها تبنيا ودفاعا وإنتصارا، ولكن تصفُّح الكتاب سوف يصدم القاري صدمة عنيفة، حيث يرمي الكاتب من كتابه إلى إثبات أن الإيمان موضوعة إخلاقية وليس عقلية، ولذلك ركّز على تزييف ما يسمى بالأدلة العقلية على وجود الله عزّ وجل، وأعرض عنها كملجا للمؤمن كي يستعين بها على تبرير إ يمانه.
كان الفيلسوف الأمريكي جورج سانتيانا يقول (الإ يمان غلطة جميلة)، ولكن المؤلف ليس في موقفه من الإيمان على غرار موقف هذا الفيلسوف الذي عرف بنظراته الثاقبة عن (الجمال)، بل يرى العكس، فإن الايمان شي جميل ورائع وصادق، ولكنّه لا يشكل قضية إستدالية، بل هو قضية نؤمن بها بلا دليل.
يبدا الكاتب بالتمييز الجاد بين مقولتين أو قضيتين، الأولى: الإيمان بوجود الله، و الثانية: الإيمان بالله. ومرد الفرق بينهما، إن الإيمان بوجود الله لا يعني بالضرورة الإلتزام بمنظومة القواعد الخلقية والتوجيهية والعبادية التي بشرّ بها أنبياء الله عزّ وجل، فيما الايمان بالله يعني ذلك بالضرورة ، وهو بهذا التصوير يعطي للإيمان بالله ميزّة زائدة على الإيمان بوجود الله، حيث يكون هذا الا خير مقدمة للإيمان بالله، ويفوق عليه بمعلم الإلتزام الديني حسب منطق أنبياء السماء.
هناك إله الأديان التي خُتِمت بالاسلام، وهناك إله الفلاسفة والمفكرين اللاهوتيين، وربما يفترق الإلهيين في كثير من الاحيان، وبذلك تكون العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مطلق، فقد يجتمعان وقد يفترقان.
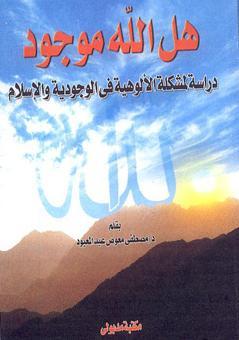
يشتغل الكاتب طويلا على القرآن باعتباره خاتم الكتب السماوية كما يرى ويعتقد، ويزيّف كل الإدعاءات التي ترى أن الكتاب الكريم يتضمن أدلة على وجود الله، ينفي ذلك نفيا قاطعا، وعنده إن جل أو جوهر القضية التي أولى لها القرآن إهتمامه ا لكبير هي (توحيد الله) وليس وجود الله، فإن وجود الله قضية مفروغ منها في منطق القران، ويستعرض بإسهام الآيات التي تتحدث عن الله ويعلّق قائلا (نلاحظ هنا / فيما يخص الآيات التي تتحدث عن الله / أن القرآن الكريم قد استخدم الآيات الباهرة في التدليل على وجوب توحيد الله، لا في التدليل على وجود الله، إذ أن القوم كانوا يسلّمون أصلا بوجود الله.) ص 26. وفي ضوء هذه الرؤية التي يطرحها الكاتب يسجّل خمس مؤاخاذت ناقدة على حملة الرأي المعاكس، منها: تجاهلهم أن قضية وجود الله في القران هي (قضية مفروغ منها، وينبغي التسليم بها تسليما قبليا وكاملا)، ومنها: تجاهلوا أنه لا توجد أدلّة عقلية يمكنها أن تبرهن على وجود الله) ومنها: إنّهم أساءوا ا ستخدام الادلة التي ساقها القرآن على التوحيد، إذ حرفوها إلى الوجود ص 27.
يستعرض الكاتب شأن الامم السالفة في ضوء القرآن ليقرر أنْ ليس منها من جحد وجود الله، بما في ذلك فرعون ، وبذلك يشنّع على الفيلسوف الكبير الرازي الذي يتحدث عن فرعون كافرا بالله، ملحدا بوجوده، بإعتبار أنه كان يقول إن فرعون يقول بأن الكواكب هي التي تدبر العالم، حيث يعد ذلك إعترافا من فرعون نفسه با لالوهية، ولكن على طريقته الخاصة ص 38. على أ ن أهل مصر القديمة كانوا يعتقدون أن فرعون بمثابة تجلي أو خلف أو مظهر للإله (رع)، وهو إعتقاد فرعون نفسه ص 39.
إن السياقات التي جاءت أو وردت فيها لفظ (يعقلون) و (يتفكرون) و (ينظرون) لا تتضمن أي نوع من البرهنة العقلية أو التدليل على وجود الله، بل يتضمن (فقط التدليل على وحدانية الله ووجوب توحيده) ص 55.
نقد الأدلة العقلية على وجود الله
ينتقل الكاتب بعد ذلك إلى موضوع آخر، إنه تزييف الأدلة التي يسوقها أهل العقل على وجود الخالق جلّ وعلا، وهذا الا دلة كما هي معروفة في الفلسفة، الدليل الكوني أو الانطولوجي الذي برع الفليلسوف أرسطوا بتجليته وإظهاره بحلته الفلسفية القشيبة، ثم الدليل الغائي الذي يعتمد على فكرة التوائم الفذ بين خصائص الخلق ومتطلبات الوجود الانساني، بل على هذا التلاحم المدهش بين متطلبات الوجود المتبادل بين الكائنات والأشياء، ولكنّه لا ينسى أن يقوم بعملية نقد حاد للأدلة التي لا تعتبر فلسفية، بل أدلة تكاد أن تكون اشبه بالوجدانية ، ومنها دليل (الإجماع العام) الذي انتصر له إفلاطون بشدة وحرارة في كتابه (العاشر) من محاوراته المعنونة بـ (القوانين)، فإن إجماع الناس على وجود الله دليل كاف ومعلم بداهة لا تتطلب المراجعة ولا النقد، بل التسليم والطاعة والإذعان! فيرفض ذلك باعتبار (معلوم بالبداهة أن إجماع الناس على شي لا يوجب في حد ذاته صحة هذا الشي، وكذلك فإن إجماع ا لناس على شيئ قد يكون قائما على سلطة التقليد) ص 61. والدليل الأخر هو دليل (الفطرة) الذي إشتهر بين المؤمنين، وأصبح مسلمة من المسلمات، ومفاده (إن كل إنسان يتمتع بشعور غريزي جبلِّي كامن في أعماقه بأن فوق الكائنات المحدودة المتناهية كائنا غير محدود، وغير متناه، مهيمنا على كل شي، ومدّبرا لكل أمر، ومرجوا ومقصودا ومعظَّما، ويُخشَى منه، إنه شعور ينبع من الاعماق، ويجده الإنسان في نفسه بغير تعلم ولا تلقين) ص 62، ويشرع فيما بعد بإبطال هذا الدليل المسمى بالدليل الفطري من ستة أوجه، وفي مقدمتها إن الملحدين على سبيل المثال ينكرون مثل هذا الشعور الفطري بوجود الله، إن هذا الشعور إن كان فهو شعور ذاتي، ومعلوم (إن ذلك كله لا يترتب عليه القول بأن هذا المعادل الذاتي يقابله معادل موضوعي) ص 62.
يحاور الكاتب بجدية ورصانة الدليل الكوني والغائي على وجود الله عزّ وجل، ويرجعهما في الاساس إلى مبدأ (العليَّة) أو (السببية) الذي يعني بالأساس، لا مسبَّبْ بلا سبب، أو لا معلول بلا علَّة، والكاتب يدافع دفاعا مريرا عن مبدا العليَّة بحد ذاته، ويشنع على هيوم وبعض المأخرين ممّن أنكر الوجود الموضوعي للعليَّة، فيقول (والحق، إن مبدأ العلية أو السببة هو مبدأ عقلي كلي تم تجريده أو استخلاصه من الاقترانات الجزئية بين الظواهر والأشياء الحسية المتعددة في الكون، ولولا هذا التجريد، لكان العام عبارة عن أجزاء منفصلة مبتورة، لا صلة مفهومة أو معقولة بينها، ولولا التجريد بوجه عام، لما أمكننا أن نتحدث عن الإ نسان بل سوف نتحدث فقط عن جزئياته محمود أو أحمد أو علي...) ص 67. ولذلك يستغرب من الفيلسوف هيوم وغيره ممّن أرجعوا مبدأ العلية إلى ظاهرة التداعي، فهي وهم ناتج من إعتيادنا على توقع ما كنا قد عهدناه متراتبا بين ظاهرتين، مثل إرتفاع الظمأ بعد شرب الماء مباشرة، ولكن نسيى هيوم إنه يستخدم ذات السببية هنا في إ بطال السببية. ص 69.
يتقوّم الدليل الكوني بنقطة جوهرية، هي إبطال التسلسل بالعلل والمعلولات إلى ما لا نهاية، فيجب أ ن تكون هناك نهاية لهذا التسلسل، مشبّعة بذاتها، قائمة بنفسها، وهي التي يسميها ارسطو المحرِّك الذي لا يتحرك، ويطلق عليها علماء الكلام الاسلامي بـ (واجب الوجوب)، وهي قفزة غير طبيعية على مبدأ السببية نفسه، إذ يتساءل العقل البسيط عن علة هذا الشذوذ، فإن الانتهاء إلى (سبب الا سباب) مغالطة، لاننا أقررنا شيئا سلفا ثم تصرفنا بمبدأ السببية وفق ما أقررنا سلفا!! ص 72.
يناقش المؤلف ما يمضيه الدليل المذكور من كون إستحالة تسلسل الاسباب والمسبّبات بقوله (إن المشكلة لا تكمن في التساؤل الساذج عمّن خلق الله، بل تكمن في عدم وجود ضرورة عقلية منطقية تلزمنا بالوقوف عند محطّة نهائية أو علّة أولى قصوى نطلق عليها أسم / اللّه)) ص 80، أي بعبارة أخرى (إن تسلسل العلل والمعلولات الى ما لانهاية أو توقفها عند علّة أولى، هما أمران جائزان من الناحية العقلية، ولا يمكن للعقل ذاته ترجيح أحدهما على الأخر، أو القطع بصحّة أحد هذين الأمرين المتناقضين وتحديده)، على أن الرياضة الحديثة أبطلت عدم إمكان اللامتناهي، ومن هنا لم يرتض كبير فلاسفة الاسلام المحدثين إبطال التسلسل كما كان يعرضه علماء الكلام الإسلامي بشكل خاص واللاهوتي بشكل عام، أقصد الفيلسوف الكبير محمد باقر الصدر.
لقد كان الكاتب دقيقا في تجلية الموقف، فهو لا ينكر (إمكان) بطلان التسلسل إلى ما لا نهاية من الاسباب والعلل، ولكن يؤكد إن هذا الامكان أحد إمكانين، حيث الثاني هو (إمكان) لا نهاية ا لتسلسل. ليس بطلان التسلسل ضروريا، بل ممكن، والممكن الأخر هو (إمكان) التسلسل إلى ما لانهاية، وبذلك لا يحق لنا الإعتماد على الدليل الكوني على وجود الله، إنه دليل زائف.
يتناول بعد ذلك المؤلف الدليل الغائي على وجود الله، ويصفه بقوله (يعتبر الدليل الغائي واحدا من أكبر الأدلة إستخفافا بالعقل البشري وأكثرها دوجما طيقية وإدعائية) ص 83.
يعتمد الدليل الغائي على مبدا العلية صعودا من النظام البديع للكون إلى علة أسمى لا تتاثر بمعلولها، قائمة بنفسها، غنية بذاتها، ومن هنا يمكن القول (إن ا لعلاقة وثيقة بين ا لدليل الكوني والدليل الغائي، بل يمكن القول أن هذه العلا قة تتصف بالتكامل) ص 83.
لب الدليل الغائي يقول (أن هناك شواهد حسية وعقلية تدل على أن هناك نوعا من التيف أو التوائم بين الموضوعات الطبيعية وتحقيق غايات معينة... وطالما الامر كذلك فلابد إذن من وجود مصمِّم حكيم أو عقل خلاّق هو الله) ص 83.
يرفض الكاتب هذا المنطق، ذلك أن شواهدنا الحسية تكشف لنا بوضوح أن كثيرا من دقة الصنع والنظم هي نتاج قوى غير عاقلة، فهذه ا لساحة الكونية تتحرك بفعل عوامل طبيعية نعرفها جيدا، فإن عملية التناسل مثلا هي نتاج لقاء عوامل طبيعية لا تمت بصلة إلى العقل الحكيم. وإذا قيل أن التصميم الدقيق يحتاج إلى ذكاء خارق، فإن الأخر يمكن أن يقول إن الذكاء بحد ذاته ربما هو نتاج هذا التلاقي بين قوى الطبيعة الميتة!! خاصة وإن نظرية النشوء والارتقاء فيما إذا صحت تقول با ن الدماغ البشري هو حصيلة تطور هائل مرت بها ما دة الكون عبر ملايين السنين! ولكن أين هي الحاجة إلى الذكاء ونحن نرى هذه الوردة الجميلة إنبثقت وتشكلت وتزينت بفعل بذرة تلقى في إرض خصبة وماء مشبّع با لغرين وأملاح تمتصها بواسطة شعيراتها الميتة هي ايضا؟ فما المانع أن نقول إن هذا التصميم هو نتاج قوى غير ذكية بالاصل؟
هنا يأتي دور القياس با لنسبة للمؤمن، فإنه يصر على أن مظاهر الكون الجميلة ا لمتقنة لابد أن يكون وراءها ذكاء مفرط، بدليل إننا ببساطة نقول إن هذه الساعة المتقنة إنما هي نتاج مصمِّم ذكي حاذق، فكيف بهذا الكون الذي هو أعقد صنعا، وأ كثر جمالا، وأعمق عطاء؟
يرى الكاتب إن مثل هذا الحجاج يبلغ السخف إلى حد كبير، ذلك أننا نستدل على أ ن وراء هذه السا عة الجميلة عقلا ذكيا لأننا شاهدنا ذلك في المعامل والمصانع أمثلة مشابهة، فقمنا بعملية قياس لا أكثر ولا أقل، ولكن أليس نشاهد في نفس الوقت (أن هناك أنواع عديدة من العلل الطبيعية الكونية المنشئة للنظام والتصميم بالرغم من أنها لا تتمتع بالذكاء؟!) ص 88 / نقلا عن الفيلسوف كرونمان في كتابه لمشكلة الفلسفية والمعرفة ص 321 /.
إن أقصى (ما يمكن للدليل الغائي أن يثبته هو إمكانية أو جواز وجود / مصمِّم ذكي / لا ضرورة أو وجوب وجوده، ذلك لأنه لا يمكن أ بدا الإستدلال من مجرّد النظام والإبداع في الكون على ضرورة وجود / مصمِّم ذكي / إلى إذا توفرّت لدينا تلك الشواهد القائمة على التجربة والملاحظة الحسيّة الممكنة لهذا المصمِّم أثناء إداء عمله كما ذكر احد الفلاسفة وهو أوكونور) ص 89. والخلاصة المهمة التي يصل إليها المؤلف هي: إن ا لتصميم في الكون بقدر ما يشي عن علة ذكية يمكن أن يشي عن علّة غير ذكية، ولا مرجِّح لاحدهما على الآخر.... وبالتالي فإن ترجيح أحدهما على الأخر يتم على أساس الإيمان نفسه، إنه الأساس الإيماني فقط.
الفلاسفة الوجوديون ومشكلة الإلوهية
ينتقل الكاتب بعد هذه الجولة المضنية حول مشكلة الالوهية في نطاق الاستدال الفلسفي إلى ذات المشكلة في نطاق الفلسفة الوجودية مبتدا بـ(باسكال 1623 ــ 1626) لاعتقاده أنه الأب الروحي الحقيقي للوجودية بكل مدارسها ونماذجها، ولم يكن موقف باسكال من قضية الالوهية خفيا، بل و اضح جلي، فهو من أشد المنافحين عن الإيمان المسيحي، ومن أشد المعارضين لنهج الاستدلال على الله، بل يرى هذا الفيلسوف الذكي بافراط إن ما يسمح بالإنكار في الطبيعة أكثر ممّا يسمح بالايمان، ولذلك يمضي الإيمان إرادة مسبقة مهما كان ثمن ذلك، منطلقا من الحاجة إلى السعادة وضرورة التغلب على ظلمة الكون، وقهر الوجود، وآلام الحياة. فهو هنا لا يختلف عن الفيلسوف البركماتي وليم جيمس، الذي ينعى على الملحد إلحاده لان ذلك يعبر عن ضعف في تحمل معنى اليقين، وجبن في التعامل بايجابية مع حتمية الكون وعلله السقيمة بالنسبة للمخلوق الإنساني. ويبدو أن الفيلسوف كيركجور إلتقط بقدرة رائعة النحو الباسكالي ليصيغة بعبارة محكمة (إن الله بالتأكيد مسلّمة ولكنه ليس مسلّمة على النحو العقيم العديم النفع الوارد عادة في فهم هذه الكلمة... فهذه المسلّمة هي أبعد ما تكون عن كونها إعتباطية، لدرجة أنها تعتبر تحديدا ضرورة الحياة) ص 119.
يرى باسكال إن الله محتجَب عنا، حجبته الخطيئة التي أقترفها الانسان الاول، وقبل ذلك تردد الطبيعة بين ما يفسح المجال للإنكار وما يفسح المجال للإيمان، وما على الإنسان إلاّ العودة إلى البراءة الاولى كي ينفتح الله عليه، وينفتح هو على الله أيضا ص 129. هذا الاحتجاب يقابله عند نيتشة تماما (موت الله)، وبالوقت الذي كان (احتجاب الاله)بالنسبة لباسكال يشكل مزيدا من أسباب العودة إلى الله، كان (موت الله) يشكل مزيدا من أسباب إعلان الالحاد كمسلمّة غير قابلة للتفاوض و المساومة!
لقد أنقذ شوبنهاور نيتشة من عدميته...
ولكن كيف؟
لقد إستقر نيتشة على تمرده، تحول تمرده إلى حقيقة، فالإله قد مات، وعليه مواجهة الكون بحيوية طاغية! أي عكس موقف شوبنهاور الذي كان يؤكد على الموت كخلاص ونهاية ناجعة، ويا لها من مفارقة رهيبة إذن!
لقد تمسّك نيتشة باضطراب الكون وعدم تناسقه وانتشار الشرور ليعلن ثورته على الله من جهة، وليسعى إلى أن يتعالى على الكون ذاته من جهة أخرى.
إن موت الإله تعبير عن العدمية بلا شك، والموقف هو مواجهة هذه العدمية المفرطة، هكذا كان رأي نيتشة، وليس غير الإنسان الاعلى طريقا بل فلسفة في مواجهة هذا الفراغ الذي تركه موت الإله ص 138.
قرا كامي الفيلسوف نيتشة وكان مهوسا بمقولة (موت الإله)، وكان كتابه (إسطورة زيزيف) الذي اصدره سنة 1955 مشبع بروح المقولة النيتشوية هذه، وإذا كان نيتشة قد واجه موت الإله بمشروع الإنسان الاعلى، فإن البير كامي كتب في مقدمة كتابه هذا (إذا كان المرء لا يؤمن بالله، فإن الانتحار رغم ذلك ليس أمرا مشروعا) ص 147.وبالتالي يجب أن نعيش أو نحيا بتعبير أدق. بل أن البير كامي يرفض الايمان لانه وخلاف باسكال لانّ الإيمان حسب كامي يستوجب التعالي على الوعي المختلط، أو الإيمان يستوجب حالة من نصاعة الوعي، الصفاء الذهني، ا لإبتعاد عن كدر الوجود، وإسقاط شفافية الإيمان عليه زورا وكذبا ودجلا أو وهما وخيالا وسرابا.
من ناحيتي لا أعرف كيف يجمع كامي أو غيره بين هذا الإنكار المطلق وجديّة الحياة؟ كيف نجمع بين سلب وإيجاب؟ تحتاج إلى مغالطة كبرى، فالموت مهزلة مذلة فيما أنكرنا الحكمة وتعالينا على غرض الوجود؟
لقد بقيت مسألة الشر سلاحا ماضيا يشرّح جثّة الإيمان ويمعن في طعنها حتى التمزّق المثير للقرف، ولذا ليس عجبا أن يكون البير كامي قد أستهلك الكثير من وقته للجمع بين عبثية الكون وحرية جادة مسؤولة.
هل هي لعبة الملحد للخروج من الأزمة العاصفة في داخل روحه؟
تلك هي نعمة الإيمان....
تتعالى بك على جروح الوجود، وتخلص لك ا لكون هدية مرّة يجب أن تستمرئها وتتخلص من العذاب والمأساة والحزن والهم، فالشرور حكمة مغلفة بقصد الله.
فرق بين أن نتقبل كونا فاجعا وبين أن نأوّل فجاعة الوجود بحكمة خفية.
هايدجر وياسبرز
بعد هذه الجولة الممتعة يدخل بنا الكاتب إلى أقبية كل من الفيسلوفين الكبيرين هايدجر وياسبرز، الاول يدعو نفسه (راعي الوجود)، والثاني يدعوه فيلسوف التعالي أو العلو، فقد كان الشغل الشاغل لهايدجر هو الجواب على سؤال (ما هو الوجود)، ويدّعي هذا الفيلسوف المغرم بنحت المصطلحات الخاصّة به إن مدخل فهمنا أو وعينا للوجود يبدا من تحلي (الأنية) الانسانية، التي عجز حقا عن إعطائنا صورة وا ضحة عنها، فكانت وعدا بلا وفاء كما قال أحدهم عنه (كان هايدجر يعتمد على الامل في أنه سوف يحل لغز الوجود، وينجز ماعجزت فعله الإنطولوجيا الغربية منذ أرسطو... وفي الواقع، فإن هايدجر لم يقم بحل لغز الوجود،بعد أن قام با ستعراض الوجود الإنساني) ص 187. ولكن الرجل كان منغمسا في حقيقته بالوجود الفردي (الأونيقيا) مفترضا بطريقة (جزافية أن هناك تعادلا وتساويا بينهما) ص 187.
ولكن ما هي علاقة هايدجر بالميتافيزيا؟
كان يلح على تجاوزها وتخطيها (وإقامة الإنطولوجيا الحقة التي تبحث عن / الوجود / من حيث هو كذلك) ص 183.
ومن أجل ذلك جهد نفسه على تعريف الوجود بأنه (هو ما هو) ص 183، وهي ذات العبارة التي اتخمت أسماعنا بها الفلسفة الإسلامية منذ أن أرسى بعض دعائمها الكندي وحتى هذه اللحظة التعيسة من حياتنا.
هذا التقديس الوثني للوجود قاد بعضهم إلى القول بان هايدجر مجرّد وثني صارخ، تسافل بالوجود الإلهي حتى غمسه بهم وجوده، وآنيته، ورمى به خارج القوس، محنّطا بين نعم و لا، أي ميّت مجرد ذاكرة ميتة. فيما يرى بعضهم إن هذا الهم الوجودي، هذا الانغماس الحار في الوجود دليل على إيمان عميق، غاية ما في الامر أنه ميتافيزي غير تقليدي كما هم الاخرون. وفي ضوء ذلك تقوم هذه المحاولة بعملية تأ ويلات رهيبة للكثير من مواقف الرجل من الله والغيب والميتفايزيا ص 209. ويقف رأي ثالث ليصف (راعي الوجود) بإنه محايد بل هو فيلسوف (اللا ادري) ص226
هذا الغموض الهايدجري يتكرر بشكل مريب وعاصف عند كارل يسبرز، حيث يغرق أحيانا في تقليدية ميتافزية فجة،وذلك عندما (يتخذ من كافة مظاهر القصور الإنساني دليلا على وجود العلو / الله /) ص 228. ممجّدا (إحتجاب الله) لأن ذلك يجعلنا نراهن على الحرية، فإن وضوحه وتجليه يجعلنا أسرى، يميت فينا أي تطلّع للفوق، للعلو، لو كان الله وا ضحا لدينا (لكنّأ مجرد دمى تحركها إرادة الله) ص 229.
في تصوري أن ياسبرز يقفز قفزة نوعية عندما يرى في الحرية شرطا من شروط اللقاء بالله، معرفة وإيمانا وتعاملا، فهو يعتقد (أن تجاوز الانسان لنفسه والعالم، من خلال الحريّة، يتيح أكبر يقين بوجود الله) ص 231، وينقل المؤلف لياسبرز قوله (إن الإنسان الذي يبلغ الوعي الحقيقي بحريته، يكتسب اليقين بوجود الله، فالحرية والله لا ينفصلان... إذ أن أسمى حرية تُعاش في التحرّر من العالم، وهذه الحرية عبارة عن ربط عميق يصلنا بالعلو).
وصدق الله العظيم الذي قال لنا في كتابه الكريم ما معناه، إن الطريق الحقيقي إلى الله هو التجرّد من حب النفس، والارتقاء بالذات إلى فوق.
أية إعادة نشر من دون ذكر المصدر إيلاف تسبب ملاحقة قانونيه

















التعليقات