"كنت حينها أتنزه بالقرب من بحيرات إكسيل في بروكسل. وأدركت أنني كنت أحمل هذا الكتاب في داخلي طيلة الوقت. كان جاهزاً ومصاغاً وتام المعنى. كنت طفلاً صموتاً وكان صوتي مسكتاً في مخيم اللاجئين. وحينما رحلت أمي إلى المملكة العربية السعودية، وتركتني مع جدتي، كان الصمت كل ما شعرت به وكأن أمي أخذت معها لغتي.."
هكذا يشرح مؤلف رواية "الصمت أضحى لغتي الأم" الكاتب الإرتري سليمان أدونيا ولادة فكرة كتابه. وذلك في معرض رده على الأسئلة خلال المقابلة التي حاوره فيها أندرسون تيبر، وترجمتها إلى العربية رفيدة جمال ثابت.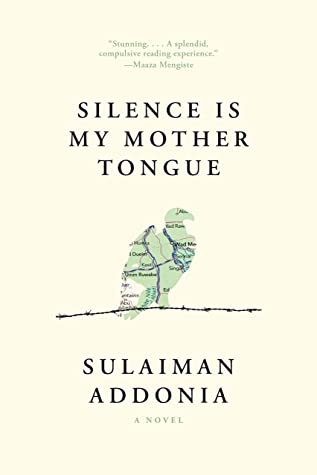
في ما يلي نص الحوار:
*في البداية يعتريني الفضول بشأن عنوان الرواية. من أين استقيته؟ أم هل ابتكرته؟
- أود أن أقول ابتكرته، لكني لست واثقاً من أنها الكلمة المناسبة. لقد عكفت على كتابة الرواية لفترة طويلة ولم أتعجل البحث عن العنوان. وفي ساعة متأخرة من إحدى الليالي ومض فجأة في ذهني، بعد ثمانية أعوام من بداية الكتابة، كنت حينها أتنزه بالقرب من بحيرات إكسيل في بروكسل. وأدركت أنني كنت أحمله في داخلي طيلة الوقت. كان جاهزاً ومصاغاً وتام المعنى. كنت طفلاً صموتاً وكان صوتي مسكتاً في مخيم اللاجئين. وحينما رحلت أمي إلى المملكة العربية السعودية (كنت في الثالثة من عمري تقريباً حينذاك) وتركتني مع جدتي، كان الصمت كل ما شعرت به وكأن أمي أخذت معها لغتي. أحياناً تفضي بك الظروف إلى عالم من الصمت، لكن فور أن تدخله وتكتشف جماله وثراء مفرداته، تتقبله وتعتنقه. وهكذا أضحى الصمت لغتي الأم، وصار شخصية في الرواية، فعاش في أبطالها الرئيسيين، ولازم اللغة والكلمات على الصفحات.
*تنعطف الرواية نحو منظور المتكلم عدة مرات، لكنها إجمالاً تطفو بحرية حول المخيم. نرى الشخصيات تستحم، وتحلم، وتحب، وتتذكر حيواتها السابقة. أكانت تلك طريقة للوصول إلى عوالمهم الداخلية ورغباتهم الدفينة بصورة أكثر قرباً وعمقاً؟
- ربما. وقد يرجع السبب أيضاً إلى أنها كانت الطريقة الوحيدة لكتابة تلك الشخصيات. حينما تأملت الرواية من منظور القارئ، لاحظت تأثير السينما فيها، وكأنما ثمة كاميرا مثبتة بجبهتي وقت كتابتها سمحت لي بتكبير الصور أو تصغيرها، أو التحرك يمنة أو يسرة. هذه الكاميرا استودعتها كل مخيلتي. فقدت ذاتي، أو بعبارة أصح، سموت عنها. حينما أكتب لا أكون واعياً؛ بل تخضع نفسي للقصة، وتكتب الشخصيات نفسها. واللاوعي في فعل الكتابة هو الاستسلام إلى قوى الإبداع الغامضة.
*صبا شخصية مميزة. تقول في أحد المواضع: «لا شيء في هذا المزيج يبدو على حقيقته. إننا نعشق بطريقة مختلفة هنا». ما أهمية خلق شخصية تتحدى الأدوار الجندرية التقليدية والتابوهات الجنسية؟
- هذه الشخصيات موجودة في الواقع، حتى لو اضطر بعضها إلى العيش في المناطق الرمادية، على هامش المجتمع. وقلما يتناولها الكُتّاب لأنهم مرهونون بأعراف المجتمع ومعاييره. إن كل القواعد الأدبية الناصحة والزاجرة ما هي إلا طريقة أخرى لتحجيم مخيلة الكُتّاب. وقد أدركت ذلك في بداية كتابة «الصمت». لم يكن بوسعي كتابة بعض الشخصيات التي تحتفظ بأفكارها الخاصة عن مفاهيم الجنس والرغبة، مثل صبا وجمال. وحينما فطنت إلى القيود المكبلة لمخيلتي، والتي فرضتها المجتمعات التي عشت فيها (إفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا)، وضعت قلمي جانباً واعتزمت تحرير ذهني، فعزلت نفسي مع كتب الطيب صالح، وآن ديكلو، وجورج باطاي، وبازوليني، مع الأفلام، والصور الأيروتيكية، والمفكرات النسويات، والشعراء، والفنانين الذين شكلوا تحدياً لعقلي. وبعدما تحررت من الأحكام، خرجت من تلك التجربة مزمعاً إتباع شخصياتي أينما أخذتني وكتابتها كما هي. ولذلك أقول دائماً: «لقد كتبت رواية (الصمت)، لكنها كتبتني أيضاً».
*منذ عهد قريب نشرت مقالاً عن طفولتك الخالية من الكتب واتجاهك، عوضاً عن ذلك، إلى قراءة الحياة من حولك. ما أهم الكتب التي طالعتها في فترة المراهقة حينما كنت مقيماً بالسعودية برغم الرقابة؟
- الكتاب الأول الذي صدمني وفتنني كان »موسم الهجرة إلى الشمال« للطيب صالح. بالإضافة إلى «أوليفر تويست» لتشارلز ديكنز. بالإضافة إلى كتب فرجينيا وولف وفيكتور هوجو، كتب لم استطع صراحة فهمها. لكنها لم تكن عن الفهم، بل حول اكتشاف عالماً وراء الأبيض والأسود التي حاول النظام السعودي ترسيخه في أذهاننا. العالم الحقيقي، بكل تعقيداته وفروقه الدقيقة، كان في متناول أيدينا من خلال الأدب المهرب.
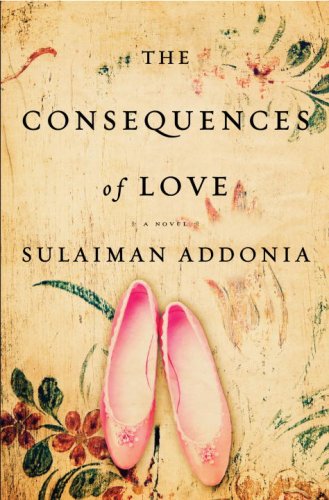
*رواية «الصمت لغتي الأم» مهداة إلى رفاق الصبا. وفي موضع آخر كتبت: »لقد كانت تلك السيمفونية ذات النغمات الإنسانية المعقدة، والتي ألَّفها أناس عاديون، هي من زرعت في نفسي حب مخيم اللاجئين«. متى اعتزمت الكتابة عن هذا العالم ونقله إلى عالم الأدب؟
- بعد نشر روايتي الأولى «تبعات الحب» في عام 2008، كافأت نفسي بالسفر إلى باريس لقضاء إجازة لفترة وجيزة. ذهبت إلى المتحف، وابتعت كتاباً عن الرسام الفرنسي ديجا. ثم خرجت وجلست في المقهى، وتصفحت الكتاب سريعاً، ووقع بصري على لوحات (المستحمات)، والتي كانت تماثل طريقة الاستحمام بالمخيم. وعلى الفور طرأت فكرة على ذهني. أردت أن أرسم المرأة الإرترية الإثيوبية بالطريقة التي رسم بها ديجا المرأة الفرنسية؛ مفعمة بالحياة، ومعقدة، ونابضة بالحيوية، في عمل فني يتناول التاريخ ومآسي الحياة، بشكل مباشر وقوي. تصورت إحدى الشخصيات تستحم في دلو ماء، في كوخ، بأحد المخيمات، في مكان ما بشرق أفريقيا. أسرتني القوة الكامنة في العري؛ إذ كانت بوابة إلى الحميمة والحرية، وأتاحت لشخصياتي التسامي عن بيئتهم المحيطة والعيش بحرية على الصفحات. ورُغم أن كتابتها استغرقت عشر سنوات، فإنه يتراءى لي أنني تمكنت أخيراً من رسم شخصياتي النسائية بكلماتي الخاصة.
*هل ثمة كُتّاب معاصرون تشعر أنك مرتبط بهم ارتباطاً وثيقاً؟
- في الوقت الحالي أحب الكتب التي تحمل في طياتها قليلاً من الجنون، واللهو، والابتكار، والجرأة. كتب لا تتمخض عن رسالة أو هدف، كتب ليست إلا سحراً خالصاً من الإبداع الفني وجنونه. لذا أجدني مرتبطاً بشكل خاص برواية إيمر ماكبرايد »فتاة شبه مكتملة«. كما أقرأ حالياً لبعض الشعراء مثل جاي برنارد، وريتشل لونج، وأوشن فونج، ووِرسن شاير. كما أنني لا أقرأ الكتب فحسب، بل كذلك اللوحات، والصور الفوتوغرافية، والأنهار، والموسيقى، وعيون العاشقين، والطبيعة، والأشجار. منابع إلهامي لا تعد ولا تحصى وليست محصورة في وسيط أو كيان واحد.
*ذكرت آنفاً أنك لم تستطع الكتابة في بداية جائحة كورونا، غير أنك سرعان ما تحمست لبدء روايتك التالية »العرَّافون« على هاتفك. ما دافع هذه الدفقات الإبداعية؟
- أعتدت كتابة جميع رواياتي ومقالاتي في المقهى. وحينما وقع الإغلاق الأول في بروكسل في مارس 2020، انتابني القلق لأنني لا أستطيع الكتابة في المنزل؛ وحياتي من دون كتابة أمر لا يُحتمل. وفي أحد الأيام، كنت أقف أمام بحيرات إكسيل حينما قفز إلى ذهني اسم هانا، وكأنما كان الاسم متصلاً بصاروخ هبط على مخيلتي. لم استطع تجاهل الاسم والشخصية. كتبت عنها وعن عالمها على هاتفي الآيفون.
*أخبرني عن مشاريعك الأدبية الأخرى في بروكسل؛ مركز الكتابة الذي أسسته وكذلك مهرجان أسمرة-أديس الأدبي.
- في عام 2018 أسست أكاديمية الكتابة الإبداعية للاجئين ومهرجان أسمرة-أديس (في المنفى)، وفي 2020 شاركت دار نشر (Spicemen) في تأسيس جائزة أدبية. والحق أن تأسيس هذين المشروعين يعزو إلى عدة أسباب. مثلاً، أسست أكاديمية الكتابة الإبداعية لإدراكي مدى صعوبة القدوم إلى بلاد جديدة، وتعلم لغتها، والتكيف على ثقافتها. حينما جئت إلى المملكة المتحدة للمرة الأولى تمنيت الذهاب إلى مكان أعبر فيه عن نفسي بحرية. كما أنني لا أفضل عبارة »صوت من لا صوت لهم«. فكل إنسان يمتلك صوته الخاص، واللاجئون ليسوا استثناء. كل ما يحتاجونه هو مكان للتعبير وسرد قصصهم بالطريقة التي يشاءون.
أما بالنسبة للمهرجان فكنت أصبو إلى إتاحة الفرصة لفناني الشتات للتحدث عن الأدب، والفن، والأداء. وقد استرعى انتباهي أنه حينما أُدعى إلى المهرجانات، توجه لي أسئلة عن الحرب والمنفى. وهذا أمر مفهوم؛ فهما جزءان من قصتي. لكن الفن شكّل حياتي أيضاً. واخترت أن أصير فناناً. قضيت عشر سنوات في بروكسل أكتب كتاباً واحداً. وكي أفعل ذلك، أمضيت سنوات من البحث في الفنون والفوتوغرافيا. كنت أتنفس اللوحات، وأصغي إلى الموسيقى، والتحم بالطبيعة. لذا أظن أن التحدث عن الفن، والموسيقى، وقوة الخيال، وغيرها، يعد أمراً مهماً بالنسبة لي وللعديد من فناني الشتات.
*تكتب حالياً عموداً في إحدى الصحف البلجيكية بصورة منتظمة. ما نوع الموضوعات التي تود الكتابة عنها؟
- أشعر بحماس كبير بخصوص هذا العمود. سيكون عن الأفكار، واللغات، والفنون، والطبيعة، والتجول في بروكسل، وتعلم الهولندية. سيكون في جوهره حول أكثر الموضوعات المحببة والملهمة لي.
أنشئت صفحة على تطبيق الانستجرام لتستكشف "الأيروتيكي" في أعمالك. ما الذي تنطوي عليه هذه الخطوة؟
- مازلت وافداً جديداً في عالم الانستجرام، فتمهل حتى أتعلم كيفية استخدامه بشكل صحيح. لكنني أفضل الفن الذي تصوره الكلمات على الصفحات. إن الطريقة التي يندمج بها العري، واللهو، والحسية، والأيروتيكا الأدبية لتوسيع مخيلة المرء، هي طريقة في غاية الشاعرية. لذا حرصت على مشاركة أعمال بعض الفنانين الذين ألهموني وأثاروا في نفسي التساؤلات، مثل ناعومي هاروكاوا، وديجا، وفرانشيسكا وودمان، وليونر فيني، وآخرين.







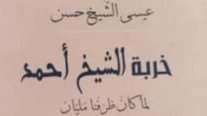



التعليقات