قبل أن ندخل في تفاصيل الردع الهجومي والدفاعي يجب البدء بالمظلة الكبرى التي ينطوي تحتها مفهوم الردع، وهي نظرية الواقعية الجديدة (النيوريالزم)، ويمكن الرجوع إلى مقال (الردع الإستراتيجي قبل أسابيع لفهم العلاقة بين الردع والواقعية الجديدة. وبالمناسبة حتى الواقعية الجديدة أيضا تنقسم إلى فرعين رئيسين: الواقعية الجديدة الهجومية والواقعية الجديدة الدفاعية. والفروقات بينهما تتمحور حول الأهداف والإستراتيجيات التي تتبعها الدول في سياق النظام الدولي الفوضوي: أما الواقعية الجديدة الهجومية: فترى أن الدول تسعى لمضاعفة قوتها لتحقيق أقصى مستوى من الأمن وتفترض أن الدول تتصرف بشكل عدواني لتعظيم قوتها النسبية. وتعتبر أن الفوضى في النظام الدولي تدفع الدول للتنافس والسعي للهيمنة. أما الواقعية الجديدة الدفاعية: فتقوم على فكرة أن الدول تسعى للحفاظ على أمنها وليس بالضرورة تعظيم قوتها وتوكّد أن التوسع العدواني يمكن أن يزعج توازن القوى ويقلل من الأمن الدولي. وتركز على الدفاع والحفاظ على الوضع القائم بدلاً من السعي للهيمنة. أبرز علماء الواقعية الجديدة الهجومية (جون ميرشايمر) ويعتبر من أبرز المنظرين للواقعية الهجومية ومؤلف كتاب (مأساة سياسات القوى العظمى). وأيضاً (جيلبين وراندال شويلر)، ويمثلان أيضًا هذا الفرع من الواقعية. وأبرز علماء الواقعية الجديدة الدفاعية هم: ( كينيث والتز) -الأب الروحي- مؤسس مدرسة الواقعية الجديدة، وإلى حد ما يميل إلى الواقعية الدفاعية. وأيضاً (جوزيف جريكو)، يُعد من المساهمين في تطوير الواقعية الدفاعية، حيث يركز على الحاجة إلى الأمن والدفاع بدلاً من التوسع العدواني و(تشارلز جليزر)، يُعد من العلماء الذين يدعمون الواقعية الدفاعية ويؤكد أن الدول تسعى للأمن وليس للقوة القصوى. هذه النظريات تقدم إطارًا لفهم كيف تتفاعل الدول في بيئة دولية تتسم بعدم وجود سلطة مركزية. وهؤلاء العلماء وغيرهم أسهموا في تعزيز فهم الواقعية الدفاعية، كنهج يركز على الحفاظ على الاستقرار والسلام من خلال السياسات المعتدلة. وكما ذكرنا أن الردع ولد تحت مظلة الواقعية الجديدة وارتباطهما قوي، وكما عرفنا الردع مسبقا بشكل مبسط: «التهديد بالعقوبات والوعد بالمكافأة لكي يمنع الخصم من اتخاذ إجراء حسابًا للعواقب». وكما الواقعية الجديدة هي فرعان هجومي ودفاعي فالردع أيضا يمكن تقسيمه إلى قسمين: هجومي ودفاعي، والفرق الأساسي بين الردع الهجومي والردع الدفاعي يكمن في الغرض والوسائل. الردع الهجومي يهدف إلى منع الخصم من القيام بأي عمل عدائي من خلال التهديد برد عسكري قوي ومدمر قد يتجاوز الحدود الدفاعية للدولة. يعتمد على القوة العسكرية الكبيرة والقدرة على شن هجوم مضاد قوي. أما الردع الدفاعي فيركز على حماية الدولة ومصالحها من خلال القدرة على الدفاع الفعال ضد أي هجوم، ويعتمد على القوات المسلحة والأنظمة الدفاعية التي تضمن الأمن داخل الحدود الوطنية. من العلماء الذين أسهموا في تطوير نظرية الردع نجد برنارد برودي، الذي طرح مفهوم الردع في بداية العصر النووي، وأكد أن الهدف يجب أن يكون تجنب الحروب لا كسبها، وكذلك توماس شيلينج الذي أسهم في تطوير فهم الردع كوسيلة للتأثير على سلوك الدول الأخرى وهناك غيرهم. اما عناصر الردع الهجومي: القوة العسكرية: استخدام قوة عسكرية كبيرة والقدرة على شن هجوم مضاد قوي. المصداقية: الإيمان بأن الدولة ستنفذ تهديداتها. الإرادة السياسية: الاستعداد لتحمل التكاليف السياسية والاقتصادية للردع. التكنولوجيا: الاعتماد على تكنولوجيا متقدمة لتعزيز القدرات الهجومية. عناصر الردع الدفاعي: الدفاعات الإستراتيجية: بناء دفاعات قوية لحماية الأراضي والمصالح. الاستعداد العسكري: القدرة على الاستجابة السريعة لأي تهديدات. التحالفات: تشكيل تحالفات لتعزيز الأمن الجماعي. الردع بالعقوبات: استخدام العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية كوسيلة للردع. الفرق الرئيسي بين الردع الهجومي والدفاعي يكمن في النية والمبادرة. الردع الهجومي يتطلب الاستعداد للهجوم الأول كوسيلة للردع، بينما الردع الدفاعي يركز على الحماية والدفاع عن النفس، وهذا يأخذنا إلى استراتيجية ومفهوم آخر وهو مفهوم {الرعب والصدمة}، استراتيجية «الصدمة والرعب» ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الردع، حيث إنها تهدف إلى إحداث صدمة مفاجئة شديدة لدى العدو لمنعه من القيام بأي تحركات عدائية. إستراتيجية «الرعب والصدمة» العسكرية تهدف إلى إحداث تأثير نفسي ومادي سريع ومفاجئ على العدو لتقويض إرادته للقتال وإحداث الفوضى في صفوفه. هذه الإستراتيجية تتطلب عادةً: التفوق الجوي: لضمان القدرة على شن هجمات دقيقة ومكثفة. القوات البرية: قوات مدربة ومجهزة للتحرك السريع واستغلال الفوضى. الاستخبارات: معلومات دقيقة عن مواقع العدو وقدراته. التكنولوجيا: استخدام أحدث التكنولوجيات للتواصل والتحكم في الأسلحة. إستراتيجية الرعب والصدمة لها مبادئها وحسابتها ومعاييرها والتي قد يطول شرحها لكن الأهم هو تحقيق تأثير مباغت ومربك يعطل قدرة العدو على الرد. العلاقة بين الردع والرعب والصدمة تتمثل في: التأثير النفسي: كلتا الإستراتيجيتين تعتمدان على التأثير النفسي لإقناع العدو بأن التكاليف المحتملة للعمل العدائي ستكون باهظة. القوة العسكرية: إستراتيجية الصدمة والرعب تستخدم القوة العسكرية بشكل مكثف لإظهار القدرة على الردع. الردع الفوري: الصدمة والرعب تسعى لتحقيق الردع بشكل فوري ومباشر، بينما الردع قد يكون أكثر استمرارية ويعتمد على التهديد بالرد في المستقبل. الإستراتيجية تعتمد على إظهار القوة بشكل يجعل العدو يتراجع عن أي نوايا عدائية بسبب الخوف من العواقب الوخيمة هذا النوع من الردع يمكن أن يكون فعالًا في بعض السياقات، لكنه يتطلب تقييمًا دقيقًا للظروف والمخاطر المحتملة. وهذا يأخذنا إلى مفهوم آخر وهو (القدرة على تحمل الخسائر)، قد يكون الردع كافيا في الأحوال الطبيعية أو بين الدول المتوازنة، لكن الردع يجب إعادة تصميمه وتفصيله لكي يناسب الحالات غير الاعتيادية، مثل أن يكون الخصم لا يبالي أو لا يهتم بالخسائر كما بعض الدول المارقة والميليشيات فهنا الردع الطبيعي قد لا يكون كافيا، وتوضع عدة تكتيكات لمثل هذه الحالات، مثل إيجاد مواضع الألم في هذه الدول المارقة والتي عادة تكون مختلفة عن مواضع الألم في الدول الطبيعية، الدول الطبيعة تهتم بالشعب والاقتصاد والرفاه مثلا لكن المارقة قد لا تهتم إلا بسلامة زعمائها أو النظام الحاكم فيها، أيضا مستوى الردع والرد قد لا يكون متناسبا كما الأحوال الطبيعية، فغالبا في هذه الحالة يحتاج تثبيت الردع إلى قوة أو ضربة أو تهديد بأضعاف ما يكون معتادا في الردع التقليدي.
- آخر تحديث :






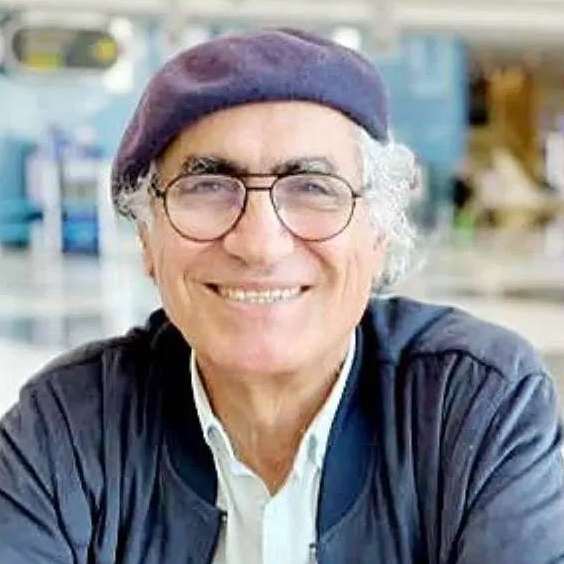

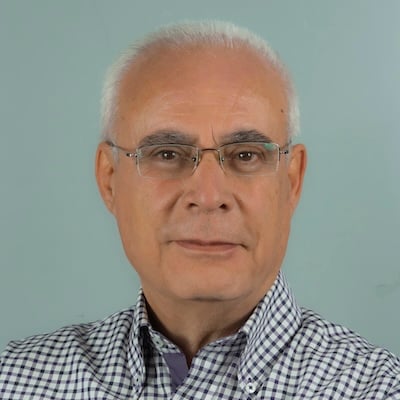
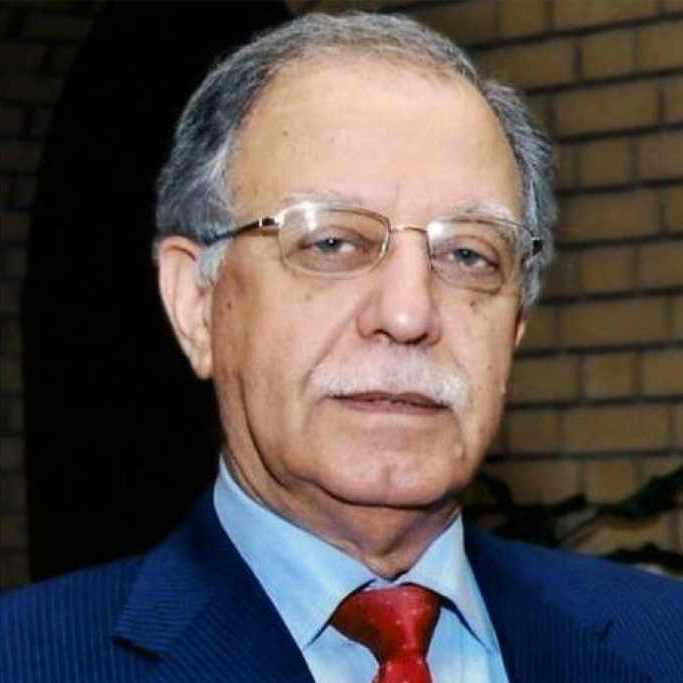




التعليقات