بداية عليّ أن أشير إلى أنني لست مُغْرَما بقراءة الروايات العربيّة مثلما هو حالي مع الروايات الأجنبية، الغربية منها بالخصوص. وقد هزني نجيب محفوظ في سنوات الشباب الأولى، لمتانة بنيته الروائية، وانسجامها مع الشكل المعماري لحواري القاهرة الشعبية، إلاّ أنني سرعان ما انجذبت إلى يوسف ادريس لابتكاره للغة سرديّة متميّزة، وللطيب صالح لدفعه للسرد العربي إلى أبعاد وآفاق لم تكن معروفة من قبل سواء على مستوى الشكل،أو على مستوى المضمون. كما اهتممت بإميل حبييبي الذي تمكن من أن ينحت لغة سرديّة تَغْرفُ من اللغة الكلاسيكية المتينة والأنيقة،كما تغرف من اللغة المحكية ،أو من "الطبق الفولكلوري" كما يقول صاحبها. وقد لفت محمد شكري نظري في ّالخبز الحافي" لعفويته،وصدقه، وتوتر لغته السردية التي تتمز بالإختصار والإيجاز التلغرافي،تماما مثلما هو الحال بالنسبة لإبراهيم أصلان،وعلاء الديب في روايته"زهر الليمون" بالخصوص . وبنهم قرأت كل أعمال محمد زفزاف لأجد فيها ما غذّى تجربتي،وعرفني بأسرار الحياة في المغرب المهمش،والمهمل. كما فتنني كتاب الراحل هشام شرابي"الجمر والرماد" حيث أخذت السيرة الذاتية شكلا روائيا مدهشا. وأقر بإعجابي بكتاب تونسيين أمثال البشير خريف، وجماعة "تحت السور" الذين حَدّثوا الأدب التونسي في الثلاثينات من القرن الماضي، لكن من دون أن يكون لهم تأثير مُهمّ عليّ لغة وأسلوبا. وأبدا لم أتأثر بمحمود المسعدي مثلما حال أغلب أبناء جيلي حتى أن البعض منهم "ذابواّ فيه ذوبانا كليا ليصبحوا صدى باهتا ومُزْريا له.وهناك مؤلفات تونسية كان ولا يزال فضلها كبيرا عليّ. وجميع هذه المؤلفات تتصل بالتراث الشعبي التونسي مثل" الأغاني التونسية" للصادق الرزقي، و"الجازية الهلالية"،و"البدو في حلّهم وترحالهم" لمحمد المرزوقي، أو بالتاريخ التونسي في أطواره المختلفة مثل "أتحاف أهل الزمان" لأحمد بن أبي الضياف. وفي عزلتي في ميونيخ التي أقمت فيها قرابة العشرين عاما، كانت هذه المؤلفات تعيدني إلى أعماق مجتمعي، لتطلعني على أحواله في الماضي، وتكشف لي عن أحواله في الحاضر أيضا، ليكون دائم الحضور في قلبي وفي ذاكرتي من خلال تقاليده،وأهازيجه وأغانيه،وحكاياته،وأساطيره،وخرافاته.
وقد يعود ميلي المبكر إلى الروايات الغربية إلى الصعقة التي حدثت لي بعد أن قرأت البعض منها. وهذا ما تمّ مع"الغريب" لألبير كامو،ومع"الغثيان" لجان بول سارتر،ومع اللأخلاقي" لأندري جيد، ومع"الأمل" ،وّالوضع البشري" لأندري مالرو، و"التحول"، وّالمحاكمةّ لفرانز كافكا.كما حدثت لي هذه الصعقة وأنا أقرأ أعمال دستويفسكي ، وتولستوي، وستاندال، وفلوبير. وكل هذه الأعمال قرأتها باللغة الفرنسية. وفي ترجمات عربية قرأت "الصخب والعنف" لويليام فوكنر ،و"عناقيد الغضب" لجون شتاينباك،و"طريق التبغ" لأرسكين كالدويل، و"الأرواح الميتة" لغوغول، و"جامعاتي" لمكسيم غوركي. ولعل أعظم وأجمل ما قدمته لي هذه الروايات هي أنها جعلتني أكتشف ثراء الواقع الذي كنت أعيش فيه،والذي كان يتراءى لي من قبل خاويا،وسطحيّا،ومبتذلا. لكن بعد أن قرأت الروايات المذكورة، تبدّى لي طافحا بالقصص والحكايات العجيبة، ومسكونا بشخصيات طريفة ،وتراجيدية. ونفس هذه الروايات هي التي أنقذتني في ما بعد من التأثيرات السلبية للإيديولوجيّات اليسارية التي بها إنبهرت في فترة من حياتي اقتصرت خلالها على قراءة المنشورات السياسية،والأدبيّات الشيوعية ،وشهادات مناضلين شيوعيين عن السجون،وروايات تنتمي إلى ما يسمى ب"الواقعية الإشتراكية". وعندما خرجت من هذه المرحلة الإيديولوجية التي خلفت أوجاعا،وآلاما نفسية وجسدية، إكتشفت أدباء أمريكا للاتينية أمثال غابريال غارسيا ماركيز، وخورخي لويس بورخيس، وماريو فارغاس لوسا، وجورج أمادو وغيرهم. وقد وجدت في روايات وقصص هؤلاء ما أعاد لي الحيوية، وشفا روحي الذابلة، وفتح عيني على حقائق جديدة وأنا آنذاك في القيروان نهاية السبعينات من القرن الماضي. وهناك بالقرب من قريتي التي فيها ولدت ونشأت، أعدت علاقتي بفضاء طفولتي الجغرافي والروحي، وبأشجار الزيتون واللوز، وبالدروب الرملية ،وبحلقات الذكر، وبالمزارعين الفقراء،.وبصبحة هؤلاء ، كنت ألعب الورق، وأشرب الشاي المر، وأدخن سجائر بخسة الثمن، مُستمعا إلى حكاياتهم البديعة عن مختلف شوؤن الحياة،وأيضا عن الموت والحب والخيانة وجراحها التي قد تظل نازفة لأمد طويل. وكانت مجموعتي الأولى"حكاية جنون إبنة عمي ه هنيّة" الصادرة عم 1985 ثمرة هذه التجربة الجديدة. وجميع قصص هذه المجموعة تغرف من التراث الشفوي ،وتروي قصص أهل الريف في منطقة القيروان وهم يواجهون رجالا وأطفالا ونساء وشيوخا القحط،والجوع، والوحدة،والموت.وأغلب الشخوص في هذه القصص هم أناس عرفتهم،ومعهم تقاسمت الرغيف اليابس، والماء والملح. لذا لم أشأ أن أغيّر أسماء االبعض منهم.
بعد إنتقالي للعيش في أوروبا،وتحديدا في مدينة ميونيخ الألمانية، عرفت مسيرتي الأدبية منعرجا جديدا. ورغم أنني كنت أجهل اللغة الألمانية، فإنني قررت أن اخوض تجربة الغربة وأنا على يقين من أنني سأجترح منها ما يمكن أن يعمق تجربتي في الحياة وفي الكتابة. وفي البداية، عشت الضياع وسط عتمة اللغة فكان كل شيء يمثل أمامي شائكا ومعقدا وغامضا. و كنت أحسّ أنني مثل روبنسون كريزوي في تلك الجزيرة النائية .ومثله كان عليّ أن أعيد ربط الصلة بالواقع الخارجي، وبما يحتويه من أشياء،ومن تفاصيل، ومن روائح،وألوان. وعندما يشتد عليّ ثقل الوحدة،أهيم على وجهي في الشوارع، أو في "الحديقة الإنجليزية" مستعيدا ذكريات طفولتي في الريف القيرواني. وتحت تأثير تلك الذكريات، كتبت قصصا مثل "السلحفاة" ،و"وجوه".وأحيانا كانت كوابيس الغربة تتحول إلى مواضيع لبعض القصص مثل"هنغاري"،و"ليلة الغرباء"،و"باد فوسينغ"، و"ترومان كابوتي"، و"البحث عن بيت الجدة"
وفي الغربة المختارة ،اتخذت علاقتي باللغة شكلا آخر،وأبعادا أخرى. فاللغة الأم هناك في المدينة التي اخترت أن أعيش فيها، لم أكن أتكلمها،ولم أكن أسمعها. وفي المرحلة الأولى، أصبت بالرعب إذ أنني اعتقدتّ أن هذا الأمر،أي عدم تكلم اللغة الأم،وعدم سماعها، سيصيبني بالعقم، ويفقدني القدرة على مواصلة الكتابة. ولكي أحافظ على توازني، رحت أكتب رسائل إلى صديقات،وأصدقاء في وطني،وفي بلدان عربية أخرى، لمعاينة درجة القدرة على المحافظة على اللغة الأم. وغالبا ما كنت أقرأ تلك الرسائل بصوت عال في الليل مُسْتَعذبا رنين الكلمات ، وموسيقى الجمل. لكن شيئا فشيئا بدأت أشعر أن العلاقة مع لغتي الأم أصبحت أكثر حميميّة من ذي قبل. فلقد أصبحت "لغتي السرية" بحسب تعبير إلياس كانيتي الذي واصل الكتابة ب باللغة الألمانيّة رغم أنه كان قد اختار الإستقرار قي سويسرا، ثم في بريطانيا. وها لغتي الأم تحوي الآن كلّ ماضيّ،وكلّ الأحداث التي عشتها، وكلّ الروائح التي شممتها، وكل الإغاني والأناشيد الدينية التي سمعتها، والمشاهد التي توقفت عندها. إنها مُسْتودعُ أسراري، ووطني في الغربة. لا أحد يشاركني في حبها مثلما هو الحال في بلادي. لا التلفزيون،ولا الجرائد، ولا الواعظ الديني بفتاويه الصفراء، ولا الرقيب بسحنته العابسة،ولا الشرطي الذي يراقب حركاتي وسكناتي،ولا رجل السياسة الذي يكذب لأن الكذب وحده يتيح له البقاء في السلطة لأمد طويل. لغتي الآن لي وحدي. وقد قوّض هذا الإحساس كوابيس الغربة،وجعلني أستعيد حيويتي، وأقول لنفسي في آخر الليل وأنا في حانة أستمع فيها إلى موسيقى الجاز بإنني إذا ما متّ في برد غربتي فلن أكون وحيدا، بل سأكون في أحضان لغتي الأم.
وقد قادتني الأسئلة التي تولّدت في ذهني بشأن مصيري الجديد،وعلاقتي بلغتي الأم ، إلى التعمّق في قراءة كبار المنفيين من الكتاب والشعراء أمثال جيمس جويس، وصاموئيل بيكت، وفلاديمير نابوكوف ، وفيتولبد غومروفيتش. وقبل ذلك كنت قد قرأت أعمال البعض من هؤلاء وأنا في تونس. إلاّ أن قراءتي لهم وأنا في الغربة كان لها مذاق آخر،ومتعة أخرى. فهم الآن قريبون مني. من خلال أعمالهم أتلمّسُ طريقي في العتمة، وبمساعدتهم أعثر على أجوبة على الأسئلة التي طالما أرقتني في ليل غربتي،ومنهم أستمدّ القوة لمواصلة مغامرتي مجهولة العواقب.وقد أحدثت قراءتي لرائعة جيمس جويس"أوليسيس" ،وأيضا سيرته التي كتبها الأمريكي ريتشاردايلمان، رجة في كياني. وها أنا الآن أدرك معنى أن يختار المبدع المسافة بينه وبين الوطن الأم ،وبينه وبين اللغة الأم، لكي يتمكن من إنجاز عمل فني عظيم.
وكان البولوني فيتولد غومروفيتش اكتشافا مهما بالنسبة لي. فقد ترك بلاده عشية الحرب الكونية الثانية ليمضي أزيد من عشرين عاما في الأرجنتين .بعدها عاد إلى أوروبا ليعيش سنتين في برلين ،ثم في جنوب فرنسا حيث توفي عام 1969. وقد أتيت على جلّ مؤلفات غومبروزفيتش بما في ذلك يومياته. وكانت قراءتي لأعماله بمثابة رحلة عجيبة في عالم عجيب. وفي نصّ له،وضّح غومبروفيتش الأسس الجمالية التي تقوم عليها أعماله الإبداعيّة .وهذه الأسس هي:الشباب،والجمال، والإيروسية .عن ذلك كتب يقول:»تأملوا قليلا في مصير الإنسان الحديث. إنه وحيد بدون إله. بدون سماء. كلّ محاولات الجمال الخارجيّة تمّ تقويضها من قبله. أين يمكن إذن للإنسانية الحديثة أن تعثر إلى حدّ هذه الساعة على مصدر للإفتنان،والإغتباط،والنشوة؟ إنها لا يمكن أن تعثر على ذلك إلاّ في داخلها، في أعماق كيانها، في شبابها الدائم، في تفتحها الذي ينبثق من كلّ جيل جديد.الجمال اليوم هو إذن الشباب. لكن الشباب هو أيضا،وللأسف ، الدونية. وهذه مُفَارَقَة مؤلمة،وصعبة في نفس الوقت. من جانب آخر، الإيوروسية هي أيضا المفتاح الذي يفجّرُ القبحَ، وكلّ ما هو بشع، ومُقَزّز، وغير مقبول أبدا. وهذا لا يمكن أن يتم بسهولة وبخفة. علينا أن نعرف لماذا وكيف ننطلق من هذا الطريق. وأعتقد أنه عند الوصول إلى هذا الحد ، لا بد أن يكون الفنان شاعرا، شاعرا بالخصوص ،وشاعرا قبل كلّ شيء. ثمة من يصفني بالمنحرف،ويتهمني بالهوس الجنسي، وبالتلصص، إلخ... لكن كل هذه الإتهامات أكاذيب سطحية وسخيفة". مثل هذه الرؤية للكتابة تكاد تكون منعدمة في الرواية العربية. وعندما نعلم أن غومبروفيتش لا يزال مجهولا في العالم العربي حتى من قبل من يمارسون كتابة الرواية، فإننا ندرك الأسباب الحقيقية لأشياء كثيرة . منها مثلا أن الكتابة تحولت عند البعض من الروائيين إلى شكل من أشكال التلفيق والشعوذة والكذب في معناه الأشد قبحا وإثارة للإشمئزاز. كما أن البعض من الروائيين الذين حصلوا على شهرة مزيفة أصبحوا يبيحون لأنفسهم الإستسهال والثرثرة الفارغة متخفين وراء قضايا كبيرة بهدف إخفاء خوائهم،وفراغ أعمالهم من كل ما يمكن أن يطور الكتابة الروائية عندنا سواء على مستوى الشكل،أو المضمون،أو الرؤية الفنية الفكرية.
وعليّ أن أشير أيضا إلى أنني تعلمت الكثير من أعمال هنري ميللر ،منها بالخصوص أنني تحررت من الأنماط السائدة لأبدع أعمالا إنطلاقا من تجربتي الخاصة.وهذا ما حدث مع "هلوسات ترشيش"، ومع "الآخرون"، ومع" وداعا روزالي"،ومع أعمال أخرى، آخرها"بحثا عن السعادة" التي أروي فيها فصوولا من حياتي مع الكتب .
بعد عشرين سنة من الغربة ،عدت إلى بلادي. وقد رسمت صورة مفصلة لعودتي في مطلع روايتي "محن تونسية " التي أروي فيها فصولا من تاريخ تونس . والآن أنا أعيش في ما يمكن أن أسميه ب" منفى داخلي". فيه أواصل الكتابة بحمية وحماس بعيدا عن الزعيق والنعيق . وأعتقد أن التجربة التي حصلت عليها من العيش في الغربة قادرة على أن تحميني من كلّ الشرور والمساوئ التي تتخبط فيها الحياة الثقافية التونسية خصوصا خلال السنوات التي أعقبت إنهيار نظام بن علي حيث تكاثرت المافيات الثورجية التي لا تهمها الثقافة في معناها النبيل والإنساني، بل هي تحشد كل جهودها لخدمة مصالها الخاصة ،مقصية المبدعين والفنانين الحقيقيين ،ومجبرة إياهم على العيش في الصمت والعزلة حتى تتمكن من مواصلة لعبة النزييف،والتزوير والإبتذال التي لا تتقن غيرها.
*نص المداخلة التي قدمها الكاتب في ندوة "الأدب والهجرة" في الدورة الأولى لمعرض الكتاب بمدينة وجدة المغربية التي انتظمت بين 21و24 سبتمبر 2017&












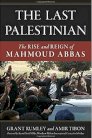




التعليقات