السويد خاص بايلاف: وضع الأديب برهان الخطيب جمهور صالة هوسبي الكبيرة للفن في ستوكهولم في حيص بيص حين قرأ عنوان محاضرته (نحن نفكر) ثم عقب ذلك بسؤال للجمهور مبتسما: هل ثمة اعتراض على العنوان؟ لم يرد أحد، من ذا يجرؤ على التفكير والرد خلاف ذلك، طبعا نفكر! وإلاّ اتهموا المعترض بتخلف عن الركب الثقافي. هكذا واصل الخطيب: إذن مَن المقصود بـ quot;نحنquot; ايها السادة؟ نحن الروائيين؟ نحن البشر عموما؟ أو نحن برهان الخطيب على غرار نحن الملك فيصل؟ أو نحن الموجودين هنا؟ لم 
بدعوة من جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين في ستوكهولم بمناسبة صدور رواية برهان الخطيب ذائعة الصيت (الجنائن المغلقة) طبعة ثانية شعبية عن وزارة الثقافة العراقية في جزئين التقى رواد صالة هوسبي الكبيرة للفن مع الروائي الخطيب في حديث عن تجربته وروايته، تصور حياة عراقيي الشتات والوطن على خلفية أحداث العقود الأربعة الأخيرة، سباقة بهذا النوع الشمولي بين روايات اليوم. كلمة برهان الخطيب عبَرت من الخاص إلى العام، كعهده حين يتكلم، متناولة العديد من القضايا الأدبية المثيرة للجدل. هنا شذرات منها:
اجتمعنا أيها السيدات والسادة لنتحدث في شأن ثقافي، تحديدا عن تجربتي الأدبية اقترح الأخوان من الجمعية التشكيلية، قلت تكلمت في هذا سابقا، الأفضل لو سمعنا الفنانين عما قرأوا، هكذا يكون الكلام بل الحوار أمتع. بالنسبة لي ليس سهلا تماما الكلام في هذا الموضوع أو غيره، حين أبدأ تتدافع عشرات الحقائق والتفاصيل لتأخذ حيزا في ما يقال، هذا ليس لتشتت وتشعب الموضوع أمامي، بل لارتوائه من مصادر وتفاصيل عديدة. البعض يطرح فكرته تلاءمت أم لم تتلاءم مع الوسط وبيئته الفكرية، غير مهتم لتناقض محتمل مع ما حولها. طبيعي، الناس يعّبرون حين يتكلمون عن مصالحهم عادة، دون أخذ مصلحة المقابل أحيانا في الاعتبار، لذلك تحدث مشاكل، يحدث اصطدام، تبدأ محاولات الالتفاف حول العقبة، التفاوض في حال أفضل، لوصول الى تسوية، بين تصورنا وتصور الآخر.
للتفكيرمراحل
لماذا هذه المقدمة؟ تبدو ضرورية لي، الروائيون أنواع طبعا ككل الكائنات، إنما يتشابهون بعملهم في الملائمة والتفريق بين الثانوي والأساسي والاستثنائي، لدفع حوار معلن أو خفي إلى أمام، هكذا تنمو رواية، حسب أخلاق وتصورات كاتبها. بالنسبة لي اكتسبت من الرواية، وربما قبلها، بالهندسة، طريقة تفكير عقلانية، طرقت وصُقلت بالكتابة، طريقة تعطي الآخر حقا للمساهمة في نحت فكرتي، أي أنني أفكر فيه وقت أفكر بالأنا، هذه مرحلة أولى لتفكير، ينطلق منها آخرون، غربيون مثلا، لصياغة أفكارهم، يتفاهمون أسرع منا، ويتباعد دائرون حول انفسهم مثل بعضنا. مرحلة ثانية تجعل التفكير أكثر خصوصية، تتلخص بملاءمة ما أفكر فيه لذاتي، وما أفكر فيه للآخر، لهذه الشخصية الروائية وتلك. بعض مَن يفكر بهذه الكيفية يستغل هذه الثنائية لسبر المقابل، قصد تصعيد الأنا، والتغلب عليه.
أكشف سمة أخرى لتفكير روائي، أو تفكيرك: ثمة مرحلة ثالثة. مراحل يقطعها عقلنا في ثوان طبعا، أثناء كلام للوصول إلى الكلمة التالية، منتقاة للتعبير عما أريد أو تريد قوله، يتحرك اللاوعي كما يقال تحت الكلام لينتج الكلام الواعي. إذن المرحلة الثالثة ما هي عندي؟ أن أجد لا ما أتغلب به على المقابل، بل ما يقوي حجته، يرفعه أمامي، لأنتقل الى الخطوة الرابعة، وهي رفع نفسي أمامه، ثم رفعه، هكذا يستمر التفكير سعيا الى حقيقة لا يمتلكها أحد، سواء كتبت رواية أو تكلمت، حتى مع كائن قد لا احترمه، هذا إبداع في رأيي، أكان في شارع أو مكتب، هكذا تنعدم مسافة بين الادب والحياة. لكليهما شئ من مثالية عندي. بعضكم قد يفكر، لماذا يتعب برهان نفسه هكذا؟ جوابي: لأني أشعر أن الوجود بغموضه، والمجتمع بمشاكله، ممزقان، عليّ واجب جمع اشلائهما، لأفهم أفضل، لأجعلهما مكانا مريحا للعيش، لي ولغيري. آخر أكثر واقعية مني يرى ربما الدنيا عراك، حتى الحب جعله سارتر حربا بين اثنين، لا أوافق على هذه الاطروحة، أراها بقايا بربرية. 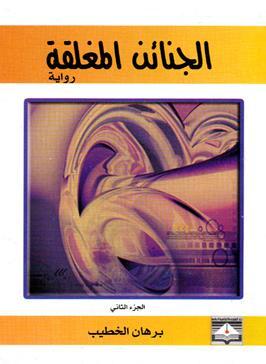
كان في إمكاني طبعا تجنب الاعتراض، لتمرير تفوق خفي على نزعة شك عند سامع تدفعه لاعتراض حقا.
المتلقي رفع وكبس
بهذا الرفع أو غيره للمتلقي أضع أمامي عقبة، تحديا، عليّ الاستجابة لا الهرب، لأكسب الاهتمام من جديد. يمكن تجاوز العقبة بطريقة فجة، كأن أقول لا علاقة لحياتي الخاصة بأدبي، أو لا علاقة لهذا السبب بتصرف هذه الشخصية الروائية أو تلك، أجفف مصادر الموضوع، لا أزج نفسي في مشكلة مع قارئ ورقيب، لكن المستمع أو القارئ الفطن ينتبه للإنهزامية، يصبح معاديا للنص، تنكسر الصلة بينهما.
لاحظوا يمكن استبدال الروائي هنا بالسياسي مثلا، القارئ بالمواطن، وانعدام الصلة بالنص باغتراب المواطن في وطنه. نحن نتكلم عن أشياء عديدة في وقت واحد. هذا ما يسمى: تحت النص، أو تحت الواقع، غير المرئي عادة لمن لا ينقب في التفاصيل.
بعرض منابع التوتر والالتقاء والافتراق والارتقاء، يدفع روائي أو غيره حديثه اليومي أو إبداعه إلى صعيد أعلى، بالصدق يكون الغموض مشرقا، هكذا يكون كتاب أو حضور متطورا مطوِّرا صاعدا. الصدق طوق نجاة أيضا للروائي، خاصة حين يَغرق في حقائقه وتفاصيله، والذاكرة أكثر من ضرورية دائما. علينا تذكر كل ما قلناه وكتبناه وقرأناه لغيرنا كي لا ننقض أنفسنا ولا نكرر غيرنا فيسقط الخطاب في الافتعال أو العادية أو حتى الابتذال.
حاولت تبيان كيف يفكر روائي، أرجوكم لا تنسوا ضعوا في اعتباركم أقصد بالروائي الإنسان عموما، أنتم مثلا، أنا، الروائي يؤلف على الورق، غيره شفاها بين عائلته وأصدقائه. قلت لا أفصل بين الأدب والحياة، غيري يفعل، هنا لعلي أخرج عن واقعيتي، أو هي واقعية من نوع خاص لم تعرّف، لأن (تأديب الحياة) هكذا يعطل المشاعر العدوانية، هكذا يكون الروائي حيوانا أليفا بين كواسر ومفترسة.
عرفنا إذن كيف يفكر روائي، فماذا عن ما يدخل في تفكيره، ما يغذي عبارته، ويؤسس لخطابه العام؟ له ينبوعان أساسيان في رأيي، تجاربه الشخصية التي تغذي عبارته، والوضع العام حوله الذي يساهم في صياغة خطابه، حسب انتباهه واستيعابه طبعا، لو كان يؤمن بأي خطاب. نقاد يعتبرون أنفسهم حداثيين يقولون: خليك من المجتمع، أكتب من نفسك لنفسك، القارئ لا يريد أن يدوخ مثلك. هكذا ترتفع موجة أدب ذاتي محدود، يعرض المواضيع مبتسرة في منطقتنا. على صعيد أعلى أرى في أوربا وغيرها أدبا مهتما بالذات والمجتمع في آن، نجح في تقديم قارة بل العالم، من خلال اشخاص معدودين، أتذكر هنا ماركيز، شتاينبك، كالدويل، شكسبير، مالرو، ستندال، تولستوي، وغيرهم. عندهم تمتزج كل الينابيع في واحد. نعم، تجارب الشخص من افرازات فئته ومجتمعه عموما، إذن الانكفاء على التجربة الذاتية فقط يفقر الموضوع. يمكنني مثلا اليوم كتابة رواية عن ليلة حمراء مررت بها أمس متغاضيا عما يحدث بعيدا، إرضاء لذوق ناشر أو تاجر كتب ما، وتكون الرواية مشوقة صدقوني، لكني لن أفعل هذا، رغم سهولة المهمة وإغراء المردود، ضميري ينبهني لليالي الشعب العراقي الحمراء أيضا، الحارقة الآن، ينبهني لكل مشاكل العالم. حين أضمّ تجربتي الشخصية للتجربة العامة في مشروع كتاب يأتي مُرضيا، مبرَّرَا، لتقديمة لوسط واسع من القراء بسعة موضوعه.
على الطرف المقابل
الخارج يؤثر في خياراتنا كما تؤثر ذواتنا فيها، مرة أخرى يهتف ناقد: معلوم طالما اخترنا، تأثير الخارج والذات واحد هنا. لكن هذا ليس مضبوطا تماما. نعرف التأثير السلبي لديكتاتورية على فكر وكتابة كتاب اختصروا طموحاتهم وقولبوها كما أرادت الديكتاتورية، النتيجة موت أعمالهم مع موت الديكتاتورية، هذا عندنا في الشرق. على طرف مقابل، أكثر حرية في الظاهر، يقولب غيرهم أيضا أفكاره، حسب متطلبات دور نشر ومؤسسات تريد للأدب السير في اتجاه تراه صحيحا مناسبا لها، تنبذ الكاتب لو شذ، تتركه في الوحدة والاهمال، فرديته هنا طاغية بطريقة غير مناسبة لأهدافها المعلنة وغير المعلنة.
خُيّل لي أن دعوات الالتزام بقوة الشخصية والتمسك بالفردية كما عند إبسن وغوته ونيتشه وغيرهم من دعاة الإرادة ما ظهرت وشاعت إلآّ في أماكن تسحقها وتنبذها، كرد فعل، لاحساس بذلك، بهوان الكاتب وخطابه.
أعود وأقول: كيف يشكل كاتب تعبيره؟ يعتمد على ثقافته طبعا. لاستعداده البيولوجي دور أيضا في تشكيل خياره وخطابه، ليس الجميع على استعداد لمواجهة نواقص حولنا، البعض يفضل غض النظر والاستفادة من المتاح، فيخفض صوت ضميره الذاتي، يعلي الصوت المطلوب سماعه في الخارج، يحصل على كسب نعم، يأخذ مكان غيره في محفل أو واجهة، هكذا تتراجع النوعية والجودة، ترتفع السطحية والابتذال، هذا في مجتمع يبدأ فقدان احترامه لنفسه، لرموزه، هذا يحدث طبعا، يحدث معه أن يتمكن كاتب مثابر الوقوف جوار ذلك البعض، أعلى ربما، لكن مقابل وقوف مثابر واحد نرى عشرات التافهين أمامه يغطون عليه. هكذا هو حال كتّاب، فنانين، غيرهم، هكذا يكون.
أظن منكم مَن يفكر الآن: برهان حوّل كاميراه مرة أخرى من ذاته، من الكاتب، إلى الجمهور العريض. لكن مسائل المجتمع نفهمها ونتعامل معها كما نريد، كما يسمح لنا استعدادنا الثقافي والبيولوجي بقوله، فلماذا يحفر برهان تحت عروش وكروش ولا يمتحنا أو يمتعنا بكلام واضح محدد عن شئ نراه ونضعه في جيبنا؟ طيب، ما زال كلامنا يمخر في مياهنا الإقليمية، نبقى نصطاد فيها أو نبحر إلى أعالي البحار؟ هذا يعتمد على استعدادنا البيولوجي والثقافي قلنا، إذن مَن يريد الاكتفاء بمياهه الإقليمية يرجع الى شاطئه، إلى طائفته، قوميته، حزبه، مَن يبغي الأعالي يصعد.
قبل هذا اهمس لاقليميين، يعرف بعضكم برهان لم يعتل أحد كتفه، ولا اعتلى هو كتف أحد. بعثيون، شيوعيون، ليبراليون، سلفيون، المهم اخلاقهم لا برنامجهم، بالبرنامج السياسي كلهم مع الشعب، بالأزمة الأخلاقية، في العراق والعالم، النتيجة من سيئ إلى أسوأ. إذن هو اقليمي، وطني، فلماذا يريد الصعود الى الأعالي واصطحاب حالمين؟ يبغي رفع ذاته فوق غيره؟ ما تكلم عن الوطن والمجتمع في هذا الحال، كان تبختر طاووسا فارشا كلماته الملونة أجنحة تأخذ إلى وهم، عدم، أو هدم، ما شأنه! إذن ثمة شئ عن الاقليمية، عن الوطنية، يريد ايصاله، نيابة عنكم؟ لغيركم؟ هل يطرح نفسه أنموذجا؟ لمجموعة؟ لجمهور أوسع؟ لعل هذا هو قصده بالصعود إلى أعالي البحار؟ أن يجعل الوطنية الاقليمية متمما لا نقيضا لصعود إلى أعالي البحار، هاجسه حل مشاكل بلا مصادمات، هذا كلام بحار طبعا، كلام مثقفين ملون، يتفاهمون وإن اختلفوا باللون أو اللغة، جمعهم ايمان بمستقبل بشري واحد، لا كلام ساسة أسود وأبيض، كلٌ متحصن على شاطئه وهواه، متراجمين بالغيب لا يعرفون العيب ولا متراحمين برحم الوطن.
اخرج من هذا لأقول: تجربتي الأدبية الحياتية اعتمدت وتطورت برغبة في الفهم الذاتي والتعبير عنه، وعن ضيقي بالواقع، بالصور المكتوبة، تجاه حلم يتألق رغم تكاثف ظلام، ظلام قد يلفك حتى وأنت في عاصمة للنور. ما قبلت الأفكار الجاهزة، أكانت أرضية أم غيبية، لهذا تحولت من الهندسة المتزمتة إلى الكتابة الرحبة، هل في هذا بعض الشذوذ الحميد عن المألوف؟ لا استعيبه، ولدت مسنونا على أي حال، حمدا لأبي، تلقفني بحضنه وذراعيه بعد رميي من السطح، للمرور حسب بدعة جدتي من بوابة الموت، هكذا أبعد عن البيت عينا حاسدة ومستغربة تلك الولادة الغريبة.
الأَجرام والرموز
شغفت في صباي برؤية ما في داخل الشمس والقمر والنجوم، حدقت فيها من سطح بيتنا حتى تأذت عيني. حين كتبت بعد سنوات قصة (الطفل والشيطان) اكتشفت أنني بحثت في تلك الأجرام عن المعاني الأرضية والكونية الأشمل. عرضَت القصة أجرامَها رموز، لاحقا في رموز رأيت الواقع، هكذا، بالتحليل والتركيب نقبت في قلب الأشياء عن حقائق، لا تعرض أمامنا حتى اليوم كما هي، بل كما يريد لها أب، سلطة، وضع بشري مقيد لإحلام وطموحات وإمكانات ذاخرة فينا. هل رأيتم كيف يعاني فلسطيني عند المعابر من أجل أن يجني زيتونه؟ وكيف يعاني طفل عراقي في ذهابه الى مدرسته؟ وكيف يشقى مثقف عربي حر من أجل أن ينشر كتابه؟ بطولة السيف أمس أصبحت اليوم بطولة الغصن والقلم. لكن أمورنا تتدهور، هل نحن نسير من سيئ إلى أسوأ حقا؟ أو أننا بكبح الجماح نتمدن أكثر ولا ندري؟ قد يبدو هذان السؤالان متشابهين، إذن مدنيتنا سيئة؟ اصلاحها شأن عريض في هذا الحال. وقد يكون هذان السؤالان مختلفين، إذن يجب التفكير في الأسس والأوليات، ولكي لا يقال: أعلِّم ولا أتعلم، ما فعلته شخصيا منذ صباي ترون رفضت التقولب. ومنذ وعيي بالكتابة، ورغم اغترابي، وربما بسببه، ربطت التمدن بمزيد من التأنسن، لا بمزيد من عراك واغتراب، فردي أو عام. خصام والدي وجدي استمر رغم سعيي لمصالحتهما استمرار خصام قوى سياسية وطنية فيما بعد سعيت أيضا بالقلم والكلمة لمصالحتها.
هل يعني هذا لا دور بعد للمثقف في عالمنا المعاصر غير التعليق على الأحداث والترفيه كما نقرأ ونسمع اليوم؟ كل يجيب على أسئلته بطريقة خاصة تشارك في صياغة مصيره قلنا. بالنسبة لي لم يناسبني ولا يناسبني أن أكون كومبارس، وصلنا منعطفا حادا، بل مفترق طرق، الثقافة والأدب يتحولان سلعة، خاضعة لقوانين السوق، قانون العرض والطلب. أكتب ما شئتَ لكن كتابك لن يوضع في واجهة إذا لم يستوف الشروط المطلوبة المحددة من أهل سوق عارفين، صانعين لأمزجة القراء والآراء، نافعة بعد حين لتلبيسها أصواتَ انتخابيةً، لممثلي شعب مختارين، من غير الناخب أولا ثم منه، وإلاّ فضائح قد تنتظره، قد تسقطه حتى قبل الانتخابات، إذا لم يأخذ هو أيضا مثلك اعتبارات السوق بميزان. إذن أمامك أيها الكاتب الانكفاء على نفسك في زاويتك، لو فضلتَ الكتابة كما تريد، وكن عبقريا، كن ما شئت، لكن أحدا لن يدعوك لتوقيع كتابك لجمهور. خيوط اللعبة في يد ماهرة. لا دور لك سوى دمية ناطقة، اكتب وانطق كما نريد تفوز مثلنا فوزا عظيما.
قد يجد البعض حلا وسطا، يذوب في تجمع أو حزب يرضي تطلعاته، فيفيد ويستفيد، كما فعل فرمان وغيره. هذه صورة قاتمة طبعا، إزاءها ماذا تفعل نفس لا تقبل الترويض؟ تشطب نفسها كما فعل مهدي علي الراضي، أو لم يفعل؟ تتلاشى كمدا كما فعلت نفس عبدالله الخطيب؟ تصمت أو شبه تصمت كما فعل محمد خضير والبعض؟ تواصل التحدي دون اهتمام بالنتائج كما يفعل عبد الرحمن الربيعي وأنا وعشرات غيرنا؟ تبدو لي الخيارات متاحة، ليس فقط في الجنة، إليس في هذا إذن مدعاة لكثير من الفرح والمسرة؟! دعونا نضحك رجاء! لكن ليس بصوت عال، كي لا يقال عنا كلمات لا ترضينا. شكرا لدعوتكم وحسن استماعكم.






التعليقات