عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: يمكن تلخيص وصف المؤرخ اليوناني هيرودتس -عام 460 قبل الميلاد- لمدينة بابل بأنها ليس كمثلها مدينة؛ إذ يقول: quot;لا توجد مدينة تشبهها في روعتها في العالم الذي نعرفهquot;.
هذه المدينة التي يحيل إسمها إلى قدسيتها فهي quot;باب إيلquot; أي باب الإله، أو بوابة الرب التي تشير المرويات الى أنّها quot;كانت ذات أسوار يبلغ ارتفاعها 350 قدماً و سمكها 87 قدما وكانت لهذه الأسوار مائة باب مصنوع من الذهب ولكل باب قوائم وسقوف من الذهب وأبرزها 8 بوابات أفخمها بوابة عشتارquot;، الموجودة اليوم في متحف برغامون بجزيرة المتاحف في برلين. وبنى رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين نسخة أصغر منها في بابل كمدخل لمتحف لم يكتمل واتخذت القوات الأميركية معسكراً لها في المدينة الأثرية، وتسببت بتدمير وإهمال أجزاء منها واختفاء قطع أثرية أيضا وفق تقارير صحافية. إذ لايمكن وضع تصور مسالم يجمع العسكر كرمز للقوة والقسوة وآثار تشكو أصلاً وترنو لمن يسعفها من سياط الرياح ومعاول الإهمال..jpg) تتبادر صور بابل وعظمتها المنكسرة في أي منجز إبداعي يحمل اسمها، وكان لفيلم (إبن بابل) للمخرج العراقي محمد الدراجي الذي بدأ بتصويره عام 2008، أن يدخل تاريخ بابل في قصته المأساوية ليمنحه قوة توثيقية يمكنها أو تزيد من صدقية المخرج والكاتب في الآن ذاته محمد الدراجي الذي يمكتلك مشروعاً يصر على إنجازه يتمثل بفضح ممارسات النظام العراقي السابق من خلال ماينجره من أفلام - سلسلة- يربطها تأريخياً كشاهد على السجل القمعي للنظام السابق. إذ ياتي هذا الفيلم الثاني بعد فيلم quot;أحلامquot; الذي عرض فيه الدراجي المرحلة الانتقالية في العراق من العيش تحت نيران القمع وخطر الموت الى سقوط النظام وماتخلل ذلك من تطورات دراماتيكية مستشرفاً فيه ما آلت إليه الأحداث في العراق.
تتبادر صور بابل وعظمتها المنكسرة في أي منجز إبداعي يحمل اسمها، وكان لفيلم (إبن بابل) للمخرج العراقي محمد الدراجي الذي بدأ بتصويره عام 2008، أن يدخل تاريخ بابل في قصته المأساوية ليمنحه قوة توثيقية يمكنها أو تزيد من صدقية المخرج والكاتب في الآن ذاته محمد الدراجي الذي يمكتلك مشروعاً يصر على إنجازه يتمثل بفضح ممارسات النظام العراقي السابق من خلال ماينجره من أفلام - سلسلة- يربطها تأريخياً كشاهد على السجل القمعي للنظام السابق. إذ ياتي هذا الفيلم الثاني بعد فيلم quot;أحلامquot; الذي عرض فيه الدراجي المرحلة الانتقالية في العراق من العيش تحت نيران القمع وخطر الموت الى سقوط النظام وماتخلل ذلك من تطورات دراماتيكية مستشرفاً فيه ما آلت إليه الأحداث في العراق.
ثم جاء فيلم بن بابل الذي تدور أحداثه عن المقابر الجماعية التي ضمت رفات مئات الالاف من ضحايا نظام صدام.
لعل عنوان الفيلم يمنح المتلقي تصوراً لما سيشاهده من قصة تبدو غريبة لجهة علاقة العنوان بمحتوى الفيلم.
لكن غابت المدينة التي ليس كمثلها مدينة، أو حسب هيرودتس quot;لا توجد مدينة تشبهها في روعتها في العالم الذي نعرفهquot;.
ولدى المخرج الأدوات التي يمكن الاستعانة والاستدلال بها، عياناً أو إيحاءً، لهذا التغييب لـ (باب إيل) المشوهة من قبل نظام صدام حسين الذي دون اسمه على كل طابوقة في جدران هذا البناء الحضاري، أو احتلالها كمعسكر للقوات الأميركية في العراق.
لكن اسم بابل وابنها سيتخفيان حين نعلم أن أحداثه تدور حول مأساة اسرة كردية تبحث عن ابنها سجون ومقابر نظام صدام حسين الجماعية. يمكن معها اعتبار الفيلم كردياً من حيث قصته وما زج بابل فيه إلاّ من باب الترويج له. فالعنوان هو عتبة العمل الفني التي تغري المتلقي بالتواصل معه أو إهماله.
لكن مالذي أجبر المخرج على الاتيان بسيدة (شاه زاد) من إقليم كردستان العراق لاتتكلم العربية مع حفيدها أحمد ( ياسر طالب) الذي من المفترض أن يجهل العربية أيضاً وفقا للواقع الحقيقي على الأرض اليوم، ليزج بهما في متن القصة، فيما محافظة بابل نفسها مليئة بمئات السيدات اللواتي فقدن أزواجا أو أخوة أو أبناء لهن في مقابر نظام صدام الجماعية، ناهيك عن محافظات عراقية أخرى.
هذه السيدة الكردية فقدت زوجاً وأخاً لها بالفعل في سجون نظام صدام مشترطة المشاركة في الفيلم علىأن يساعدها المخرج في البحث عنه.
الواضح أن قصة الفيلم تغيرت بعد الإلتقاء بهذ السيدة، ولعل ظروف الإنتاج لها دور في ظهور اسم بابل كإشارة طارئة في قصة تكشف مأساة إنسانية نجح المخرج الدراجي في إيصالها للرأي العام من خلال سيدة كردية قادمة برفقة حفيدها ذي الاثني عشر عاماً من قرية في أقصى قرى إقليم كرتسان العراق تبحث عن ابنها المفقود منذ حرب الخليج الثانية عام 1991 في جنوب العراق وقد علمت بعد سقوط نظام صدام بالعثور على سجناء كانوا مفقودين.
غير أن التفاصيل التي تخللت الفيلم يمكن أن تظهر أكثر من ثلمة فنية. فالطفل يتحدث العربية بطلاقة يصعب العثور عليها في إقليم كردستان. وقد أبلى بلاءً حسناً في خطوات تمثيله في الفيلم حتى حانت قمة القصة التي يكتشف فيها أن والده غير موجود في سجن الناصرية جنوب العراق من خلال رد فعله الذي بدا تلقينيا بشكل واضح، وهو يصرخ بحارس السجن.
وبعد يأسهما من العثور على مطلبهما في الجنوب يلتقيان شخصاً (موسى) في الباص المتوجه من الناصرية يقدم المساعدة لهما في الباص وخارجه، حيث يتقن بعض الكلمات الكردية، ثم مايلبث أن يكشف لهما بأنه كان ضمن عناصر القوات العراقية التي قتلت وأحرقت قرى كردية.
فكرة هذه القصة تبدو نبيلة في الترويج لقيم التسامح في مجتمع تتناهبه روح الثأر، اليوم، بين قومياته وطوائفه. لكن تنفيذها جاء مقصّراً وأظهر الممثل بشير الماجد (موسى) متراجعاً عن دوره الجيد في فيلم quot;أحلامquot;. ربما بسبب انتقاله للاخراج أثر في هذا التراجع كممثل، حيث كل فن دون ممارسة وتدريب تذوي شعلته ويعجز عن الإبهار وإقناع المتلقي.
ينجح هذا الجندي السابق والقاتل بنظر مرافقيه الكرديين باقناعهما بتوبته من خلال المساعدات التي قدمها لهما في رحلة العودة والبحث عن رفاة ابنهما.
وهنا يتم حشر بابل في الحوارات بين الجندي السابق (موسى) والصبي (أحمد) الذي يكشف لنا عن حبه لبابل وتعلقه بها بعد سماعهم باكتشاف مقابر جماعية فيها وقربها. لكنه حين ييأس من العثور عن أي خبر لوالده يرفض أن يرافقهما الجندي في رحلة العودة لكردستان خشية على حياته من الثأر. ومن وجوده كتذكير بمأساة حلبجة والأنفال عندما استخدم نظام صدام الأسلحة الكيمياوية في قتل المواطنين الأكراد إبان ثمانينات القرن الماضي.
ربما لو كانت ولادة الطفل في بابل من خلال خدمة العسكرية وانتقال عائلته لها لبعض الوقت أو أن والدته عربية من بابل خاصة أن الطفل يظهر راكضاً فوق بعض آثار بابل كمن يعرفها سابقاً، لقدم الفيلم لنا صورة كبيرة للتعايش التي تكتمل بالتسامح والتعايش بين القوميات.
وخلال عملية البحث عن الرفات بين القبور الجماعية يلجأ المخرج الى التمثيل بدلاً من الاستعانة بالإرشيف الفيديوي لهذه المقابر وهو متوفر في أكثر من مكان داخل أو خارج العراق. ولو فعل ذلك لأكسب الفيلم جهداً توثيقياً يخدم الفيلم ولايعيبه، لكن الدراجي قام بتثميل ذات المشاهد الإرشيفية المتوافرة، مفوتاً على فيلمه أن يكون وثيقة تأريخية في جانب منه.
بدت بابل وابنها محشورَين في قصة الفيلم التي كان بالامكان الاشتغال عليها بحرية وأفكار أوسع، لحصلنا على فيلم متكامل فنياً وروائياً وساهم بإقناع أكبر قدر من المشاهدين في أحداثه وتسلسل قصصه.
وقصّر العنوان عن بلوغ دلالته حتى في طريقة كتابته في المانشيت إذ ظهر هكذا (أبن بابل) وليس (إبن بابل) فثمة عدم انتباه للغة في ترجمة الحوارات غير العربية أوبشروط كتابة الهمزة في العنوان.
فمن معاني quot;أبنquot; أبّنه أثنى عليه بعد موته أو عابه في وجهه أو ترقبه أو لحق به. ويأبن بالسوء، عابه والأبن هو الدم الأسود في الجرح والأبنة مسمار القدم. وغيرها من المعاني لكن لايوجد بينها الإبن أو الولد.
حوارات الفيلم جاءت غير متناغمة مع جمالية لقطاته الصامتة. فحين يتكلم أحد الممثلين يسقط حجر من سور بناء القصة المأساوية. فخير المشاهد فيه الخالية من الحوار، مثل مشهد نواح الثكالى من جنوبيات العراق على ذويهن المفقدوين. إهمال التدريب على الحوارات غائب حتى في فيلم quot;أحلامquot; للدراجي. يتطلب الحوار مراناً وتمثيلاً وفق متطلبات الشخصية التي يجسدها الممثل. ولن تكون التلقائية محمودة دائماً في السينما، خاصة الروائية.
لكن هذه الثلمات التي ساهم المخرج محمد الدراجي بها في فيلمه الثاني الروائي الطويل لا تمنع من مواصلة الاعجاب بمنجزه الفني المتأني وانحيازه الصادق بين قلة قليلة جداً من مخرجين شباب لامكانية أن تساهم السينما كمنجر ثقافي- فيالوقت الذييفشل فيه السياسي العراقي- على أن يتوافر في الفنان كثير من الفن والحرفة ومثلهما من النوايا الصادقة لانجاح أي مشروع إبداعي.








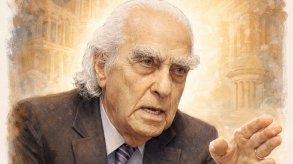

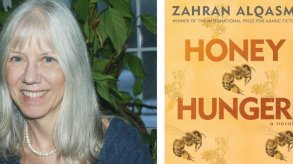

التعليقات