1
كان مما له دلالته، على رأيي، أن يتصادفَ تاريخ إستشهاد كمال جنبلاط، في يوم 16 آذار، مع مأساة مدينة quot; حلبجة quot;، الكردية، والتي حصلت في التاريخ نفسه. إنّ الأمرَ محضُ مصادفة، ولا شك. إلا أنّ ما وصفناه بـ quot; الدلالة quot;، ترجّحَ لدينا من معطياتٍ عدّة، تحيل هنا وهناك إلى أقدار تراجيدية، لها طالعٌ تاريخيّ أكثرَ منه أسطورياً. وأول ما يمكننا تأمله هنا، أنّ البعث، بشقيه السوريّ والعراقيّ، كان هوَ الخصمُ في كلا المأساتيْن. فبأمر من الأسد الأب، جرى إغتيال جنبلاط عام 1977، بطريقة غادرة. وبعد ذلك بحوالي عقدٍ من الأعوام، أعطى صدّام حسين أمرَه، المشؤوم، بإغتيال الحاضرة الكردية، عبرَ قذفها جواً بالغازات السامّة. كلاهما، فرعونا النظاميْن، البعثيين، أراد من خلال فعلته تلك، الختمَ على مصير شعبٍ بأكمله : فالطاغية القرداحيّ ، البائد، في سعيه لإلحاق لبنان بـ quot; المزرعة quot;، السورية، ما كان ليحتمل وجودَ زعيم وطنيّ، مميّز، بحجم كمال جنبلاط. بدوره، شاءَ الطاغية التكريتيّ، المقبور، أن يُنهي بالقصف الكيماويّ، الشامل، حملة quot; الأنفال quot;، سيئة الصيت، الهادفة لإبادة شعب كردستان العراق؛ أو على الأقل، دفن طموحاته القومية، المشروعة، في تلك المقبرة الجماعية، الهائلة.
2
في العام السابق لموته، المأسويّ، وجدَ جنبلاط الأبُ نفسه في عزلة شبه تامة، بعدما تخلى جميعُ العرب ـ علاوة على العالم ـ عن موطنه الصغير، تاركينه فريسة سائغة بين مخالب الأسد ! كانت الحرب الأهلية، الهمجية، قد تناهت وقتئذٍ إلى عامها الثاني، تؤججها القوى الإقليمية، المتربّصة بالتجربة اللبنانية، الديمقراطية، والتي جعلت من بيروت منارة حقيقية في ظلام المشرق العربيّ برمته. النظام السوريّ، بصفته الديكتاتورية / الطائفية، كان الأكثرَ إهتماماً بتخريب تلك التجربة، لما يراه من خطرها ـ كنموذج حضاريّ، راق، لبلدٍ متعدد الأعراق والأديان والمذاهب. وكان رأس ذلك النظام، في خطاب عام له في خريف 1976، قد إعترف بتدخله السافر في الشؤون اللبنانية قبل ذلك التاريخ بسنوات ثلاث، وأنّ قواته موجودة مذاك في المخيمات الفلسطينية، بزعم حمايتها وتأمين سلامتها. هذه التراجيديا، اللبنانية، يمكن لنا مقاربتها مع مثيلتها، الكرديّة : حينما نعاينُ ما عاناه البارزاني الأب، عام 1975، من مشاعر الإحباط ذاتها، وقد رأى خيانة الأصدقاء، من القوى الإقليمية والدولية على حدّ سواء، وهيَ تترك شعبه أيضاً لقمة سهلة في فم الفرعون العراقي. كان القائد الكرديّ ذاكَ ـ العائد من منفاه السوفياتيّ، الطويل، أواخر خمسينيات القرن الماضي ـ مناضلاً تحررياً في سبيل الديمقراطية، بنظر شيوعيي العراق ورفاقهم في الدول العربية. بيْدَ أنّ نظرتهم إليه، ما أسرع أن تحولت يميناً مع إعتمادهم عدسة المصالح السوفياتية، المتغيّرة؛ تحولاً شاءَ أن يتفاقمَ في مهزلته، إلى درجة إطلاق نعت quot; كاسترو العرب quot; على الرفيق البعثي، التكريتي !
3
كان من غرائب قدرَيْهما ـ جنبلاط وبارزاني ـ أن يموتا في شهر آذار، نفسه، يفصل بينهما عامان بالتمام. لنتذكر كذلك، أنّ كلاهما كان سليل عائلة كبيرة، عريقة في الوجاهة ولها تاريخٌ مديد من الكفاح ومقارعة الظلم. إنّ مصطفى البارزاني، من جهته، ينتمي لأسرة دينية تعتنق الطريقة النقشبندية، الصوفية، وتعدّ رأسَ العشائر في منطقتها الجبلية، المتاخمة للمثلث العراقي السوري التركي. ثمة معلومة شائعة في تلك المنطقة، بأنّ البارزانيين كانوا نصارى نسطوريين ( آشوريين )، ثمّ تحولوا إلى الإسلام السني، لسبب ما : هذه الشائعة، ربما روّج لها العثمانيون وأدواتهم، من العشائر المحلية، المنافسة، للغمز من قناة البرزانيين؛ وهمُ المشهورون بالتسامح والإعتدال تجاه أهل الأديان والمذاهب الاخرى. وعلى كل حال، فإنّ الشقيق الأكبر لزعيمنا هذا، وإسمه عبد السلام البارزاني، قد إنتهى مصيره شنقاً على أيدي العثمانيين، إثرَ فشل ثورته ضدهم في مستهل القرن المنصرم. بدوره، فكمال جنبلاط كان من سلالة لا تقل عراقة. وأضحى الآن معروفاً، في الحقيقة، أنّ أصلَ السلالة هذه كرديٌّ !.. فهيَ تنحدر من أمراء بني أيوب؛ وهمُ القادة العسكريون، نصيرو المذهب السنيّ، الذين حكموا بلاد الشام في القرون الوسطى. والمفردة المركبة quot; جان ـ بولاد quot;، الكردية ، تعني : الروح الفولاذية. ويُقال أنّ الفاتح العثماني، سليم الأول، هوَ من أطلقها على جدّ أجداد هذه الأسرة، بعدما أعجبَ بجرأته وجسارته. لعله من النادر، تاريخياً، أن يعثر المرءُ على أسرة حاكمةٍ ـ كالجنبلاطية هذه، كان مصير أقطابها جميعاً، تقريباً، متطابقاً في نهايته المأسوية. إن الأمير جنبلاط الإبن، كان قد رفضَ الإنصياع لأوامر الدولة بالإشتراك في حربها ضدّ الصفويين، فدفع حياته ثمناً لذلك عام 1605. ثمّ تولى مكانه ولده الأكبر، وإسمه عليّ ، مشمولاً برتبة الباشوية وحاكمية إمارة شاسعة، كان مركزها مدينة quot; كلّس quot; ( في كردستان تركية، حالياً ). بيْدَ أنّ علي باشا هذا، سرعان ما تأثرَ خطى والده، فأعلن العصيان على الدولة العلية، وسيطر على مدينة quot; حلب quot;. وقد عقد الأمير الجنبلاطيّ، الكرديّ، محالفة مع الأمير اللبناني، فخر الدين المعني، ضافره بإرسال جيشه لمساندته بوجه أطماع والي الشام. وما لبثت قوات الأميرين، العاصيين، أن أحدقت بدمشق وحاصرتها. ولكن الدولة، إلى الأخير، تمكنت من إخماد العصيان وأجبرت الأمير الكرديّ على الإستسلام. حصل علي باشا جنبلاط على عفو السلطان، وعيّن حاكماً لـ quot; بلغراد quot; الصربية. ولكنه ما عتم أن قتلَ غدراً، بأمر من السلطان العثماني، نفسه.
4
الأسرة الجنبلاطية، اللبنانية، ما كان عميدها سوى الإبن الأكبر لعلي باشا، المذكور آنفاً. كان سعيد بك هذا، يعيش في الآستانة ـ كرهينة، على عادة ذلك الزمن الغاشم. إلا أنه نجح بالإتصال سراً مع الأمير فخر الدين المعني، صديق أبيه، الذي أبدى إستعداداً لحمايته. هكذا إلتجأ السليل الجنبلاطيّ إلى موطن الأرز، واجداً ربما في ربوعه وجباله وغاباته، الساحرة، شبهاً بفردوسه الكردستانيّ، المفقود. إنّ تحوّل الجنبلاطيين إلى المذهب الدرزيّ، جرى في العام 1712، من لدن حفيد سعيد بك ذاكَ. كان الشيخ قبلان، عامئذٍ، زعيماً لطائفة الموحدين، حينما توفيَ بلا ذريّة، فإرتأى وجهاؤهم تعيين صهره، علي بك جنبلاط، بمحله في الزعامة. منذ ذلك التاريخ، غلبت صفة quot; الشيخ quot;، على الجنبلاطيين؛ وهيَ الصفة، الشائعة أيضاً لدى كبار العائلات المارونية. شكل هؤلاء الأخيرون، مع أندادهم الدروز، أساس لحمة جبل لبنان على مرّ الحقب والقرون. إلا أنّ الأتراك، وعن طريق باشاواتهم في الشام، دأبوا على شقّ هذه اللحمة، الصلدة، عبرَ إثارة الأحقاد الدينية والسياسية. الشيخ بشير جنبلاط، الزعيم الدرزي الأبرز في النصف الأول من القرن التاسع عشر، كان ضحية ً للسياسة تلك، التركية؛ حينما وجدَ نفسه في صراع خفيّ على النفوذ مع بشير الشهابي، أمير جبل لبنان، وكبير الطائفة المارونية. لا غروَ إذاً، أن يتناهى الخصام بين الطائفتين، الجارتين، وأن يمتدّ إلى باقي مناطق سورية الداخلية، وبخاصة مع إستيلاء إبراهيم باشا، المصري ، على بلاد الشام بكاملها. فما أن جلت القوات المصرية عن البلاد، حتى راح الباب العالي يحوكُ الدسائس مجدداً، لكي يوقع بين الموارنة والدروز. وحينما نشبت الحرب الأهلية عام 1860، كان الشيخ سعيد بك جنبلاط قد خلف والده ذاكَ، المغدور، في الزعامة. وقد نهضَ الرجلُ إلى محاولة التوفيق بين المتحاربين، وأمكنه لجم إندفاع رعيته ضد النصارى؛ حدّ أنه إستحق رسالة شخصية من بابا الفاتيكان، يمجّد فيها أخلاقه وفروسيته. ولكن العثمانيين، بخبثهم المشهود، إستطاعوا إقناع الدول الأوروبية، المتدخلة في النزاع، بزعم مسؤولية الزعيم الجنبلاطي عن تلك المذابح، فتمّ لهم سجنه ومن ثمّ التخلص منه بوساطة السمّ. بعد مرور حوالي القرن من الزمن، كان على موطن الأرز، الجميل، الوقوع في التجربة الممضة، مجدداً. آنذاك، قدّر للزعامة الدرزية أن تحلّ في شخص شابٍ نبيه، تحلى بقدَر وافر من الثقافة والمعرفة، فضلاً عن موهبة سياسية لا يُماري بها الأصدقاء والخصوم، على السواء.
5
كمال جنبلاط، هوَ ضربٌ من الزعماء الأفذاذ، النادرين في مشرقنا. إن إشكالية اللوحة الإجتماعية، اللبنانية، من حيث تنوّع الأديان والمذاهب والأعراق، ربما حدّت من تأثير الشخصية الجنبلاطية على حياة البلد السياسية، إلى هذه الدرجة أو تلك. على أنّ التاريخ، عموماً، لا يُسجله سوى أشخاصٌ إشكاليّون، وفي لحظات حاسمة، مصيرية. وإذا كان كمال جنبلاط، في أكثر من مرحلة من مراحل نضاله، قد بدا خصماً لطائفة معيّنة أو لفريق سياسيّ منافس أو لفكر آخر مختلف؛ إلا أنه الآن، وتحديداً بعد مرور ثلاثين عاماً على إستشهاده، يعدّ زعيماً وطنياً بنظر كل لبنانيّ مخلص لحرية بلده وإستقلاله ونظامه الدستوري، الديمقراطي. لنتذكر أنّ جنبلاط كان شاعراً، أكثرَ منه سياسياً. وقد تكون صفته هذه، قد شاركه فيها سياسيون آخرون في مشرقنا. وعلى سبيل المثال، الراحل بلند أجاويد؛ رئيس الوزراء التركي، الأسبق : ولكن هذا الرجل، وهوَ أيضاً من أصل كرديّ، لم يتفهم وضع مجتمعه المتعدد، من ناحية تنوعه الأثنيّ والدينيّ، فبقيَ أسيرَ الذهنية quot; الأتاتوركية quot;، شبه الفاشية، والمشددة على هيمنة القومية الواحدة والثقافة الوحيدة. وإذ حددنا ثيمة مقالنا بالتراجيديا الكردية، فلنقل إذاً أنّ جنبلاط، بعقليته المتنوّرة، كان السبّاق لإيجاد الحلول لمسألة المواطنة، التي عانت منها طويلاً مجموعاتٌ إثنية، معيّنة، في لبنان. ويُسَجل لزعيمنا هذا، أنه في موقعه كوزير للداخلية، في ستينات القرن الماضي، فقد قام بمنح الجنسية اللبنانية للعديد من أفراد الجالية الكردية، فضلاً عن الترخيص لجمعياتها وأحزابها وأدبياتها. وعلى الصعيد الخارجيّ، إتصفَ جنبلاط بنظرة موضوعية، منصفة، تجاه حركة التحرر الوطني، الكردية. لقد تفرّغ لإستنباط حلّ واقعيّ للمسألة الكردية في العراق، بحكم علاقته الجيّدة بطرفيْ النزاع، مسهماً هكذا في التوسّط بينهما. وفي هذا الإتجاه، فثمة معلومات أنه قام، في بداية السبعينات، بزيارة لمعقل البارزاني الأب في كردستان ، بطلب من حكومة بغداد. ما كان بالغريب، والحالة تلك، أن يواصل نجله ووريثه، وليد بك، هذه السياسة الحكيمة، بعيدة النظر، تجاه المسألة الكردية. كذلك أعلن هذا الأخير، علناً، إفتخاره بأصله الكرديّ، أثناء مشاركته بمؤتمر للإشتراكية الدولية. كما وحضر بنفسه مؤتمراً عالمياً لنصرة القضية الكردية، وكان صوته مدوياً بإدانة النظام العراقي، على أثر نكبة quot; حلبجة quot;. موقفه ذاكَ، كان بطبيعة الحال صدىً لفكر أبيه؛ المعلم الفذ. فكمال جنبلاط، في مذكراته التي حملت عنوان quot;هذه وصيّتي quot;، أعاد ذكرَ الحقيقة التاريخية لأصول سلالته، والتي تطرقنا لها في ما سلف من حديث. لقد قدّر لكاتب هذه السطور، فيما مضى، أن يحلّ في الربوع الجبلية الساحرة، الفاتنة، لكل من لبنان وكردستان العراق. حينما أستعيدُ الآن صوراً من تلك البلاد، لا أستطيع إلا مماهاتها بقول بليغ لأحد مدوّني سيرة quot; جبران quot;، النابغة اللبنانيّ؛ حيث لاحظ بحق، أنّ الأوطان المُتسِمة بجمال طبيعتها وتنوعها الأثني وحسن سكانها ولطف معشرهم، مقدرٌ عليها دوماً إجتيازَ النكبات والمصائب والآلام والمعاناة.







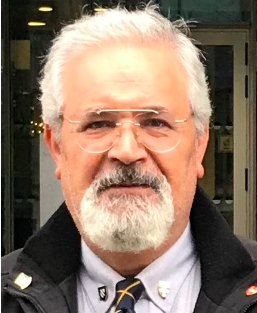














التعليقات