ما يجري في العراق يستدعي من السلطة التنفيذية إعلان حالة quot;الاستثناءquot; أو حالة quot;الطوارئquot;، وهي الحالة القانونية التي تنص عليها الشرائع الدستورية في حال وجود ما يهدد الأمن العام أو استقرار البلاد أو تهديد الوحدة الوطنية، وكل هذه الأمور مستوفاة في الوضع العراقي الراهن، بما يجعل آليات العمل السياسي العادية عاجزة تماما عن مواجهة التحديات والأخطار الكبيرة المحدقة، وبما يبرر اللجوء إلى وسائل مواجهة عملية لا تتناقض أبدا مع مبادئ دولة القانون والديمقراطية.
التاريخ المعاصر يؤيد وجهة النظر هذه، فالديمقراطية ليست نظاما سياسيا ضعيفا، واحترام مبادئ التعددية والحرية وحقوق الإنسان لا يجب أن يقود بالضرورة إلى الفوضى، وعندما تكون البلاد مهددة بدفعها إلى أتون الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي المدمر، فإن على النظام الديمقراطي أن يتحرك لإيجاد الصيغة القانونية والسياسية الحازمة التي ترتب الأولويات الوطنية ترتيبا مناسبا يجعل الأهم قبل المهم، وأمن الناس قبل مصالح الطوائف والأحزاب. عندما استدعي الجنرال ديغول لإنقاذ فرنسا من الفوضى أواخر الخمسينيات، بعد أن كان أنقذها من الاحتلال النازي أواسط الأربعينيات، اشترط على السياسيين الذين استدعوه دستورا جديدا، سيعرف لاحقا بquot;دستور الجمهورية الخامسةquot; أو quot;دستور 1958quot;، من بنوده تحويل النظام السياسي من حالته البرلمانية إلى حالة رئاسية، يكون فيها لرئيس الجمهورية صلاحيات حقيقية تمكنه من تطبيق برنامجه الإنقاذي وإعادة الأمن والاستقرار المطلوبين، وكان لديغول ما أراد، وهكذا أنقذت فرنسا من الفوضى دون أن تفقد الديمقراطية.
الصداميون والزرقاويون يراهنون على إغراق العراق في الدم والفوضى، ويراهنون على أن يصل العراقيون إلى حالة مأساوية يترحمون فيها على أيام الصنم والطاغية، وربما يكونون قد نجحوا في هذا الاتجاه إلى حد كبير، ولقد ساعدهم في نجاحهم هذا انقسام الطبقة السياسية وتناحرها وعجزها على الاتفاق على أجندة سياسية موحدة، ربما جراء ضعف التقاليد الديمقراطية، وربما أيضا نتيجة حدة الانقسامات البنيوية، أي الطائفية والمذهبية والقومية والدينية واللغوية والايديولوجية، وليس من مخرج لحل هذا المأزق المزدوج، أي رهان الأعداء على الفوضى وصراع النخب السياسية الجديدة، إلا العودة إلى ما كان يفترض أن يعمل به منذ 9 ابريل 2003، أي النظام السياسي الانتقالي، الذي يجمع بين نظام سياسي تقوده شخصية قوية ذات صلاحيات دستورية واسعة، و مؤسسات ديمقراطية قابلة للتطور في مستقبل الأيام.
لقد جرى تبني النظام البرلماني بعد انهيار النظام البعثي، كرد فعل أكثر مما كان جراء دراسة متوازنة لمتطلبات الوضع العراقي، ولو بشكل انتقالي، وهو ما أفسح المجال لظهور الانقسامات والصراعات والتجاذبات على أشدها، كما عمق النزعات الطائفية والحزبية والقومية التي كانت مقموعة بالحديد والنار طيلة العقود الأربعة الماضية. وفي الوقت الذي كانت فيه البلاد أحوج ما يكون إلى حكومة متجانسة وقوية، وجد العراق نفسه أمام حكومات ائتلافية متعاقبة تقدمت فيها التزكيات الحزبية على الكفاءة المهنية، وسيطرت فيها المزايدات السياسية على التحليلات العقلانية والاختيارات الوطنية.
وإن الناظر إلى سيرة حكومة المالكي على سبيل المثال، سيجد أن رئيس الوزراء نفسه لم يجر اختياره جراء مناقبه القيادية، بقدر ما كان نتاج خصومات سياسية، طغت عليها الاعتبارات الشخصية، كما سيجد أيضا أن الوزراء أنفسهم قد تم تصعيدهم في إطار توافقات حزبية فردية وجماعية، داخلية وخارجية، وافتقد كثير منهم للمؤهلات الإدارية الكافية، كما بدوا في مجملهم، بما في ذلك رئيس الوزراء، مجرد أصوات أو أياد تنفذ ما يسدد لها في مرجعياتها الحزبية أو الطائفية.
لقد كان المفترض أن تزود الديمقراطية العراق بنظام قوي يمكنه من مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية، ولم يكن العيب أبدا في الديمقراطية عندما فشل السياسيون العراقيون في اختيار النظام السياسي الملائم لبلادهم في هذا الوقت بالتحديد، وليس عيبا أن يجرى تقييم نقدي سريع للأوضاع والعودة بالعراق إلى النظام المطلوب ضمن ما تسمح بع الأعراف الديمقراطية، بدل تحقيق رغبات الأعداء و تسجيل خلاصة تاريخية ظالمة في حق الديمقراطية، مفادها أن العراق لا تحكمه إلا الديكتاتورية، وأن الوحدة الوطنية لا يصونها سوى الطغاة، وأن النظام الديمقراطي لم ينتج إلى الآن غير الخراب والفوضى، وقاد في نهاية المطاف إلى الفرقة والتجزئة.
الحل برأيي، يكمن ودون كثير كلام، في إعلان حالة الاستثناء الدستورية، عبر إجراء تعديل دستوري سريع، يمكن من تحويل النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي لفترة مؤقتة قابلة للتمديد، كما يقوم البرلمان الحالي باختيار شخصية وفاقية قوية في منصب رئيس الجمهورية، وتفويضه صلاحيات حقيقية تساعده على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة الحرب التي يخوضها الإرهابيون الداخليون والخارجيون، وتأتمنه على الحريات العامة والخاصة، بحيث تكون واثقة بأنه لن يبتلعها بمجرد نجاحه في مهمته الاستثنائية الموكلة إليه.
إن ما يواجهه العراق اليوم، لا يهدد بضياع مكتسبات الديمقراطية السياسية فحسب، بل يهدد الوحدة الوطنية والثروة البشرية والمكتسبات الحضارية، ولهذا فسيكون مفهوما، بل ضروريا، الإقدام على مجازفة محسوبة، فالإبقاء على النظام البرلماني خوفا على الديمقراطية سيتسبب حتما في ضياع البرلمان والديمقراطية معا، أما إذا ما جرى تبني النظام الرئاسي بشكل مؤقت، فإن الأمل سيكون كبيرا في الحفاظ على قدر من البرلمانية وقدر أكبر من الديمقراطية.
لقد عانى العراق طيلة ثلاث سنوات من حكومات وبرلمانات ديمقراطية حقا، لكنها عاجزة ومشتتة وغير قادرة على اتخاذ أي إجراء فاعل يواجه الأزمة، مما سهل مهمات المراهنين على إشاعة أجواء الإرهاب والفوضى والحرب الأهلية، و حول الساحة العراقية من مناط للأمل في التغيير ودفن مظالم الطاغية، إلى مناط للبؤس والشقاء والذبح والدماء وصراع الديوك واستغلال الأبرياء والأغبياء، فالوزراء هم قادة في أحزابهم أولا، وليسوا مسؤولين وطنيين بمقدورهم اتخاذ الإجراءات المناسبة، ونواب الجمعية الوطنية هم شيعة وسنة وعرب وتركمان وأكراد، وليسوا نوابا لشعب وأمة، وحتى يتدرب الجميع على ممارسة مسؤولياته بتقدير وطني أساسي، لا مناص من تسليم شؤون البلاد الرئيسية لقيادة وطنية متماسكة وحازمة وذات رؤية شاملة متعالية على الصراعات الطائفية والحزبية.
إن انبثاق القيادة في النظم الديمقراطية، خصوصا الرئاسية منها، لا يجب أن يرتبط بالضرورة بالخارطة المنبثقة عن الانتخابات البرلمانية، فعندما دعي الجنرال ديغول لمهمته الوطنية لم يكن يملك حزبا ذا أغلبية في الجمعية الوطنية، ولهذا فإنني أرى في الدكتور إياد علاوي أول رئيس للوزراء عقب انهيار النظام الصدامي، الشخصية السياسية العراقية المؤهلة للقيام بالمهمة الإنقاذية في حال اعتماد الجمعية الوطنية والقوى السياسية قرارا صارما بإعلان حالة الاستثناء وتكوين سلطة تنفيذية تحفظ الأمل للبلاد والديمقراطية، وتهزم الجماعات الإرهابية الصدامية والزرقاوية.
والدكتور علاوي يجمع في شخصيته، كما هو معروف، بين النزعة الليبرالية الوفاقية المنفتحة على كافة القوى والتيارات الوطنية، وبين النزعة القيادية الحازمة التي لديها كل المؤهلات في حال مكنت من الصلاحيات الدستورية والسياسية والقانونية الكافية، لمحاربة قوى الشر والإرهاب. وهو فوق كل هذا الرجل الذي يجمع بين انتماء شيعي غير طائفي وعلاقات سنية وثيقة، وبين إيمان قومي عربي معاصر وتفهم كبير لمطالب الأقليات القومية التي تستوطن العراق وتشكل جزء أصيلا من نسيجه التاريخي والجغرافي والديمغرافي.
وإن الدعوة قائمة إلى أن تدرك الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة، وفي مقدمتها أحزاب الائتلاف الشيعي، أن من مصلحتها، وقبل ذلك مصلحة العراق، أن تتنحى عن قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية، لارتباطها ببنى النزاع الطائفي، حتى وإن كانت أجندتها وطنية خالصة لا مجال للتشكيك فيها، وأن تقوم بدعم المشروع الإنقاذي، وتستغل المدة التي سيشغل فيها مواقع المسؤولية، في تدريب كوادرها وتأهيل مؤسساتها وصحفها، بما يتناسب مع متطلبات العيش في دولة ديمقراطية.
كما هي الدعوة أيضا للأحزاب والشخصيات الكردية لتفهم مقتضيات المرحلة الانتقالية، وتقديم التنازلات الضرورية للحفاظ على عراق ديمقراطي تعددي اتحادي، لأن انقلاب الوضع العراقي وارتداده إلى سنوات الطغيان البعثي، أو إلى أي صيغة زرقاوية جديدة، سيقود إلى نظام ستكون مكتسبات الأكراد القومية أول ضحاياه، وسيجد في محيط العراق الخارجي من يساعد ويدعم لإعادة كردستان العراق إلى ما يشبه كردستان تركيا أو سوريا أو إيران.
إذا لم تتخفف سفينة العراق بحكمة نخبه، فإن الغرق حتمية، ليس لأن بحرها هائج فحسب، بل لأن الراغبين في إغراقها، بين ظاهر وباطن، أكثر مما يسع عقل محب للعراق الجديد المتطهر من الصنم.
كاتب تونسي








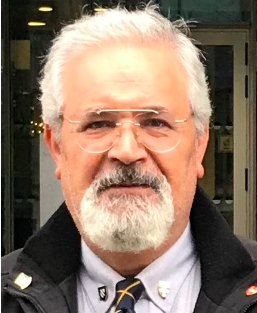
















التعليقات